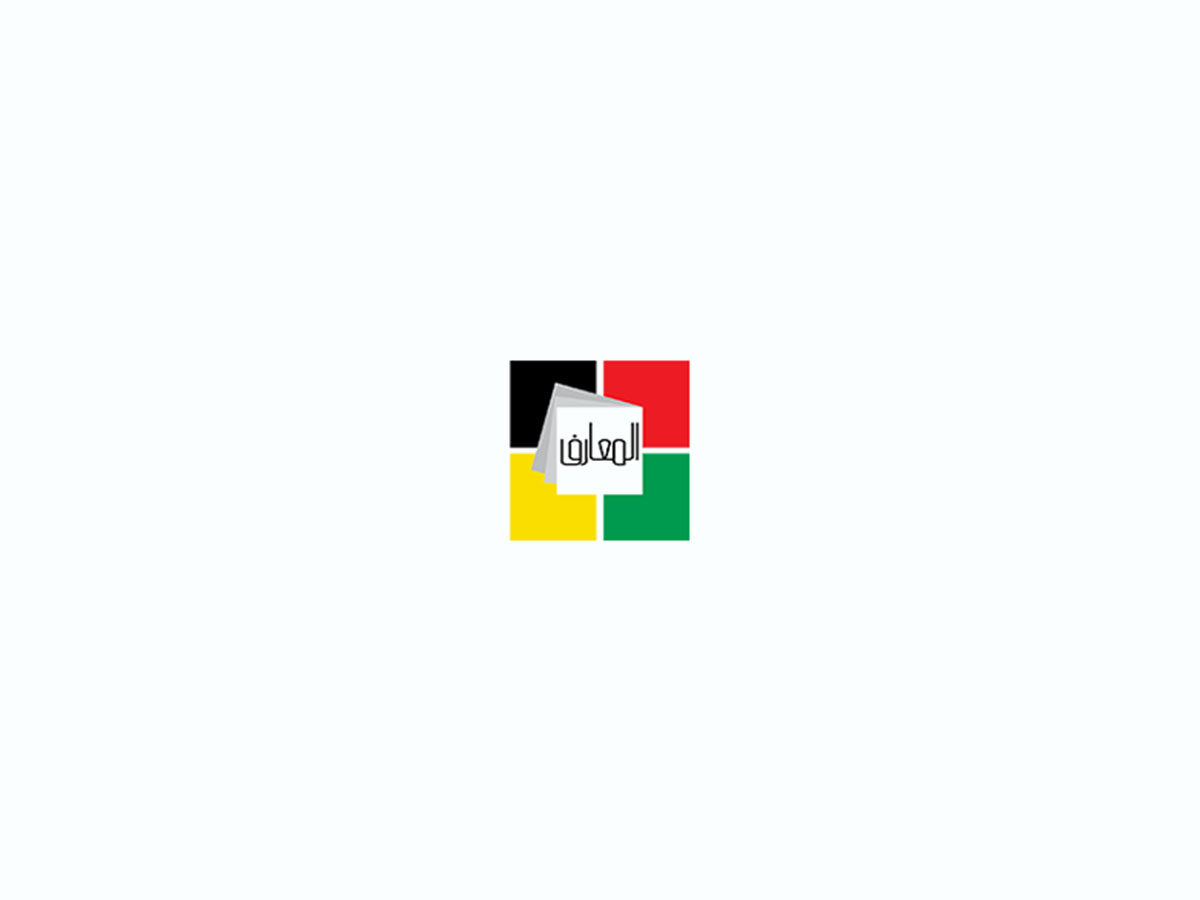المنح الموهوبة
إن من المتعارف بين الخلق ( منح ) جائزة كبرى، بعد ( تراكم ) الموجبات الجزئية لهـا..كالمنح الدراسية الموهوبه في آخر الفصل لمن أحرز الدرجات العالية في كل فصول سنته.
عدد الزوار: 928
إن من المتعارف بين الخلق ( منح ) جائزة كبرى، بعد ( تراكم ) الموجبات الجزئية
لهـا..كالمنح الدراسية الموهوبه في آخر الفصل لمن أحرز الدرجات العالية في كل فصول
سنته..والأمر في معاملة المولى لعبيده يشبه ذلك، فبعد الطاعات الجزئية المتواصلة في
كل مناسبات الشهور، يمنح الحق عبده ( رتبة ) عالية من رتب القرب، كمقام الرضا
والسكون إلى الحق، أو ( مقدمة ) من مقدمات تلك الرتب، كاستضافته إلى بيته الحرام،
أو إلى مشاهد أحد أوليائه العظام، مما يفتح له أفقاً جديدا للسير الحثيث نحو الحق
المتعال..ومن طرائف الأثر في مجال إستضافة الحق لأوليائه، ما روي - في الاحتجاج -
عن الإمام السجاد (عليه السلام) عندما دخل مكة، وقد اشتد بالناس العطش وقال لمن
هناك من العبّـاد: أما فيكم أحد يحبه الرحمن ؟!.. فقالوا: علينا الدعاء وعليه
الإجابة، فقال (عليه السلام): ابعدوا عن الكعبة فلو كان فيكم أحد يحبه الرحمن
لأجابه..ثم أتى الكعبة فخر ساجداً، فسُمع يقول في سجوده: "سيدي بحبك لي، إلا سقيتهم
الغيث"..فما استتم كلامه حتى أتاهم الغيث كأفواه القرب، فقيل له: من أين علمت أنه
يحبك ؟!.. فقال (عليه السلام): "لولم يحبني لم يستزرني، فلما استزارني علمت أنه
يحبني، فسألته بحبه لي فأجابني"، وأنشأ يقول:
من عرف الرب فلم تُـغنه***معرفة الرب فذاك الشقي
المعاملة بما يناسب المرحلة
كما أن معاملة الأب لأولاده يختلف بحسب سنيّ العمر، فأولها الدلال وآخرها
الهيبة والاحترام، ويجمعهما المحبة والوداد..فكذلك الأمر مع الرب الودود، فتارة
يتقرب إلى عبده بما يشعر معه ( الدلال ) والإنبساط، وتارة يحتجب عنه بما يشعر معه (
الوحشة ) والانقباض، وتارة يتجلى له بوصف العظمة والجلال بما يشعر معه ( الهيبة )
والإشفاق..وهكذا يتعامل الحق مع - من يصنعه على عينه - بما يناسب مقتضى مرحلته، وهو
الخبير البصير بعباده.
مجمل شهوات الدنيا
إن شهوات الدنيا قد أجملها الحكيم المتعال في النساء والبنين والأموال بأقسامها
من المنقول وغيره، ويجمع ذلك كله: الاستمتاع ( بالاعتبارات ) كوجاهة البنين
والعشيرة، ( والواقعيات ) كالاستمتاع بالنساء والأموال..وهذا مما يعين العاقل على
مواجهة الشهوات بما يناسبها، لأنها بتنوعها تندرج تحت قائمة واحدة، وتصطبغ بصبغة
واحدة وهي ملاءمتها لمقتضى الميل البشري ( السفلي )..فلو تصّرف العبد في طبيعة ميله،
وجعلها تتوجه إلى قائمة أخرى من مقتضيات الميل البشري ( العلوي )، لزال البريق
الكاذب للقائمة الأولى، لتحل محلها قائمة أخرى من الشهوات العالية، وقد قال الحق
المتعال عن هؤلاء: "والذين آمنوا أشد حبا لله".
ترك التسافل
إن الوظيفة الأساسية للعبد أن ( يترك ) التسافل والإخلاد إلى الأرض، بترك
موجبات ذلك، ولا يحمل بعد ذلك ( هـمّ ) التعالي والعروج، إذ المولى أدرى بكيفية
الصعود بعبده، إلى ما لا يخطر بباله من الدرجات التي لا تتناهى..إذ هو الذي يرفع
عمله الصالح - على تفسيرٍ - لقوله تعالى: "والعمل الصالح يرفعه"، وبارتفاع ( العمل
) يرتفع ( العبد ) أيضا، لأنه القائم بذلك العمل الصالح، وقد عبّر في موضع آخر
بقوله تعالى: "ورفعناه مكانا عليا".
مادة الافتتان
ينبغي معاملة الدنيا معاملة المرأة التي ( ترافق ) العبد وهي في غاية الجمال مع
عدم ( الإذن ) له بالزواج منها..فلو انفصلت عنه لشعر صاحبها بالسرور والارتياح،
لارتفاع مادة ( الافتتان ) التي لا يُؤمن معها الزلل في ساعة من ساعات الغفلة، بل
اعتبرت بعض الروايات أن مثل هذا الحرمان كالحمية، كما يحمي الطبيب المريض..ولهذا
يفرح المؤمن حقيقة، بتخفيف زهرة الحياة الدنيا لديه - وإن رآه البعض فقداً وخسراناً
- لما فيه من الجمع بين زوال الفتنة، والتعويض عما سلب منه..ومن هنا طلب الأولياء
الكفاف من العيش، إذ قد ورد: "فإن ما قل وكفى، خير مما كثر وألهى"-البحارج58ص165.
ملاك النظر إلى الأجنبية
إن من المعلوم كون النظر إلى الأجنبية من موجبات ظلمة الفؤاد كما نلاحظ أثر ذلك
بالوجدان، كالنار التي لا تحرق الدار ولكن تسوّد جنباتها..ولكن هناك أشياء أخري
فيها ( الملاك ) نفسه، وإن لم يكن ( حراماً ) بالمعني الفقهي للحرمة، وذلك كمد
البصر إلى ما مُتـّع به الآخرون من متاع الدنيا، وتحديق النظر إليها، والسؤال عن
مظانـّها، والحسرة على ما زُوي عن العبد منها، كمن يمشي في السوق لينظر بحسرة إلى
كل ما يراه، ( فيُشغل ) فؤاده بما تراه عيناه..وقد حذر القرآن من هذه الحالة بوضوح
إذ قال: "ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم
فيه".
أصناف أزواج الدنيا
إن علاقة الناس بالدنيا إما:زواج دائم، أو زواج منقطع، أو طلاق رجعي، أو طلاق
بائن، أو عدم زواج أصلا..فالأول: لأهل الدنيا ( المستغرقين ) في متاعها..والثاني: (
للمستمتعين ) بها من غير استغراق، فيقدمون رجلا ويؤخرون أخرى..والثالث: لمن هجر
الدنيا بعد أن انكشفت له حقيقة حالهـا، ثم يعود إليها بمقتضى ضعفه ووهن
إرادته..والرابع: لمن ( هجرها ) بعد طول معاناة، بما لا يفكر معها بالرجوع
أبدا..والخامس للكمّلين الذين ( لم يتصلوا ) بمتاعها - دواما وانقطاعا - لينفصلوا
عنها طلاقاً رجعياً أو بائناً، وقليلٌ ما هم.
الجيفة المجمدة
مثل بعض الصفات الرذيلة الكامنة في النفس، والتي لم يُظهرها العبد - إما (
خوفـاً ) من الله تعالى كما عند أهل التقوى، أو ( تعالـياً ) عن رذائل الأمور، كما
عند أهل الإرادة والرياضة - كمثل الجيفة المجمدة التي تنتظر الفرصة المناسبة ليظهر
نتنها بما يزكم منه الأنوف..فطريق الخلاص هو ( دفنها ) في التراب لتتحلل وتستحيل
إلى مادة أخرى لا تنطبق عليها وصف الجيفة..فصاحب القلب السليم هو الذي تخلص من
رذائل نفسه ( بقطع ) مادتها، إذ خلي باطنه من الجيفة بكل أشكالها.
إحسان من أسلم وجهه
قد يستفاد من قوله تعالى"بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن":أن الإحسان من حالات
المسلِّم وجهه لله تعالى..فموضوع الآية في الدرجة الأولى هو العبد الذي أصلح ( وجهة
) قلبه وأسلمها للحق وأعرض بها عمن سواه، ومن ثَمَّ صدر منه ( الصالحات ) من
الأعمال، كشأن من شؤون ذلك الموضوع..ومن المعلوم أن رتبة الموضوع سابقة لرتبة
الحالات الطارئة عليه، وعليه فلا يؤتي الإحسان ثماره إذا لم تصلُح وجهة القلب
هذه..ومن هنا لم يقبل الحق قربان قابيل، لأنه صدر من موضوعٍ لم تتحقق فيه قابلية
الإحسان، إذ قال تعالى: "إنما يتقبل الله من المتقين".
كالسائر على طرف حائط
إن مَثَل السائر إلى الحق، كَمَثل من يمشي على طرف حائط عالٍ، يرى منه جمال
الأفق بألوانها الآخذة بمجامع القلوب، فلا يحتاج إلى ( الحـثّ ) للنظر إلى فوق،
لأنه مستمتع بنفسه ومستغرق بمشاهدة ألوان الجمال، كما لا يحتاج إلى ( الزجر ) عن
النظر إلى تحت، لأنه بنفسه يخاف السقوط وما يستتبعه من حرمان للجمال وسقوط في
الهاوية، فالمهم في السائر إلى الحق أن يرى تلك الصور الجمالية التي تستتبع بنفسها
الزجر من الإعراض عن ذلك الجمال، والحث على الإقبال عليه.. وعندها ينتظم السير
ويتباعد صاحبها من الزلل، ويزداد الهدف وضوحاً والطريق إشراقاً.
إجتثاث الرذيلة الباطنية
أسند الحق الشح في آية: {ومن يوق شح نفسه} إلى النفس، إذ من المعلوم أن الحركات
الخارجية تابعة لحركات الباطن..والشحّ الذي هو أشد من البخل - والذي يتجلى خارجا في
منع المال - منشأه حالة في الباطن..ومن دون علاج هذا الشح ( الباطني )، يبقى الأثر
( الخارجي ) للشح باقيا، وإن تكلّف صاحبه في دفعه - خوفا أو حياء - كما نراه عند
بعض متكلفي الإنفاق..وهكذا الأمر في باقي موارد الرذائل، كمتكلفي التواضع والرفق
وحسن الخلق..فاللبيب هو الذي ( يجتثها ) من جذورها الضاربة في أعماق النفس، بدلا من
( تشذيب ) سيقانها المتفرعة على الجوارح.
من أرجى آيات القرآن
إن من أرجى الآيات قوله تعالى: "فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من
الخاسرين"..والسر في ذلك أنها نازلة بحق اليهود وقبائحهم من عبادة العجل، وكفران
النعم، وقتل الأنبياء، ونقض الميثاق، مع ما رفع فوقهم من جبل الطور تخويفا لهم، كما
ذكر في صدر الآية: "ورفعنا فوقكم الطور...ثم توليتم من بعد ذلك"..فإذا استعمل الحق
الودود ( أناتـه ) مع هؤلاء القوم، فكيف لا يستعملها مع عصاة الأمة المرحومة (
بشفاعة ) نبيها (ص)، وهم دون ما ذكر من قبائح بني إسرائيل بكثير
؟!.
التحايل في الحكم الشرعي
يستفاد من شدة عذاب بني إسرائيل عندما اعتدوا في السبت، وتحايلوا في العمل
بالحكم الشرعي، أن الحق تعالى لا يحب ( تفويت ) مراده باحتيال العبد والتفافه حول
حكم مولاه، فإن كمال العبودية هو تحصيل ( مراد ) الحق، إذا علم به العبد كيفما كان.
الاعتقاد بالبداء عند الدعاء
إن من الأمور المشجّعة على الإلحاح في الدعاء، هو الاعتقاد ( بالبداء )..فإن
الأمر بيد المولى الذي لا يعجزه شئ في الأرض ولا في السماء، وهو القادر على تغيير
المفاسد في الحوائج، إلى ( المصالح ) التي بحسبها يتغير ملاك الاستجابة نفياً
وإثباتاً..وعليه فما المانع من استقامة العبد في مطالبة الرب القدير بقضاء الحوائج
العظمى كتغيير مقدرات الأمم، فضلا عن تغيير مقدراته الفردية من الشقاء إلى السعادة
؟!..ومن أمثلة الاستجابة في الحوائج العظمى، هو إعمال البداء في توقيت فرج وليه (عليه
السلام) الذي ورد في حقه: "أن الله يصلح أمره في ليلة، كما أصلح أمر كليمه موسى (عليه
السلام) ليقتبس لأهله ناراً، فرجع وهو رسول نبي"البحار-ج51ص156.
القعود على الصراط المستقيم
ينحصر طلب الداعي في سورة الفاتحة - بعد مقدمات الحمد والثناء - في ( الاستقامة
) على الصراط، كما انحصر تهديد الشيطان من قبلُ، ( بالقعود ) على الصراط المستقيم
نفسه..ومن مجموع الأمرين يُعلم أن معركة الحق والباطل إنما هي في هذا الموضع،
والناس صرعى على طرفيها، وقد قلّ الثابتون على ذلك الصراط المستقيم..ومن هنا تأكدت
الحاجة للدعاء بالاستقامة في كل فريضة ونافلة..وليُعلم ان الذي خرج عن ذلك الصراط:
إما بسبب ( عناده ) وإصراره في الخروج عن الصراط باختياره وهو المغضوب عليه، وإما
بسبب ( عماه ) عن السبيل وهو الضال.
الحق أولى بحسنات العبد
إن الله تعالى أولى بحسنات العبد من نفسه، لأن كل الآثار الصادرة من العبد إنما
هو من بركات ( وجود ) العبد نفسه، والحال أن وجوده إنما هو ( فيض ) من الحق المتعال
حدوثا وبقاء..أضف إلى أن ( مادة ) الحسنة التي يستعملها العبد في تحقيق الحسنات،
ينتسب إلى الحق نفسه بنسبة الإيجاد والخلق..فيتجلى لنا - بالنظر المنصف - أن دور
العبد في تحقيق الحسنة، دور باهتٌ قياسا إلى دور الحق في ذلك..فلـيُقس دور مؤتي
الزكاة من الزرع، إلى دور محيي الأرض بعد موتها، وما تمر فيها من المراحل المذهلة
التي مكّنت المعطي من زكاته، والتي هي أشبه بالأعجاز لولا اعتيادنا لها
بتكررها..ومن هنا أسند الحق الزرع إلى نفسه، رغم أن الحرث من العبد، فقال: "أأنتم
تزرعونه أم نحن الزارعون".
التدريب على تعظيم المخلوق
لا يبعد أن يكون ( الأمر ) بالسجود لآدم (عليه السلام)، ( تدريباً ) للخلق على
تعظيم المخلوق بأعلى صور التعظيم، المتمثل بالسجود الذي لا يجوز لغيره تعالى، وذلك
فيما لو كان ذلك التعظيم بأمر من الحق نفسه..ويظهر أثر ذلك في تعاملنا مع المعصومين
(عليه السلام)، فنوطّن أنفسنا على أعظم درجات الخضوع والتعظيم، ما دام ذلك ( بأمـر
) من المولى وبرغبة أكيدة منه، وهو الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون..وقد عمل
بذلك آدم نفسه - عندما توسل بهم في بدء الخليقة - عند تلقّي الكلمات من ربه،
المتمثلة بالنبي وآله عليهم السلام، كما رواه الكليني والصدوق والعياشي.
عبادة الحق كما يريد
طلب إبليس من الحق أن يعفيه من السجود لآدم (عليه السلام)، مقابل عبادة لم
يعبدها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكان جواب الحق كما روي عن الصادق (عليه السلام): "لا
حاجة لي في عبادتك، إنما عبادتي من حيث أريد، لا من حيث تريد"البحار-ج11ص141..وفي
ذلك بيان لقاعدة عامة، وهي أن العبادة المطلوبة للحق هي ما طابقت إرادة ( المعبود )
لا رغبة ( العابد )..ومن هنا يكتشف العبد ضلالة سعيه إذا لم يكن مطلوبا للحق، وإن
وجد العبد سعيه حسناً، مصداقا لقوله تعالى: "الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً".
القشر واللب
إن لعالم الوجود قشراً ولبـّا، قد عبر القرآن عن الأول بظاهر الحياة الدنيا،
بما يفهم منه أن له باطنا أيضا وهو اللب..فإذا أعمل الحق المتعال خلاّقيته بما
يُذهل الألباب في الظاهر، فقال تعالى: "تبارك الله أحسن الخالقين"و"بديع السموات
والأرض"و"أعطى كل شئ خلقه ثم هدى"و"ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح"..فكيف بآثار
خلاقيته في عالم الألباب ؟!، وهي الأرواح التي نسبها الحق إلى نفسه فقال: "قل الروح
من أمر ربي"و"ونفخت فيه من روحي"..ومن هنا يعلم شدة تقصير العبد في ( تزيين ) أكثر
المخلوقات قابلية للجمال والكمال، وهي ( نفسه ) التي بين جنبيه.
انقطاع تسبيح الثوب
أمر رسول الله (ص) عائشة بغسل برديه فقالت: بالأمس غسلتهما، فقال لهـا: "أما
علمت أن الثوب يسبح، فإذا اتسخ انقطع تسبيحه"الدر المنثورج4ص185..فالمستفاد من هذه
الرواية أن القذارة ( الظاهرية ) مانعة من التسبيح ( التكويني )..وهنا نتساءل:كيف
لا تكون القذارة ( الباطنية ) مانعة من التسبيح ( الاختياري ) ؟!..ومن صور الظلم أن
يسبب العبد ما يوجب انقطاع تسبيح خلق من خلقه.
العقوبة في الطبيعة
أشار الحق في سياق العقوبات التي حلت ببني إسرائيل، أن ماءهم تحول إلى دمٍ،
فقال: "فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم".. فما المانع من حلول
( الغضب ) بعد مقتل الحسين (عليه السلام)، بنفس الأسلوب من العقوبة كما ورد من وجود
الدم ( العبيط ) تحت الحجارة في بيت المقدس ؟!..وكقول زينب (عليه السلام): "أفعجبتم
أن قطرت السماء دما ؟!".
المعية العامة والخاصة
إن هناك فرقا شاسعا بين المعيّـة الخاصة للحق المتمثلة بقوله: "إن الله مع
الذين اتقوا"، وبين المعيّة العامة المتمثلة بقوله: "وهو معكم أينما كنتم"..ففي
الأول معيـّة ( النصر ) والتأييد، وفي الثاني معيـّة ( الإشراف ) التكويني المستلزم
للرزق والحفظ وغيره..والفرق بين المعيّـتين كالفرق بين إطلالة الشمس على الغصن
الرطب واليابس، ففي الأول معـية التربية والتنمية، وفي الثاني المعيـة التي لا ثمرة
لها غير المصاحبة المجردة.
القلبان في جوف واحد
نفى الحق المتعال أن يكون لرجل ( قلبان ) في جوفه، وقد روي عن الصادق (عليه
السلام) أنه قال: "ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يحب بهذا قوما ويحب بهذا
أعدائهم"التبيان-ج9ص313..فإن للعبد ( وجهة ) غالبة في حياته، وهـمّ واحد، يدفعه
لتحقيق آماله وأمانيه، وتلك الوجهة هي التي تعطي القلب وصفا لائقا به، فإذا كان
إلهيـّا استحال القلب إلهيـّا وكذلك في عكسه..فإذا اتخذ العبد وجهته ( الثابتة ) في
الحياة، لم تؤثر الحالات ( العارضة ) المخالفة في سلب العنوان الذي يتعنون به القلب.
التدبر فيما وراء الفقه
روي عن الصادق (عليه السلام): "إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت ملكا عظيما،
لا يطأ بساطه إلا المطهرون، ولا يؤذن لمجالسته إلا الصديقون" البحارج80ص373..وهذا
الخبر يعطي درسا بليغا في تعامل العبد مع كل صور الطاعة..فالمطلوب من العبد دائما
أن يترجم لغة ( الفقه ) إلى لغة التدبر فيما ( وراء الفقه )، و ينتقل من ( لسان )
الحكم الشرعي إلى البحث عما وراءه من ( الملاكات ) المرادة لصاحبها، ويترقى من حالة
التعبد ( الحرفي ) بالأوامر والنواهي، إلى التفاعل ( الشعوري ) مع الآمر
والناهي..فإذا طالب الحق عبده بمثل هذه المشاعر العالية عند بلوغ المسجد، فكيف
بالواجبات المهمة في حياة العبد، عند بلوغه ساحة الحياة بكل تفاصيلها ؟!.
الصبغة الواحدة
إن الكون - على ترامي أطرافه وتنوّع مخلوقاته - متصف بلون واحد وصبغة ثابتة،
وهي صبغة العبادة التكوينية التي لا يتخلف عنها موجود أبدا..والموجود المتميز بصبغة
أخرى زائدة غير العبادة ( التكوينية ) هو الإنسان نفسه، فهو الوحيد الذي وهبه الحق
منحة العبادة ( الاختيارية )..وبذلك صار المؤمن وجودا ( متميزا ) من خلال هذا
الوجود المتميز أيضا، لأنه يمثل العنصر الممتاز الذي طابقت إرادته إرادة المولى حبا
وبغضا..ولذلك يباهي الحق - فيمن يباهي فيهم من حملة عرشه والطائفين به - بوجود مثل
هذا العنصر النادر في عالم الوجود..والسر في ذلك أن الحق تعالى مكنّه من تحقيق
إرادته مع ما جعل فيه من دواعي الانحراف كالشهوة والغضب، وقد ورد: "أن طائفة من
الملائكة عابوا ولد آدم في اللذات والشهوات، أعني لكم الحلال والحرام.. فأنف الله
للمؤمنين من ولد آدم من تعيير الملائكة، فالقى الله في همة أولئك الملائكة اللذات
والشهوات، فلما أحسوا بذلك عجّـوا إلى الله من ذلك، فقالوا ربنا عفوك عفوك، ردّنا
إلى ما خلقتنا له فإنا نخاف أن نصير في أمر مريج"البحار-ج8ص141.
لو فرض مَحالاً
لو افترض محالا أن الخلق كلهم عبيد لأحدنا، وافترض أن عباداتهم إنما هي بحقنا،
( لاستصغرنا ) ذلك منهم، وتوقعنا منهم أكثر من ذلك بكثير، بل لانتابنا شعور بالسخط
ولزوم التأديب، لما نراه من حقارة تعظيمهم إيانا قياسا إلى عظيم حقنا عليهم..ومن
هنا تتجلى ( أنـاة ) الحق في إحتمال عباده، الذين يغلب - حتى على الصالحين منهم - (
الغفلة ) عنه في أكثر آناء الحياة..ومن ذلك يعلم أيضا العفو العظيم من الرب الكريم،
الموجب لإعفاء الخلق من كثير من العقوبات مصداقا لقوله تعالى: "وما أصابكم من مصيبة
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير"و"لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة".
القدرة المستمدة من الحق
إن الالتفات إلى ( عظمة ) الحق في عظمة خلقه، وإلى ( سعة ) سلطانه في ترامي
ملكه، وإلى ( قهر ) قدرته في إرادته الملازمة لمراده، كل ذلك يضفي على المرتبط به -
برابط العبودية - شعورا بالعزة والقدرة المستمدة منه..ولهذا يقول علي (عليه السلام):
"الهي كفى بي عزا أن أكون لك عبداً، وكفى بي فخراً أن تكون لي
رباً"البحار-ج77ص402..هذا الإحساس لو تعمّق في نفس العبد، لجعله يعيش حالة من
الاستعلاء، بل اللامبالاة بأعتى القوى على وجه الأرض - فضلاً عن عامة الخلق الذين
يحيطون به - لعلمه بتفاهة قوى الخلق أجمع، أمام تلك القدرة اللامتناهية لرب الأرباب
وخالق السلاطين.
عظمة الخالق في النفس
قد ورد في وصف المتقين أنه قد: "عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في
أعينهم"..فلنتصور عبدا وصل إلى هذه الرتبة المستلزمة لصغر ما سوى الحق في عينيه،
كيف يتعامل مع كل مفردات هذا الوجود ؟!..فإن صغر ما سوى الحق عنده، يجعله لا ( يفرح
) بإقبال شئ عليه، كما لا يأسى على فوات شئ منه، كما لا ( يستهويه ) شئ من لذائذها،
ما دام ذلك كله صغيرا لا يستجلب نظره، كالبالغ الذي يمر على ما يتسلى به الصغار غير
مكترث بشيء من ذلك..وفي المقابل فإن من صغُر الحق في نفسه، فإنه ( يكبر ) كل شئ في
عينه، فاللذة العابرة يراها كاللذة الباقية، والمتاع الصغير وكأنه منتهى الأماني
لديه، والخطب اليسير في ماله وبدنه كأنه بلاء عظيم لا زوال له، وهكذا يعيش الضنك في
العيش الذي ذكره القرآن الكريم..وليعلم في هذا المجال أن كبر الدنيا في عين العبد،
تدل بالالتزام على صغر الحق المتعال في نفسه، وفي ذلك دلالة على ( خطورة ) ما فيه
العبد وإن ظن بنفسه خيرا.
الحركة حول محور واحد
إن في عالم الطبيعة حركةً دائبةً حول محور واحد لا تتخلف أبدا، كحركة النواة
والمجرّات والمجموعات الشمسية حول محاورها..فالمطلوب من العبد المخـتار أيضا أن
ينسجم مع هذه الحركة ( الكونية )، فتكون له حركته الدائبة والثابتة حول محور واحد
في الوجود بلا انقطاع..وقد طالب الحق المتعال عباده بهذه الحركة المادية أيضا و(
المشابهة )لحركة الطبيعة، وذلك بالأمر بالطواف حول محور بيته الحرام..ومن الملفت في
هذا المجال أن جهة الطواف - بعكس حركة الساعة - تشابه الحركة الدائرية ( للتكوينيات
) وفي الاتجاه نفسه، والتي يغلب على مداراتها عدد السبعة أيضا.
الإخلاد إلى الأرض
إن كلمة اثّـاقلتم في قوله تعالى: "اثاقلتم إلى الأرض" تشعر بأن الإخلاد إلى
الأرض، كسقوط الأثقال إلى الأسفل، في أنها حركة ( طبيعية ) لا تحتاج إلى كثير مؤونة،
بخلاف الحركة إلى الأعلى، فإنها حركة ( قسرية ) تحتاج إلى بذل جهد ومعاكسة للحركة
الطبيعية تلك..ولهذا ورد التعبير ( بالنفر ) في قوله تعالى: "إنفروا في سبيل
الله"..و( الفرار ) في قوله تعالى: "فروا إلى الله"..و( المسارعة ) في قوله تعالى:
"سارعوا إلى مغفرة من ربكم"، مما يدل جميعا على أن الوصول إلى الحق، يحتاج إلى نفر
وفرار ومسارعة..وفي كل ذلك مخالفة لمقتضى الطبع البشري، الميال إلى الدعة
والاستقرار والتباطؤ.
التعالي عن عامة الخلق
إن مثل المتعالي عما يشتغل به عامة الناس، كمثل من أرغم على الاشتراك مع من هم
دون سن البلوغ في لهوهم ولعبهم..فيجد كثير ( معاناة ) في هذه المعاشرة، لعدم وجود (
الأنس ) مع من لا تربطه بهم صلة في علم و لا عمل..فعلى المؤمن - المبتلى بمثل هذه
الحالة - أن يعاشر الخلق ببدنه لا بروحه، ليتخلص من تبعات عدم التوافق الذي ينغص
عيشه..ومن الضروري في مثل هذه الحالة، كتمان حالات الضيق التي تنتابه معهم، إذ أن
في ذلك ( انتقاص ) غير محمود، قد يعرّض نعمة العلو الروحي للزوال، كما ينبغي
الالتفات الدقيق إلى عدم الوقوع في دائرة العجب المهلكة، عندما يرى في نفسه من
الكمال ما لا يراه في عامة الخلق، لأن المعجب الواجد للكمال أقرب للهلاك من الفاقد
له.
صراحة أمير المؤمنين (عليه السلام)
يكتب أمير المؤمنين (عليه السلام) كتابا إلى واليه يقول فيه: "تعمر دنياك بخراب
آخرتك، وتصل عشيرتك بقطيعة دينك، ولئن كان ما بلغني عنك حقا، فبعير أهلك وشسع نعلك
خير منك ومن كان بصفتك"البحار-ج33ص506.. فتبلغ صراحة أمير المؤمنين (عليه السلام)،
وتنمّره في ذات الله تعالى مبلغا يجعل شسع النعل، خيرا ممن ينحرف عن طريق
الحق..لوضوح أن شسع النعل لا ( غضاضة ) في وجوده، إذ أنه ( مسبح ) للحق بلسان حاله
أو مقاله، كباقي موجودات هذا الكون الفسيح، خلافا لمن ( حـاد ) عن جادة الحق فهو
دون البعير وشسع النعل بل أضل سبيلا.
الاشتغال بالفسيح
إن مواجهة القلب مواجهة متفاعلة مع أمور الدنيا - وخاصة المقلق منها - مما (
تضيّق ) القلب..إذ أن القلب يبقى منشرحا إذا اشتغل ( بالفسيح ) من الأمور التي تتصل
بالمبدأ والمعاد..والقلب الذي يشتغل بالسفاسف من الأمور، يتسانخ مع ما يشتغل به،
فيضيق تبعا لضيق ما اشتغل به..والحل - لمن لابد له من التعامل مع الدنيا - أن يرسل
إليها ( حواسه ) وفكره القريب إلى حواسه..وأما ( القلب ) والفكر القريب إلى قلبه،
فيبقى في عالمه العلوي الذي لا يدنّـسه شئ..فمَثَل القلب كمَثَل السلطان الذي يبعث
أحد رعاياه لفك الخصومات وغيرها، ولا يباشرها بنفسه لئلا تزول هيبة سلطانه.
صنوف الكمال
يمكن القول أن جميع صنوف الكمال مجتمعة في قوله تعالى: "وأما من خاف مقام ربه
ونهى النفس عن الهوى"..فإن فيه كمال ( معرفة الرب )، لأنه لولا هذه المعرفة لما عرف
مقام الرب، وبالتالي لم يتحقق منه الخوف من صاحب ذلك المقام..وفيه كمال مرتبة (
القلب السليم ) لأن الخوف من مقام الرب لا ينقدح إلا من القلب السليم، الذي خلي من
الشوائب بما يؤهله لنيل تلك المرتبة من الخوف..وفيه كمال مرتبة ( العمل الصالح )
الذي يلازم نهي النفس عن الهوى، إذ أن الذي يصد عن العمل الصالح، هو الميل إلى
الهوى الذي لا يدع مجالا لتوجه القلب إلى العمل الصالح.
كثرة الهموم
إن كثرة الهموم والغموم تنشأ من تعدد مطالب العبد في الحياة الدنيا، فكلما (
يـأس ) من تحقيق مأرب من مآربه ( انتابه ) همّ الفشل، فإذا تعددت موارد الفشل تعددت
موجبات الهموم، وتبعاً لذلك تتكاثف الهموم على القلب بما تسلبه السلامة
والاستقامة..فلو نفى العبد عن قلبه الطموحات الزائفة، وتضيّقت عنده دائرة المحبوبات،
واقتصرت همّته على ما يحسن الطمع فيه والطموح إليه، ( قلّت ) عنده فرص الفشل،
وبالتالي نضبت روافد الهموم إلى قلبه..وقد أشار أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى
هذه الحقيقة بقوله: "قد تخلّـى من الهموم إلا هما واحداً"البحار-ج2ص56..ومن هنا
يعيش الأولياء حالة من ( النشاط ) والانبساط الذي يفقده - حتى المترفون - من أهل
الدنيا، وذلك لانصرافهم عما لا ينال، وتوجّههم إلى ما يمكن أن ينال في كل آن، وهو
النظر إلى وجهه الكريم.
السعة المذهلة للوجود
ورد في الحديث: "ما السموات السبع والأرض عند الكرسي إلا كحلقة خاتم في فلاة،
وما الكرسي عند العرش إلا كحلقة في الفلاة"البحار-ج58ص2..إن استشعار هذه الحالة -
وخاصة - عند مواجهة الحق في الصلوات والدعوات، يجعل العبد يعيش حالة ( التذلّل )
والانبهار أمام هذه القدرة التي لا تتناهى، والسلطان الذي لا يدرك كنهه..فمن موجبات
( تعميق ) محبة المحبوب هو الالتفات التفصيلي لما عند المحبوب من صفات وقدرة، ولما
يتمتع به من جمال وجلال..والأمر عند عشاق الهوى كذلك، إذ أنهم يختارون من يجتمع
فيهم الجمال والاقتدار..فالأول عنصر ( اجتذاب ) يوجب دوام محبة المحبوب..والثاني
عنصر ( ارتياح ) يوجب قضاء مآرب الحبيب.
حقيقة الاسترجاع
إن حقيقة آية الاسترجاع: "إنا لله وإنا إليه راجعون"لو تعقلها العبد بكل وجوده،
لأزال عنه الهمّ الذي ينتابه عند المصيبة..والسر في ذلك أن الآية تذكّره بمملوكية (
ذاتـه ) للحق، فضلا عن ( عوارض ) وجوده..وهذا الإحساس بدوره مانع من تحسّر العبد
على تصرف المالك في ملكه - وإن كان بخلاف ميل ذلك العبد - إذ أنه أجنبي عن الملك
قياسا إلى مالكه الحقيقي..كما تذكره ( بحتميّة ) الرجوع إليه المستلزم ( للتعويض )
عما سلب منه وهو مقتضى كرمه وفضله، وإن ذكرنا آنفا أن سلب الملك من شؤون المالك لا
دخل لأحدٍ فيه، كما يقال في الدعاء: "لاتضادّ في حكمك ولا تنازع في ملكك"..كل هذه
الآثار مترتبة على وجدان هذه المعاني، لا التلفظ بها مجردة عما ذكر.
روح الدعاء
رأى الإمام الحسن (عليه السلام) رجلا يركب دابةً ويقول: "سبحان الذي سخر لنا
هذا وما كنا له مقرنين"فقال (عليه السلام) أبهذا أمرتم؟، فقال بم أمرنا؟، فقال (عليه
السلام): ( أن تذكروا نعمة ربكم )..ومن ذلك يعلم أن حقيقة الأدعية المأثورة تتحقق
بالالتفات الشعوري إلى مضامينها..إذ أن الدعاء حالة من حالات القلب، ومع عدم تحرك
القلب نحو المدعو وهو ( الـحق ) والمدعو به وهي ( الحاجة )، لا يتحقق معنىً
للدعاء..وبذلك يرتفع الاستغراب من عدم استجابة كثير من الأدعية، رغم الوعد الأكيد
بالاستجابة، وذلك لعدم تحقق الموضوع وهو ( الدعاء ) بالمعني الحقيقي الذي تترتب
عليه الآثار.
الملَكَة أشرف من العمل
إن رتبة ملكة التقوى أشرف من رتبة العمل الصالح لجهات: منها أن صاحب الملكة
متصف بتلك الملكة وإن ( انقطع ) عن العمل، فالكريم كريم وإن لم يكن متلبساً
بالإكرام الفعلي..ومنها أن العمل الصالح قد تشوبه ( شوائب ) العمل من الرياء وغيره،
والحال أن الملكة حالة راسخة في الباطن، فلا مجال لإبدائها بنفسها في الظاهر لجلب
رضا المخلوقين، وإن بدت آثارها في الخارج..ومنها أن العمل الصالح قد ( يفارق )
العبد ولا يعود إليه لوجود ما يزاحم تحققه، ولكن الملكة صفة لازمة للنفس..ومنها أن
الملكة قائمة بالروح ( الباقية ) بعد الموت أيضا، والعمل الصالح قائم بالبدن، ولهذا
ينقطع بانقطاع الحياة..ومنها أن العمل من ( آثار ) الملكة التي منها يترشح العمل
المنسجم مع تلك الملكة، ورتبة ما هو كالسبب، أشرف من رتبة ما هو كالمسبَّب.
الحسنة في الدنيا والآخرة
إن من يهوى الدنيا، يطلبها بكل متعها، من دون ( تقييدها ) بكونها حسنا عند الحق
المتعال..وذلك لأن كل ما فيها - مما يطابق الهوى - مطلوب لديه..وهذا بخلاف المؤمن
الذي لا يريد من الدنيا والآخرة، إلا ما كان ( حسناً ) عند مولاه..ولهذا يوكل أمر
آخرته ودنياه إليه، لأنه الأدرى بالحسن الذي يلائمه بالخصوص..وقد روي عن الإمام
الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة"أنه قال: ( رضوان الله والجنة في الآخرة، والسعة في الرزق، وحسن الخلق في
الدنيا ).
التركيز في غير الصلاة
يتذرع الكثيرون الذين لا يملكون القدرة على التركيز - في الصلاة والدعاء -
بذرائع واهية من عدم القدرة على مثل ذلك، بما يوهم سقوط التكليف بالصلاة
الخاشعة..والحال أن هؤلاء أنفسهم يملكون أعلى صور التركيز في مجال عملهم، بل في
مجال العلوم التي تتطلب منهم التركيز الذهني المتواصل..والسر في ذلك واضح وهو
رغبتهم ( الأكيدة ) في مثل هذا التركيز فيما يحبون، طمعا لما وراءه من المنافع..ولو
تحققت فيهم مثل هذه ( الرغبة ) في التركيز - عند الصلاة والدعاء - طلبا لعظيم
المنافع فيهما، ( لأمكنهم ) مثل هذا التركيز أيضا بل أشد من ذلك..وتتجلّى ضرورة مثل
هذا التركيز، بالتأمل فيما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: "من كان
قلبه متعلقاً في صلاته بشيء دون الله، فهو قريب من ذلك الشيء، بعيد عن حقيقة ما
أراد الله منه في صلاته"تفسير الصافي-ج4ص161.
سكر الشهوة والغضب
كما أن ( المسكرات ) سالبة للعقل، فكذلك ( الشهوة ) و ( الغضب ) تسلبان الإرادة
من صاحبهما حتى يوصلاه إلى ما يقرب من السكر بل الجنون!!..فالمردود السلوكي متشابه
في كل من المسكر والشهوة والغضب..فعلى المؤمن - الذي لا بد وأن يمارس شهوته في
فترات من حياته - أن لا يسترسل أثناء ممارسته لتلك الشهوة بما يفقده حالة
الاعتدال..ومن هنا أحاط الشارع الحكيم ( معاشرة ) النساء بأحكام وجوبيه وإستحبابية
- حتى في الليلة الأولى منها - لئلا يعيش العبد حالة من الذهول المطلق عن مولاه عند
فوران شهوته..وقد وصف أمير المؤمنين (عليه السلام) بوصف بليغ تلك الحالة بقوله: "حياء
يرتفع، وعورات تجتمع، أشبه شيء بالجنون !!، الإصرار عليه هرم، والإفاقة منه ندم" -
غرر الحكم.
السياحة اللاهادفة
إن على المؤمن أن يحترز عن السياحة ( اللاهادفة ) التي لا يتأتّى فيها قصد (
القربة ) إلى الحق..فإن جميع حركات العبد وسكناته، ينبغي أن تكون مقرونة ( بالنـّية
) التي تربطه بالعلة الغائية في أصل وجوده..وإلا فإن مجرد التنقل من بلد إلى بلد لا
قيمة له في حد نفسه، سوى ما يستوجبه شيئا من الاسترخاء والارتياح، الذي يزول مع
العودة إلى البيئة التي كان فيها العبد، ليعاني فيها - مرة أخرى - مشاكله التي غفل
عنها في سفره..وهذا خلافا للسياحة التي ترتبط بهدف مقدس: كمواطن الطاعة والارتباط
بالحق أو بأوليائه، أو كالمواطن التي تعينه على استرجاع النشاط، لمواصلة سبيل
العبودية بجد واجتهاد..فإن أثرها متسمٌ بالبقاء والخلود، لأنه مصداق لما عند الله
تعالى..وقد ورد عن الإمام الكاظم (عليه السلام) بعد تقسيم الساعات لمناجاة الله
تعالى ولأمر المعاش ولمعاشرة الإخوان: "وساعة تخلون فيها للذّاتكم في غير محرم،
وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث ساعات"البحار-ج78ص321.
الاستلقاء بعد التثاقل
يستحسن في بعض الحالات التي يعيش فيها العبد حالة ( التثاقل ) الروحي أن يستلقي
في جوّ هادئ، ليعيش شيئا من ( التركيز ) الذهني فيما يحسن التفكير فيه..وهذا
الإستلقاء بمثابة إعادةٍ لحالة ( التوازن ) النفسي الذي يخـتل في زحمة الحياة، سواء
في دائرة مشاكله الخاصة أو العامة..ومن هنا نلاحظ التركيز الكثير من الشارع على
أدعية ما قبل النوم، ليستذكر العبد ما نسيه في معترك التعامل مع ما سوى الحق
المتعال.
روح الصلاة
إن على العبد أن يسعى للوصول إلى مرحلة يعيش فيها ( روح ) الصلاة طوال ليله
ونهاره..فإن روح الصلاة هي التوجه للحق، وما الصلاة إلا قمّـة ذلك ( التوجه ) العام،
وهي موعد اللقاء الذي أذن به الحق المتعال لجميع العباد..ومن هنا كان الذاهل عن ربه
- في ليله ونهاره - عاجزا عن الإتيان بالصلاة التي أرادها منه، إذ أنه وصفها بقوله:
"وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين"..و هذه هي من صور الإعجاز، لأن الصلاة على خفّـتها
على البدن، يستشعر ثقلها غير ( الخاشعين )، بما يفوق ثقل بعض الأعمال البدنية
الأخرى.
عدم الذهول عند الخطاب
يحسن بالداعي أن يعيش ولو أدنى درجات ( التوجّـه ) والجديّـة في الخطاب، عند
حديثه مع الرب بقوله: "اللهمّ"..فإن خطاب العظيم مع الذهول عنه - عند ندائه - لمن
صور سوء الأدب الذي قد يوجب عدم التفات ذلك العظيم إلى ما يقوله المتكلم بعد
ذلك..فلا يحسن بالداعي أن يهمل صدر الخطاب وهو ( نداء ) الرب الكريم، ويتوجه بقلبه
في ذيله وهو ( طلب ) الحوائج..إذ يتجلى بذلك حالة النفعية والطمع، مع الإخلال (
بالأدب ) عند مخاطبة العظيم.
الحيران في الأرض
يصوّر الحق - فيما يصور - حالة العبد الضّـال المتحير في هذه الحياة، المبتعد
باختياره عن جادة الهدى، فيقول: "كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب
يدعونه إلى الهدى"..فهو إنسان حائر وكأنه على مفترق طرق عديدة، لا يعلم طريق الخلاص
منها، والشياطين تحيط به تطلب هواه، بمعنى أنها تطلب منه أن يهوى ما فيه ( هلاكه )،
أو بمعنى أنها تطلب منه ( الحب ) والهوى لنفس الشياطين، وذلك بحبّ ما تدعو الشياطين
إليه..فتكون الصورة الثانية أبلغ في تجسيد هذا الخذلان، لأنها تمثل الشياطين وكأنها
امرأة تطلب هوى الغريم، وتسعى لإيقاعه في عشقها، ومن ثَمَّ الفتك بهذا العاشق
البائس بعد ( ارتمائه ) في أحضانهـا.
التصرف في الحس
ذكر الحق في كتابه الكريم: "إذ يغشيكم النعاس أمَـَنة منه"، وقال أيضا: "وإذ
يريكموهم في أعينكم قليلا"، مما يستفاد من ذلك أن الحق يتصرف حتى في ( حواس )
العباد، لمصلحة يراها بحكمته، إضافة إلى تصرفاته في ( النفوس )، كقوله تعالى: "وقذف
في قلوبهم الرعب"..هذا الاعتقاد اليقيني ( بهيمنة) الحق على شؤون العباد، وكونهم
جميعا في قبضته، يبعث المؤمن على الارتياح التام إلى نصرة الحق، ولو استلزم التصرف
في عالم الأبدان، فضلا عن عالم النفوس.
صرف الكيد
ذكر الحق في كتابه مستجيبا لدعاء نبيه يوسف (عليه السلام) فقال: "فاستجاب له
ربه فصرف عنه كيدهن"، مما يدل على أن الحق رغم أنه أعطى العبد الاختيار في الأفعال
- فله أن يختار المعصية أو الطاعة - إلا أنه في الوقت نفسه، حريص على استقامة عبده
الذي ( استخلصه ) لنفسه، وجعله في دائرة رعايته الخاصة، فيصرف عنه موارد الكيد
والفتنة، كما طلبها يوسف (عليه السلام) من ربه..وهذا من مصاديق ( التوفيق ) الذي
يتجلى في تيسير سبيل الطاعة للعبد تارة، وإبعاده عن سبيل المخالفة تارة أخرى، خلافا
( للخذلان ) الذي ينعكس فيه الأمر..ومن هنا تأكّدت الحاجة للدعاء دائما بالتوفيق
وتجنيب الخذلان، ومن دون هذا التوفيق، كيف يستقيم العبد في سيره إلى الحق، مع وجود
العقبات الكبرى في الطريق ؟!..ولهذا يدعو أمير المؤمنين كما روي عنه بقوله: "إلهي
إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق ؟!".
الالتفات إلى العورة
إن العبد الذي غَـلَب على وجوده ( هوى ) المولى، يرى أن الالتفات إلى نفسه (
إرضاء ) لهـا وإعجابا منها بدلا من الالتفات إلى مولاه الحق، كالنظر إلى ما يقبح
النظر إليه كالعورة مثلا..فكما قبح الثاني عند عامة الخلق، فكذلك يقبح الأول عند
الخواص من ذوي المعرفة بالحق، فينتابهم شعور بالخجل عند الارتياح إلى ذواتهم،
وإشباع رغباتهم، كمن بَـدَت عورته على حين غفلة..ولعل هناك ارتباطاً بين أكل الشجرة
المنهيّـة، وبين بدوّ العورة في قوله تعالى: "فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة".
* الشيخ حبيب الكاظمي
2016-01-22