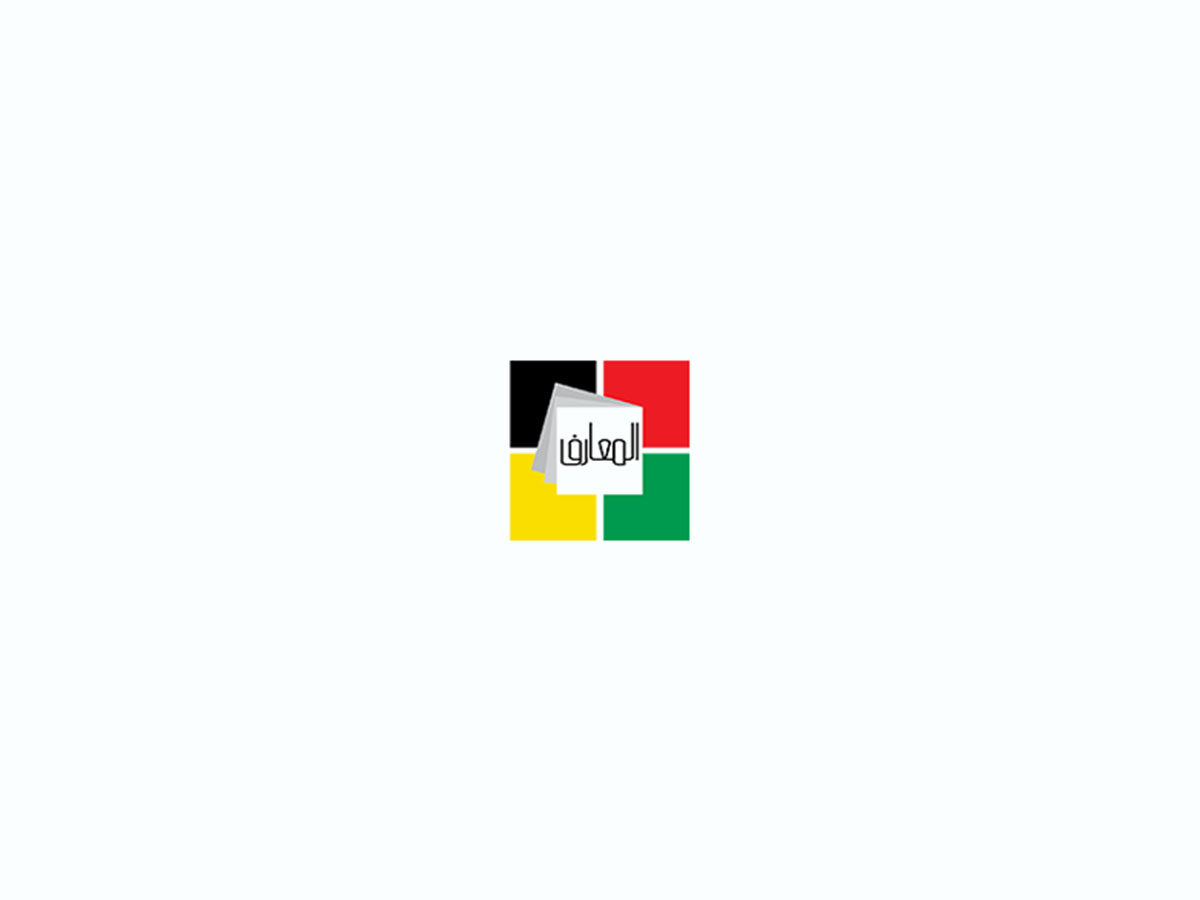أمارة التسديد
من أمارات الصلاح في الطريق الذين يسلكه العبد، هو إحساسه ( بالارتياح ) وانشراح الصدر، مع استشعاره للرعاية الإلهية المواكبة لسيره في ذلك الطريق،
عدد الزوار: 854
من أمارات الصلاح في الطريق الذين يسلكه العبد، هو إحساسه ( بالارتياح )
وانشراح الصدر، مع استشعاره للرعاية الإلهية المواكبة لسيره في ذلك الطريق، وقلب
المؤمن خير دليل له في ذلك..وحالات ( الانتكاس ) والتعثر والفشل، والإحساس (
بالمـلل ) والثقل الروحي مع الفرد الذي يتعامل معه أو النشاط الذي يزاوله، قد يكون
إشارة على مرجوحية الأمر..ولكنه مع ذلك كله، فإن على العبد أن يتعامل مع هذه
العلامة بحذر، لئلا يقع في تلبيس الشيطان.
اختيار الأقرب للرضا
لا ينبغي للمؤمن أن يختار لنفسه المسلك المحببّ إلى نفسه حتى في مجال الطاعة
والعبادة، فمن يرتاح ( للخلوة ) يميل عادة للطاعات الفردية المنسجمة ( مع الاعتزال
)، ومن يرتاح ( للخلق ) يميل للطاعات الاجتماعية الموجبة للأنس ( بالمخلوقين )..بل
المتعين على المستأنس برضا الرب، أن ينظر في كل مرحلة من حياته، إلى ( طبيعة )
العبادة التي يريدها المولى تعالى منه، فترى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عاكفا
على العبادة والخلوة في غار حراء، وعلى دعوة الناس إلى الحق في مكة، وعلى خوض غمار
الحروب في المدينة تارة أخرى، وهكذا الأمر في الأوصياء من بعده.
كالخرقة البالية
تنتاب الإنسان حالة من إدبار القلب، بحيث لا يجد في قلبه خيرا ولا شرا، فيكون
قلبه ( كالخرقة ) البالية كما ورد في بعض الروايات..ففي مثل هذه الحالة يبحث المهتم
بأمر نفسه عن سببٍ لذلك الإدبار، فان اكتشف سببا ( ظاهرا )، من فعل معصية أو ترك
راجح أو ارتكاب مرجوح، حاول الخروج عن تلك الحالة بترك موجب الادبار..وإن لم يعلم (
سبباً ) ظاهرا ترك الأمر بحاله، فلعل ضيقه بما هو فيه، تكفير عن سيئة سابقة أو رفع
لدرجة حاضرة أو دفع للعجب عنه.
لحظات الشروق والغروب
إن لحظات الغروب والشروق مما اهتم بها الشارع من خلال نصوص كثيرة..إذ أنها بدء
مرحلة وختم مرحلة، وصعود للملائكة بكسب العبد خيرا كان أو شرا، وهو الذي يتحول إلى
طائر يلزم عنق الإنسان كما يعبر عنه القرآن الكريم..فهي فرصة جيدة لتصحيح قائمة
الأعمال قبل تثبيتها ( استغفارا ) منها أو تكفيراً عنها..وللعبد في هذه اللحظة
وظيفتان، الأولى: ( استذكار ) نشاطه في اليوم الذي مضى، ومدى مطابقته لمرضاة
الرب..والثانية: ( التفكير ) فيما سيعمله في اليوم الذي سيستقبله..ولو استمر العبد
على هذه الشاكلة - مستعينا بأدعية وآداب الوقتين - لأحدث تغييرا في مسيرة حياته،
تحقيقا لخير أو تجنيبا من شر.
الصفات الكامنة
إن من شؤون المراقبة اللازمة لصلاح القلب، ملاحظة الصفات ( القلبية ) المهلكة
كالحسد والحقد والحرص وغير ذلك..فان أثر هذه الصفات الكامنة في النفس - وان لم
ينعكس خارجا - إلا أنه قد لا يقل أثرا من بعض الذنوب الخارجية في ( ظلمة )
القلب..وليعلم أنه مع عدم استئصال أصل هذه الصفة في النفس، فان صاحب هذه الصفة قد (
يتورّط ) في المعصية المناسبة لها في ساعة الغفلة، أو عند هيجان تلك الحالة
الباطنية، كالماء الذي أثير عكره المترسب.
برمجة اليوم
إن على العبد أن ( يبرمج ) ساعات اليوم من أول اليوم إلى آخره فيما يرضي المولى
جل ذكره، مَثَله في ذلك كمَثَل ( الأجير ) الذي لا بد وأن يُرضي صاحبه من أول الوقت
إلى آخره فيما أراده منه..فإذا أحس العبد بعمق هذه ( المملوكية )، لاعتبر تفويت أية
فرصة من عمره، بمثابة إخلال الأجير بشروط هذه الأجرة المستلزم للعقاب أو
العتاب..وبمراجعة ما كتب في أعمال اليوم والليلة - كمفتاح الفلاح وغيره - تتبين لنا
رغبة المولى في ذكر عبده له في جميع تقلباته، حتى وكأن الأصل في الحياة هو ذكر الحق،
إلا ما خرج لضرورة قاهرة أو لسهو غالب.
خلود المنتسب إلى الحق
إن مما يوجب الخلود والأبديّة للأعمال الفانية، هو ( انتسابها ) للحق المتصف
بالخلود والبقاء..فمن يريد تخليد عمله وسعيه، فلا بد له من تحقيق مثل هذا الانتماء
الموجب للخلود..فلم تكتسب الكعبة - وهي الحجارة السوداء - صفة الخلود كبيت لله
تعالى في الأرض إلا بعد أن انتسب للحق..ولم يكتب الخلود لأعمال إيراهيم وإسماعيل في
بناء بيته الحرام، إلا بعد أن قبل الحق منهما ذلك، وهكذا الأمر في باقي معالم الحج
التي يتجلى فيها تخليد ذكرى إبراهيم الخليل (عليه السلام)..والأعمال ( العظيمة )
بظاهرها والخالية من هذا الانتساب حقيرة فانية،كالصادرة من الظلمة وأعوانهم، سواء
في مجال عمارة المدن، أو فتح البلاد، أو بث العلم، أو بناء المساجد أو غير ذلك.
قوارع القرآن
كثيرا ما يخشى الإنسان على نفسه الحوادث غير ( المترقبة ) في نفسه وأهله
وماله..فيحتاج دائما إلى ترس يحميه من الحوادث قبل وقوعها، ومن هنا تتأكد الحاجة
لالتزام المؤمن بأدعية الأحراز الواقية من المهالك، وهي قوارع القرآن التي من قرأها
( أمِـنَ ) من شياطين الجن والإنس: كآية الكرسي والمعوذات وآية الشهادة والسخرة
والملك..فإن دفع البلاء قبل إبرامه وتحقـقه، أيسر من رفعه بعد ذلك..وقد ورد: "أنه
ليس من عبد إلا وله من الله حافظ وواقية، يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في
بئر، فإذا نزل القضاء خلـيّا بينه وبين كل شيئ"البحار-ج5ص105.
الهيئة الجماعية للطاعة
نقرأ في دعاء شهر رمضان المبارك في الليلة الأولى منه: "أنا ومن لم يعصك سكان
أرضك، فكن علينا بالفضل جوادا"..فالعبد في هذا الدعاء يخلط نفسه بالطائعين، بدعوى
أنه ( يجمعه ) وإياهم سكنى الأرض الواحدة، ليستنـزل الرحمة الإلهية العائدة
للجميع..وبذلك يتحايل العبد ليجد وصفا يجمعه مع المطيعين، ولو كان السكنى في مكان
واحد..وكذلك الأمر عند الاجتماع في مكان واحد، وزمان واحد في أداء الطاعة، كالحج
وصلاة الجماعة والجهاد ومجالس إحياء ذكر أهل البيت (عليهم السلام)، فان الهيئة (
الجماعية ) للطاعة من موجبات ( تعميم ) الرحمة..وقد ورد في الحديث: "إن الملائكة
يمرون على حلق الذكر، فيقومون على رؤسهم ويبكون لبكائهم، ويؤمّنون على دعائهم…فيقول
الله سبحانه:إني قد غفرت لهم وآمنتهم مما يخافون، فيقولون: ربنا إن فيهم فلانا وإنه
لم يذكرك، فيقول الله تعالى: قد غفرت له بمجالسته لهم، فإن الذاكرين من لا يشقى بهم
جليسهم"البحار-ج75ص468.
الأدب الباطني للأكل
إن للأكل آدابا كثيرة مذكورة في محلها، إلا أن من أهم آدابه شعور الإنسان
العميق ( برازقية ) المنعم الذي أخرج صنوفا شتى من أرض تسقى بماء واحد..فمن اللازم
أن ينتابه شعور بالخجل والاستحياء من تواتر هذا الإفضال، رغم عدم القيام بما يكون
شكرا لهذه النعم المتواترة..ومن الغريب أن الإنسان يحس عادة بلزوم الشكر والثناء
تجاه المنعم الظاهري - وهو صاحب الطعام - رغم علمه بأنه واسطة في جلب ذلك الطعام
ليس إلاّ..أولا يجب انقداح مثل هذا الشعور - بل أضعافه بما لا يقاس - بالنسبة إلى
من أبدع خلق ( الطعام )، بل خلق من أعده من ( المخلوقين ) ؟!.
الرغبة الجامحة
إن الميل والرغبة الجامحة في الشيء من دواعي النجاح في أي مجال: دنيويا كان أو
أخرويا..وهذا الميل قد يكون ( طبعيا )، كما في موارد الهوى والشهوة، ولهذا يسترسل
أصحابها وراء مقتضياتها من دون معاناة..وقد يكون ( اكتسابيا ) كما لو حاول العبد
مطابقة هواه مع هوى مولاه فيما يحب ويبغض..وليُعلم أنه مع عدم انقداح مثل هذا الحب
والميل في نفس العبد، فإن سعيه في مجال الطاعة لا يخلو من تكلف و معاناة..فالأساس
الأول للتحليق في عالم العبودية، هو ( استشعار ) مثل هذا الحب تجاه المولى وما يريد،
إذ أن"الذين آمنوا أشد حبا لله".
سوء الظن
كثيرا ما يحس الإنسان بإحساس غير حسن تجاه أخيه المؤمن، وليس لذلك - في كثير من
الأحيان - منشأ عقلائي إلا ( وسوسة ) الشيطان، و ( استيلاء ) الوهم علي القلب
القابل لتلقّي الأوهام..وللشيطان رغبة جامحة في إيقاع العداوة والبغضاء بين
المؤمنين، معتمدا على ذلك ( الوهم ) الذي لا أساس له..ومن هنا جاءت النصوص الشريفة
التي تحث على وضع فعل المؤمن على أحسنه، وألا نقول إلا التي هي احسن، وان ندفع
السيئة بالحسنة، وأن نعطي من حرمنا ونصل من قطعنا، ونعفو عمن ظلمنا، وغير ذلك من
النصوص الكثيرة في هذا المجال.
وظيفة الداعي
ليس المهم في دعوة العباد إلى الله تعالى، كسب العدد والتفاف الأفراد حول
الداعي..وإنما المهم أن يرى المولى عبده ساعياً مجاهداً في هذا المجال..وكلما اشتدت
( المقارعة ) مع العباد، كلما اشتد ( قرب ) العبد من الحق، وإن لم يثمر عمله شيئا
في تحقيق الهدى في القلوب..فهذا نوح (عليه السلام) من الرسل أولي العزم، لبث في
قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، فما آمن معه إلا قليل، بل من الممكن القول بأن دعوة
الأنبياء والأوصياء لم تؤت ثمارها الكاملة كما ارادها الله تعالى لهم، وهو ما
نلاحظه جلياً في دعوة النبي وآله (عليه السلام) للأمة، إذ كان الثابتون على حقهم هم
أقل القليل..فالمهم في الداعي إلى سبيل الحق ( عرض ) بضاعة رابحة ولا يهمه من
المشتري ؟!..وما قيمة البضاعة الفاسدة وإن كثر مشتروها ؟!..أضف إلى كل ذلك أن أجر
الدعوة ودرجات القرب من الحق المتعال، لا يتوقف على التأثير الفعلي في العباد.
هدر العمر بالنوم
إن النوم من الروافد الأصلية التي ( تستنـزف ) نبع الحياة..ومن هنا ينبغي
السيطرة على هذا الرافد، لئلا يهدر رأسمال العبد فيما لا ضرورة له..ولذا ينبغي
التحكم في أول النوم وآخره، ووقته المناسب، وتحاشي ما يوجب ثقله..والملفت في هذا
المجال أن الإنسان كثيرا ما يسترسل في نومه الكاذب، إذ حاجة بدنه الحقيقية للنوم
اقل من نومه الفعلي..فلو ( غالب ) نفسه وطرد عن نفسه الكسل، وهجر الفراش كما يعبر
القران الكريم: "تتجافى جنوبهم عن المضاجع"، فانه سيوفّر على نفسه - ساعات كثيرة -
فيما هو خير له و أبقى..وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: "من كثر
في ليله نومه، فاته من العمل ما لا يستدركه في يومه}و"بئس الغريم النوم، يفني قصير
العمر، ويفوّت كثير الأجر".
الفراق والوصل
إن في الفراق رجاء ( الوصل )، وخاصة إذا اشتد ألم الفراق وطال زمان الهجران،
وفي الوصل خوف ( الفراق )، وخاصة مع عدم مراعاة آداب الوصل بكاملها، ومن هنا كانت
حالة الفراق لديهم - في بعض الحالات - أرجى من حالة الوصل..إذ عند الوصل تعطى
الجائزة ( المقدرة )، بينما عند الفراق يعظم السؤال فيرتفع قدر الجائزة فوق
المقدر..وعند الوصل حيث الإحساس بالوصول إلى شاطئ الأمان ( يسكن ) القلب ويقل الطلب،
وعند الاضطراب في بحر الفراق يشتد التضرع والأنين..وعليه فليسلم العبد فصله ووصله
للحكيم، الذي يحكم بعدله في قلوب العباد ما يشاء و كيف يشاء.
العداء المتأصل
إن القرآن الكريم يدعونا لاتخاذ موقع العداء من الشياطين..وليس المطلوب هو
العداء ( التعبدي ) فحسب، بل العداء ( الواعي ) الذي منشأه الشعور بكيد العدو
وتربّصه الفرص للقضاء على العبد، خصوصا مع الحقد الذي يكنّه تجاه آدم وذريته، إذ
كان خلقه بما صاحبه من تكليف بالسجود مبدأ لشقائه الأبدي، وكأنه بكيده لبنيه يريد
أن ( يشفي ) الغليل مما وقع فيه..وشأن العبد الذي يعيش هذا العداء المتأصل، شأن من
يعيش في بلد هدر فيها دمـه..فكم يبلغ مدي خوفه وحذره ممن يطلب دمه بعد هدره له ؟!.
مؤشر درجة العبد
لو اعتبرنا أن هناك ثمة مؤشر يشير إلى حالات تذبذب الروح تعاليا وتسافلاً، فإن
المؤشر الذي يشير إلى درجة الهبوط الأدنى للروح، هو الذي يحدد المستوى الطبيعي
للعبد في درجاته الروحية..فدرجة العبد هي الحد ( الأدنى ) للهبوط لا الحد ( الأعلى
) في الصعود، إذ أن الدرجة الطبيعية للعبد تابعة لأخس المقدمات لا لأعلاها..فإن
التعالي استثناء لا يقاس عليه، بينما الهبوط موافق لطبيعة النفس الميالة للّعب
واللهو..فهذه هي القاعدة التي يستكشف بها العبد درجته ومقدار قربه من الحق
تعالى..وقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: "من أحب أن يعلم ما له
عند الله، فليعلم ما لله عنده"البحارج73ص40..وبذلك يدرك مدى الضعف الذي يعيشه، وهذا
الإحساس بالضعف بدوره مانع من حصول العجب والتفاخر، بل مدعاة له للخروج منه، إلى
حيث القدرة الثابتة المطردة.
مجالس اللهو والحرام
إن بعض المجالس التي يرتادها العبد، يكون في مظان اللهو أو الوقوع في الحرام،
كالأعراس والأسواق والجلوس مع أهل المعاصي..ومن هنا لزم على المؤمن أن ( يهيئ )
نفسه لتحاشي المزالق قبل ( التورط ) فيما لو اضطر إلى الدخول فيها..وليُعلم أن
الجالس مع قوم إنما يبذل لهم ما هو أهم من المال - وهي اللحظات التي لا تثمن من
حياته - فكما يبخل الإنسان بماله، فالأجدر به أن يبخل ببذل ساعات من عمره للآخرين
من دون عوض..وتعظم ( المصيبة ) عندما يكون ذلك العوض هو ( تعريض ) نفسه لسخط المولى
جل ذكره، فكان كمن بذل ماله في شراء ما فيه هلاكه..وأشد الناس حسرة يوم القيامة من
باع دينه بدنيا غيره.
التفكير في الشهوات
إن التفكير في الشهوات - بإحضار صورها الذهنية - قد تظهر آثاره على البدن،
فيكون كمن مارس الشهوة فعلا يصل إلى حد الجنابة أحيانا..فإذا كان الأمر كذلك في
الأمور ( السافلة )، فكيف بالتفكير المعمق فيما يختص بالأمور ( العالية ) من المبدأ
والمعاد ؟..أولا يُرجى بسببه عروج صاحبه - في عالم الواقع لا الخيال - ليظهر آثار
هذا التفكير حتى على البدن..وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض هذه الآثار بقوله: "تقشعر
منه جلود الذين يخشون ربهم ثمَّ تلين"و{تولَّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا"، أضف
إلى وجل القلوب وخشوعها..بل يصل الأمر إلى حالة الصعق الذي انتاب موسى (عليه السلام)
عند التجلّي، وكان لإبراهيم أزيز كأزيز المرجل، ناهيك عن حالات الرسول (صلى الله
عليه وآله وسلم) عند نزول الوحي، وحالات وصيه (عليه السلام) أثناء القيام بين يدي
المولى جل ذكره.
منبّهية الآلام الروحية
كما أن الآلام ( العضوية ) منبهة على وجود العارض في البدن، فكذلك الآلام (
الروحية ) الموجبة لضيق الصدر، منبّهة على وجود عارض البعد عن الحق..إذ كما انه
بذكر الله تعالى ( تطمئن ) القلوب، فكذلك بالإعراض عنه ( تضيق ) القلوب بما يوجب
الضنك في العيش، فيكون صاحبه كأنما يصّـعد في السماء، والمتحسس لهذا الألم أقرب إلى
العلاج قبل الاستفحال..والذي لا يكتوي بنار البعد عن الحق - كما هو شان الكثيرين -
يكاد يستحيل في حقه الشفاء، إلا في مرحلة: "فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد}،
وعندئذ لا تنفعه هذه البصيرة المتأخرة عن وقت الحاجة.
آيات لأولي الألباب
إن التأثر ( بآيـتيّة ) الآيات متوقفة على وجود ( اللّب ) المدرك لها..فالآية
علامة لذي العلامة، والذي لا يعرف لغة العلامة كيف يتعرّف على ذي العلامة ؟!..فمَثَل
الباحثين في الطبيعة والغافلين عن الحق، كمَثَل من يحلل اللوحة الجميلة إلى أخشاب
وألوان..فتراهم يرهقون أنفسهم في البحث عن مادة اللوحة وألوانها، ولا يدركون شيئا
من جمال نفس اللوحة ولا جمال مصورها، وليس ذلك إلا لانتفاء اللبّ فيهم إذ"ان في ذلك
لآيات لأولي الألباب"..فعيونهم المبصرة والآلة الصماء التي يتم بها الكشف والاختراع
على حد سواء، في انهما لا يبصران من جمال المبدع شيئا.
التسمية نوع استئذان
إن التسمية قبل الفعل - من الأكل وغيره - نوع ( استئذان ) من العبد في التصرف
فيما يملكه الحق، وإن كان الأمر حقيرا عند العبد، فالأمر في جوهره وعند أهله
المستشعرين للطائف العبودية، يتجاوز مرحلة الاستحباب..وهكذا الأمر في جميع الحركات
المستلزمة للتصرف في ملك من أمـلاك المولى جل ذكره..ولهذا فإن كل عمل غير مبدوء بـ
( بسم الله) فهو أبتر، إذ كيف يبارك المولى في عبد لا ينسب عمله إليه، ولا يصدر
منطلقا من رضاه، بل يتصرف في ملكه من دون ( إحراز ) رضاه ؟!.
الإعراض بعد الإدبار
لابد من المراقبة الشديدة للنفس بعد حالات الإقبال - وخاصة - الشديدة
منها..وذلك لأن ( الإعراض ) المفاجئ باختيار العبد - بعد ذلك الإقبال - يُـعد نوع (
سوء ) أدب مع المولى الذي منّ على عبده بالإقبال وهو الغني عن العالمين..ولطالما
يتفق مثل هذا الإقبال - في ملأ من الناس - بعد ذكر لله تعالى، أو التجاء إلى
أوليائه (عليه السلام)، وعند الفراغ من ذلك يسترسل العبد في الإقبال على الخلق،
فيما لا يرضي الحق: من لغو في قول، أو ممقوت من مزاح، أو وقوع في عرض مؤمن أو غير
ذلك..ومثل هذا الإدبار الاختياري قد ( يحرم ) العبد نعمة إقبال الحق عليه مرة أخرى،
وهي عقوبة قاسية لو تعقّلها العبد..نعم قد يتفق الإدبار المفاجئ - مع عدم اختيار
العبد - دفعا للعجب عنه، وتذكيرا له بتصريف المولى جل ذكره لقلب عبده المؤمن كيفما
شاء.
مؤلفات المنحرفين
إن مما ينبغي الحذر منه، هو ما وصل إلينا من مؤلفات المنحرفين عن خط أهل البيت
(عليه السلام) - قصورا كان الانحراف أو تقصيرا - وخاصة فيما كان في مجال الأخلاق
والاعتقاد..فمن الدواعـي الخفـية التي جعلت البعض منهم يتخذ لنفسه اتجاهاً أخلاقيا
متميزا ليجـذب به قلوب المريدين، هو ( منافسة ) خط أئمة أهل البيت (عليه السلام) في
ذلك، و ( استلاب ) القلوب المتعطشة للمعارف الإلهية..وخاصة أن الأئمة (عليه السلام)
لهم منهجهم المستقل في مجال تهذيب السلوك الإنساني المتمثل في: ( الاستقامة ) على
طريق الشرع أولا، و( الاعتدال ) في السير ثانيا، و( الجامعية ) لكل جهات التكليف
ثالثا..وقد درّبوا خواصهم على هذا المنهج الذي افرز الكثير ممن يتأسى بهم في هذا
المجال..وينبغي الالتفات إلى أن حث عامة الناس على الرجوع إليهم قد يؤدي - من دون
قصد - إلى صرف الناس عن خط أئمتهم (عليه السلام)، أو على الأقل عدم استنكار البنية
العقائدية لمخالفيهم.
القلب حرم الله تعالى
إن اشتغال القلب بغير الله تعالى مذموم حتى عند الاشتغال ( بالصالحات ) من
الأعمال كقضاء حوائج الخلق وأشباهه..فقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه
قال: "القلب حرم الله تعالى، فلا تُدخل حرم الله غير الله}البحار-ج70ص25..فالمطلوب
من العبد أن لا يذهل عن ذكر مولاه، وإن اشتغلت الجوارح بعمل قربي لله فيه رضاً..فإن
( حسن ) اشتغال الجارحة بالعبادة لا ( يجبر ) قبح خلو الجانحة من ذكر الحق، فلكل من
الجوانح والجوارح وظائفهما اللائقة بهما..وحساب كل منهما بحسبه، فقد يثاب احداهما
ويعاقب الأخرى كما يشير إليه الحديث: "إن الله يحب عبدا ويبغض عمله، و يبغض العبد
ويحب عمله}البحار-ج46ص233..والخلط بينهـما مزلق للأولياء عظيم..وهذا الأمر وإن بدا
الجمع بينهما صعبا، إلا إنه مع المزاولة والمصابرة يتم الجمع بين المقامين،كما كان
الأمر كذلك عندهم صلوات الله عليهم أجمعين.
استغلال أية فرصة
إن من الأمور المهمة التي قد يغفل عنها العبد هو استغلال ساعة ( الإقبال ) على
المولى في أي ظرف كان صاحبه..فقد تأتي هذه المنحة الإلهية على حين ( غفلة ) من
صاحبها، وفي حالة ( يجلّ ) الإنسان ربه في أن يذكره في تلك الحالة كالأماكن
المستقذرة، كما يشير إليه ما روي عن موسى (عليه السلام) إذ سأل ربه فقال: إني أكون
في حال أجلك أن أذكرك فيها، فجاءه الجواب: "يا موسى اذكرني على كل
حال"البحار-ج3ص329..فليس للعبد أن يُعرض - حتى في تلك الساعة - عن ربه مع إقبال
الحق عليه، فان ذلك مدعاة لتعريض هذه النعمة الكبرى للزوال..وقد يتفق الإقبال في
المواطن المناسبة لذلك، فيرق القلب من دون مجاهدة تذكر كمجالس رثاء أهل البيت (عليه
السلام)، فما أحرى بأصحابها أن يستغلّوا حالة الرقة التي تنتاب حتى غير الصالحين
منهم في تلك المجالس، وذلك بالتوجه إلى الله تعالى وخاصة بعد الفراغ من المجلس،
فإنها من المظان الكبرى لاستجابة الدعاء.
تصريف الحق للأمور
كما يتولى الحق تعالى تصريف ( جزئيات ) عالم الخلق، إذ ما تسقط من ورقة إلا
بعلمه، ولولا الإذن لما تحقق السقوط الذي تعلق به العلم، فكذلك الأمر فيمن ( شملته
) يد العناية الإلهية، فيتولى الحق تعالى تصريف شؤونه في كل صغيرة وكبيرة..ومن هنا
أُمر موسى(عليه السلام) بالرجوع إلى الحق، حتى في ملح عجينه وعلف دابته..ومن
المعلوم أن هذا الإحساس ( يعمّق ) الود بين العبد وربه، ناهيك عما يضفيه هذا الشعور
من سكينة واطمئنان على مجمل حركته في الحياة..ومن هنا ينسب الحق أمور النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) من الطلاق والزواج إلى نفسه فيقول: "عسى ربه إن طلقكن" و"فلما
قضى زيد منها وطرا زوجناكها".
الأجر الجزيل على القليل
قد يستغرب البعض من ترتب بعض ما روي من ( عظيم ) الثواب على اليسير من
العبادة..ولو كان هذا الاستغراب بمثابة عارض أوّلى لا قرار له في النفس لهان الأمر،
ولكن الجاد في استغرابه، فإنما هو قاصر: إمّا في إدراك ( قدرة ) المولى على استحداث
ما لم يخطر على قلب بشر بمقتضى إرادته التكوينية المنبعثة من الكاف والنون، أو في
إدراك مدى ( كرمه ) وسعة تفضله الذي استقامت به السموات والأرض..فمن يجمع بين
القدرة القاهرة و العطاء بلا حساب، فإنه لا يعجزه الأجر الذي لا يقاس إلى العمل..إذ
الثواب المبذول إنما هو اقرب للعطايا منه إلى الأجور..وليعلم أخيرا أن نسبة قدرة
الحق المتعال إلى الأمر - الحقير والجليل - على حد سواء..فلماذا العجب بعد ذلك ؟!.
ملكوت الصلاة
إن الصلاة مركب اعتباري ركب أجزاءه العالم بمواقع النجوم..فالحكيم الذي وضع
الأفلاك في مسارها هو الذي وضع أجزاء هذا المركّب في مواقعها، ولهذا كان ( الإخلال
) العمدي بظاهرها مما يوجب عدم سقوط التكليف، لعدم تحقق المركب بانتفاء بعض
أجزائه..وليعلم أن بموازاة هذا لمركب الاعتباري ( الظاهري )، هنالك مركب اعتباري (
معنوي ) يجمعه ملكوت كل جزء من أجزاء الصلاة..فالذي يأتي بالظاهر خاليا من الباطن،
فقد أخل بالمركب الاعتباري الآخر بكله أو ببعضه..ومن هنا صرحت الروايات بحقيقة: "أنه
ما لك من صلاتك إلا ما أقبلت فيها بقلبك"البحار- ج81 ص260.
الطهارة الظاهرية والباطنية
أكد المشرع الحكيم على طهارة البدن والساتر والأرض في حال الصلاة، التي هي أرقى
صور العبودية للحق المتعال،كما يفهم من خلال جعلها عمودا للدين ومعراجا
للمؤمن..ولعل الأقرب إلى تحقيق روح الصلاة، هو الاهتمام بتحقيق الطهارة ( الداخلية
) في جميع أبعاد الوجود، بل هجران الرجز لا تركه فحسب لقوله تعالى: "والرجز
فاهجر"..فالهجران نوع قطيعة مترتبة على بغض المهجور المنافر لطبع المقاطع
له..فالمتدنس ( بباطنه ) لا يستحق مواجهة الحق وان تطهّر بظاهره، حيث أن المتدنس -
جهلا وقصورا - لا يؤذن له باللقاء وان اُعذر في فعله..كما أن المتدنس ( بظاهره ) لا
يؤذن له بمواجهة السلطان، وإن كان جاهلا بقذارته.
الصورة الذهنية الكاذبة
إن ما يدفع الإنسان نحو الملذات واقتناء أنواع المتاع، هو الصورة ( الذهنية )
المضخمة - التي لا تطابق الواقع غالبا - لتلك اللـذة..والسر في ذلك كما يذكر القرآن
الكريم، هو تزيين الشيطان ما في الأرض للإنسان بحيث لايرى الأشياء كما هي، ومن هنا
أمرنا بالدعاء قائلين: "اللهم أرنا الأشياء كما هي"..ولطالما يصاب صاحبها بخيبة أمل
شديدة عندما يصل إلى لذته، فلا يجد فيها تلك الحلاوة الموهومة، وبالتالي لا يجد ما
يبرر شوقه السابق، كالأحلام الكاذبة التي يراها الشاب قبل زواجه..ويكون ( تكرّر )
هذا الإحباط مدعاة ( للملل ) من الدنيا وما فيها..وهذا هو السر في استحداث أهل
الهوى وسائل غريبة للاستمتاع يصل إلى حد الجنون !..أما النفوس المطمئنة - بحقيقة
فناء اللذات وعدم مطابقة الواقعية منها لما تخيلها صاحبها، بل وجود لذائد أخري ما
وراء الحس لا تقاس بلذائذ عالم الحس - ففي غنى عن تجارب المعاناة والإحباط،
لاكتشافهم الجديد الباقي حتى في عالم اللذات، إذ أن كل نعيم دون الجنة مملول.
الخسارة الدائمة
إن الإنسان يعيش حالة خسارة دائمة، إذ أن كل نَفَس من أنفاسه ( قطعة ) من عمره،
فلو لم يتحول إلى شحنة طاعة، لذهب ( سدىً ) بل أورث حسرة وندامة..ولو عاش العبد
حقيقة هذه الخسارة لانتابته حالة من الدهشة القاتلة!..فكيف يرضى العبد أن يهدر في
كل آن، ما به يمكن أن يكتسب الخلود في مقعد صدق عند مليك مقتدر ؟!..وقد ورد في
الحديث: "خسر من ذهبت حياته وعمره، فيما يباعده من الله عز
وجل"البحار-ج10ص110..والملفت حقا في هذا المجال أن كل آن من آناء عمره، حصيلة
تفاعلات كبرى في عالم الأنفس والآفاق، إذ أن هذا النظم المتقن في كل عوالم الوجود -
كقوانين السلامة في البدن و تعادل التجاذب في الكون - هو الذي أفرز السلامة
والعافية للعبد كي يعمل، فما العذر بعد ذلك ؟!..وإيقاف الخسارة في أية مرحلة من
العمر - ربح في حد نفسه - لا ينبغي تفويته، فلا ينبغي ( التقاعس ) بدعوى فوات
الأوان، ومجمل القول: أن الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل فيهما.
أدنى الحظوظ وأعلاها
لكل من القلب والعقل والبدن حظّه من العبادة، نظرا لتفاعله الخاص به، فللأول (
المشاعر )، وللثاني ( الإدراك )، وللثالث ( الحركة ) الخارجية..وأدنى الحظوظ إنما
هو للبدن، لأنها أبعد الأقمار عن شمس الحقيقة الإنسانية..وقد انعكس الأمر عند عامة
الخلق، فصرفوا جُلّ اهتمامهم في العبادة إلى حظ البدن، وصل بهم إلى حد الوسوسة
المخرجة لهم عن روح العبادة التي أرادها المولى منهم، مهملين بذلك أمر اللطيفة
الربانية المودعة فيهم..ومن هنا لا نجد لعباداتهم كثير أثر يذكر غير الإجراء وعدم
لزوم القضاء..ومن المعلوم أن هذا الأُنس الظاهري بالعبادة، متأثر بطبيعة النفس التي
تتعامل مع الحقائق من خلال مظاهرها المادية، وليست لها القدرة - من دون مجاهدة -
على شهود الحقائق بواقعيتها، ومن هنا عُلم منـزلة إبراهيم الخليل (عليه السلام)
الذي أراه الحق ملكوت السماوات والأرض.
مخالفة النفس فيما تهوى
إن مخالفة النفس فيما تهوى وتكره لمن أهم أسس التزكية، وخاصة عند ( إصرار )
النفس على رغبة جامحة في مأكل، أو ملبس، أو غير ذلك..فان الوقوف أمام النفس - ولو
في بعض الحالات - ضروري لتعويد النفس على التنازل عن هواها لحكم العقل، ولإشعارها
أن للعقل دوره الفعّال في إدارة شؤون النفس، بتنصيب من المولى الذي جعل العقل رسولاً
باطنياً، وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: "إذا صعبت عليك نفسك،
فاصعب لها تذلّ لك"البحارج78ص119..ومن الملحوظ إحساس العبد ( بهالة ) من السمو
والعزة، عند مخالفة شهوة من الشهوات، وهذه الحالة جائزة معجلة في الدنيا قبل الآخرة،
إذ يجد حلاوة الإيمان في قلبه..هذه الحلاوة تجبر حرمان النفس من الشهوة العاجلة، بل
يصل الأمر إلى أن يعيش الإنسان حالة التلذذ في ترك اللذائذ، لما فيها من السمو
والتعالي عن مقتضيات الطبع، بل يصل الأمر عند - الكمّلين - إلى مرحلة يتلذذون فيها
( برضا ) الحق عنهم حين تلذذهم بالمباحات، أكثر من تلذذهم ( باللذة ) نفسها..فمثلا
يرون أن لذة رضا المولى على عبده بالزواج، ألذ لديهم من عملية المعاشرة نفسها، وهذا
معنىً لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم.
التجلي في الآفاق والأنفس
لقد تجلّى الحق في عالم ( الآفاق )، فأوجد هذا النظام المتقن الذي أذهل أرباب
العقول على مر العصور..فكيف إذا أراد الحق أن يتجلى لعبده في عالم ( الأنفس ) فيمن
أراد سياسته وتقويمه ؟!..ولئن كانت العجائب لا تعد في عالم الآفاق، فان العجائب لا
تدرك في عالم الأنفس!!..ولا عجب في ذلك، فإن المبدع في عالم الآفاق هو بنفسه المبدع
في عالم الأنفس، بل اكثر تجليـّا فيها، لأنها ( عرش ) تجليه الأعظم..فالمهم في
العبد أن يعّرض نفسه لهذه النفحات، حتى يصل إلى مرحلة: "عبدي أطعني تكن مَثَلي،
أقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون".
المال آلة اللذائذ
إن المال آلة لكسب اللذائذ، فالذي لا تأسره لذائد المادة، لا يجد في نفسه مبررا
للحرص والولع في جمعه، كما هو الغالب على أهل اللذائذ، لأن لذائذهم لا تشترى إلا
بالمال كلذة البطن والفرج، وهو المتعالي عن تلك اللذائذ..وبهذا ( التعالي ) النفسي
يكون قد خرج من أسر عظيم وقع فيه أهل الدنيا..وأما الذي ( ترقّى ) عن عالم اللذائذ
الحسية، فإن له شغل شاغل عن جمع المال بل عن الالتفات إليه، إذ أن من لا تغريه
اللذة، لا تغريه مادتها أي ( المال )..وهذه هي المرحلة التي لا يجد فيها العبد كثير
معاناة في دفع شهوة المال عن نفسه، إذ اللذائذ أسيرة له، لا هو أسير لهـا.
اللقاء في الأسحار
إن القيام في الأسحار بمثابة لقاء المولى مع خواص عبيده، ولهذا لا ( تتسنى )
هذه الدعوة إلا لمن نظر إليه المولى بعين ( اللطف ) والرضا، وهي الساعة التي يكاد
يطبق فيها نوم الغفلة حتى البهائم..ومن المعلوم أن نفس قيام الليل - مع قطع النظر
عن حالة الإقبال - مكسب عظيم، لما فيه من الخروج على سلطان النوم القاهر، فكيف إذا
اقترن ذلك بحالة الالتجاء والتضرّع ؟!..ومن هنا جعل المولى جل ذكره ( ابتعاث )
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المقام المحمود مرتبطا بتهجده في الأسحار، رغم
حيازته للملكات العظيمة الأخرى..ويمكن القول - باطمئنان - أن قيام الليل هو القاسم
المشترك بين جميع الأولياء والصلحاء، الذين يشتد شوقهم إلى الليل ترقّباً للذائذ
الأسحار..وقد روي عن الإمام العسكري (عليه السلام) أنه قال: "الوصول إلى الله، سفر
لا يدرك إلا بامتطاء الليل"البحار-ج78ص379.
التشويش الباطني
إن من الضروري لمن يريد الثبات في السير إلى الله تعالى، أن يستبعد عن طريقه كل
موجبات القلق والاضطراب، فإن التشويش الباطني بمثابة تحريك العصا في الماء العكر،
الذي يُخرجه عن صفة المرآتية للصور الجميلة والحالة تلك!..وإن استبعاد موجبات القلق
يكون: بدفعها وعدم التعرض لها ( كعدم ) الاستدانة مع العجز عن السداد..ويكون برفعها
وإزالة الموجب لهـا ( كأداء ) الدين مع القدرة على أدائها..ويكون بالتعالي وصرف
الذهن عنها مع العجز التام عن الدفع والرفع ( كالعاجز ) عن السداد بعد
الاستدانة..وتفويض الأمر في كل المراحل - خصوصا الأخيرة - إلى مسبِّب الأسباب من
غير سبب.
دواعي الهدى والهوى
إن الإخلاد إلى الأرض والركون إلى الشهوات البهيمية مما يوافق دواعي الهوى،
وبذلك تكون حركة الإنسان نحوها سريعة للغاية لو استرسل في شهواته ولم يغالبها، وفي
هذا السياق يبدي أمير المؤمنين (عليه السلام) تعجبه بقوله: "كيف يستطيع الهدى من
يغلبه الهوى ؟"..ولكنه في الوقت نفسه فإن التعالي والسمو إلى درجات القرب من الحق
أيضا مما يوافق دواعي الهدى، وهي إرادة الحق ورغبته، بل دعوته الأكيدة للناس إليه
بقوله: "ففروا إلى الله"..فكما أن الهوى في عالم التكوين سائق لصاحبه إلى الهاوية،
فإن ( مشيئة ) الحق، وارداته ( التشريعية ) لطهارة العبيد كذلك ( تيسّر ) سبيل
الوصول لمن تعرض لنفحات تلك الإرادة التي عبّر عنها الحق بقوله: "ولكن يريد ليطهركم".
البلاء المعوض
إن البلاء الذي يصيب المؤمن الذي اخلص حياته لله رب العالمين، بمثابة البلاء
الذي يصيب العامل أثناء العمل مع من ضمن له الخسارة في نفسه وبدنه..فمع علمه بأن كل
بلاء يصيبه فهو ( مضمون ) العوض، فإنه لا ( يستوحش ) لتوارد البلاء مهما كان
شديدا..بل قد يفرح - في قرارة نفسه - لو علم بالعوض المضاعف الذي لا يتناسب مع حجم
الخسارة، وهذا خلافا لمن يصيبه البلاء وهو لا يعلم انه رفع لدرجة أو كفارة لسيئة،
فيستوحش من أدنى البلاء يصيبه، لما يرى فيه من تفويتٍ للّذائذ من دون تعويض.
العبثية في السلوك
إن الخوض فيما لايعني مصداق لحالة العبثية و ( اللاجدية ) في سلوك الإنسان، وهو
من موجبات قساوة القلب..إذ القلب المشتغل بأمر لا يحتمل الاشتغال بأمر آخر، ولو كان
اللاحق أنفع من سابقه..فليتأمل في مضمون هذا الحديث القدسي: "يا ابن آدم إذا وجدت
قساوة في قلبك، وسقما في جسمك، ونقصا في مالك، وحريمة في رزقك، فاعلم انك قد تكلمت
فيما لا يعنيك"..فإذا كان الخوض فيما لا يعني - ولو كان حلالاً - مما تترتب عليه
هذه الآثار المهلكة، فكيف بالخوض في ( الحرام ) ؟!.
هندسة التكامل
إن الذي يريد أن يحقق مستوى من التكامل الروحي في حياته، عليه أن يمتلك خطة
مدروسة: لها ( مراحلها ) المتدرجة، ولها ( تقسيمها ) الزمني لكل مرحلة، وفيها (
دراسة ) لنقاط ضعفه وقوته، وفيها ( ملاحظة ) لتجارب الآخرين، وفيها ( معرفة )
للعوارض التي تنتاب مجمل السائرين في الطريق: كالقبض والبسط، وإعراض الخلق، وضيق
الصدر، وهجوم الوساوس..هذا المخطط ببعديه النظري والعملي، ينبغي أن يكون واضحا
دائما للسائرين إلى الله تعالى، وإلا كان صاحبها كمن يحتطب ليلا..إذ كما أن هندسة
البناء المادي - وإن طال البحث فيها - أساس لنجاح البناء خارجاً، فكذلك الأمر في
البناء المعنوي، فإن وضوح الخطـة وإتقانها، وهندسة مراحلها، مدعاة للسير على هدى
واطمئنان، وهذا بخلاف السائر على غير ( هدى )، فإنه لا تزيده كثرة السير إلا بعداً.
الصلاة موعد اللقاء
إن من اللازم أن نتعامل مع ( وقت ) الصلاة على أنه موعد اللقاء مع من بيده
مقاليد الأمور كلها..ومع ( الأذان ) على انه إذن رسمي بالتشريف..ومع ( الساتر )
بزينته على انه الزيّ الرسمي للّقاء..ومع ( المسجد ) على أنه قاعة السلطان
الكبرى..ومع ( القراءة ) على أنه حديث الرب مع العبد..ومع ( الدعاء ) على أنه حديث
العبد مع الرب..ومع ( التسليم ) على أنه إنهاء لهذا اللقاء المبارك، والذي يفترض
فيه أن تنتاب الإنسان عنده حـالة من ألم الفراق والتوديع..ومن هنا تهيّب الأولياء
من الدخول في الصلاة، وأسفوا للخروج منها.
فرق الحال عن المقام
إن هناك فرقا واضحا بين الحالات الروحية ( المتقطعة ) التي تعطى للعبد - بحسب
قابليته - بين فترة وأخرى، وبين المقامات الروحية ( الثابتة ) التي لا تفارق صاحبها
أبدا..واستبدال الحال بالمقام يفتقر إلى رؤية واضحة للحالتين، ومعرفة بموجباتهما،
وتجربة خاصة للعبد المراقب لنفسه..ومجمل القول: أن استمرار الحالات الروحية
المتقطعة، وتحاشي موجبات الإدبار، والالتزام العملي الدقيق بما يرضي المولى تبارك
وتعالى، والالتجاء الدائم إليه بالتوسل بمن لديهم أرقى درجات الزلفى لديه..كل هذه
الأمور دخيلة في تحويل الحالات المتناوبة إلى مقامات ثابتة، ولكن بعد فترة من
الصمود والاستقامة فيما ذكر.
مرحلة الاصطفاء
قد يصل العبد بعد مرحلة طويلة من ( المجاهدة ) في طريق الحق إلى مرحلة (
الاصطفاء ) الإلهي له..ومن مميزات هذه المرحلة أن العبد يعيش فيها حالة القرب
الثابت من الحق - حتى مع عدم بذل جهد مرهق - في هذا المجال..فهو يعيش حالة حضور (
دائم ) بين يدي المولى سبحانه، إذ العالم كله محضر قدسه، بكل ما في هذا الحضور من
آداب الضيافة الربوبية، التي لم تتم لولا دعوة الحق المتعال عبده إلى نفسه اكراما
وحبـّا له..وقد روي أن موسى (عليه السلام) سأل ربه: يارب وددت أن أعلم من تحب من
عبادك فأحبه، فأجابه: "إذا رأيت عبدي يكثر ذكري، فأنا أذنت له في ذلك وأنا
أحبه"البحار-ج93ص160..والتأمل في هذا المضمون النادر، يفتح آفاقاً للذاكر وخاصة في
بداية الطريق.
ساعات الجد الواقعي
إن كل نشاط وحركة ( جـدّ ) في الحياة، لهو أقرب إلى ( اللهو ) والبطالة، إن لم
يكن في سبيل مرضاته تعالى..فما يمنّي به بعضهم نفسه بأنه مشغول طول وقته بالبحث
العلمي، أو التجارة، أو عمران البلاد، أو سياسة العباد، أشبه بسراب يحسبه الظمآن
ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وذلك فيما لو إنتفى قصد القربة الذي يضفي الجدية
على كل سلوك..وقد ذكر القرآن الكريم الأخسرين أعمالاً بقوله: "الذين ضلّ سعيهم في
الحياة الدنيا، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا".. ورأس ساعات الجد هو ساعة ( الإقبال
) على المولى بكل أركان الوجود وذلك في الصلاة وغيرها، ومن ساعة الجد هذه يترشح
الجد على الساعات الأخرى من الحياة..وقد بيّن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه
إلى واليه على مصر مالك الأشتر موقع الصلاة من الاعمال بقوله: "واعلم أن كل شئ من
عملك تابع لصلاتك، واعلم أنه من ضيع الصلاة، فإنه لغير الصلاة من شرائع الإسلام
أضيع"تحف العقول-ص126.
التعالي قاصم للظهر
إن من الواضحات التي ينبغي الالتفات إليها دوما ضرورة تحاشي الإحساس ( بالعلوّ
) على المخلوقين..فهذا الترفع ولو كان في - باطن النفس - لمن قواصم الظهر،كما قصم
من قبل ظهر إبليس، مع سابقته قليلة النظير في عبادة الحق..وطرد هذا الشعور يتوقف
على الاعتقاد بأن بواطن الخلق محجوبة إلا عن رب العالمين، فكيف جاز لنا قياس (
المعلوم ) من حالاتنا، إلى المجهول من حالات الآخرين، بل قياس ( المجهول ) من
حالاتنا إلى المجهول من حالاتهم، ثم الحكـم بالتفاضل ؟!..أضف إلى جهالة الإنسان
بخواتيم الأعمال وهو مدار الحساب والعقاب..ومن هنا أشفق المشفقون من الأولياء من
سوء الخاتمة، لتظافر جهود الشياطين على سلب العاقبة المحمودة للسائرين على درب
الهدى، ولو في ختام الحلبة، إذ أنها ساعة الحسم، ولطالما افلحوا في ذلك.
انحراف المدعين للمقامات
يتحير بعضهم في تفسير انحراف من أوتي نصيبا من العلم - حتى الإلهي منه - إذ
تراهم يحلّقون في دعوى الحب الإلهي، وكشف حقائق عالم الوجود كما يدعونها في
منظوماتهم ومنثوراتهم..ومن الأمثلة القرآنية على ذلك ( بلعم ) الذي أوتي الاسم
الأعظم، وقد وصفه القرآن بأنه أوتي الآيات، فأسند المولى الإيتاء إلى نفسه فقال: {آتيناه}،
ومن ثم جمع ما آتاه فقال: {آياتنا}..وقد روي عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: "الأصل
في ذلك بلعم، ثم ضرب الله مثلاً لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبلة"مجمع
البيان-ج2ص499..ولا غرابة في هذا الأمر، إذ أن العبد في كل مرحلة هو في شأن، و(
الاستقامة ) في العبودية من جانب العبد، فرع ( الحصانة ) الربوبية من جانب
الرب..هذه الحصانة التي لو رفعت عن العبد - بجريرة ارتكبها - لهوت به الريح في مكان
سحيق..ولـيُعلم في هذا المجال أن الحديث عن منازل الكمال وأسرار الطريق، يتوقف على
نوع معرفة يكتسبها صاحبها: بالتأمل، أو الرياضة النفسية، أو الاكتساب من
الغير..وهذا المقدار من المعرفة النظرية لا دلالة فيها على كمال صاحبها بالضرورة،
فهو علم لا يستلزم الكمال بمجرده..كما قد يتفق ذلك كثيرا لأرباب العلوم الأخرى
كالطب والحكمة، فتجد الطبيب سقيما والحكيم يرتكب ما هو أقرب إلى السفه.
الأوقات المباركة
إن ( قصر ) فترة الحياة الدنيا - قياسا إلى الفترة اللامتناهية - من الحياة
العقبى، يجعل الإنسان ( محدوداً ) في كسبه، وخاصة أنه يريد بكسبه المحدود تقرير
مصيره الأبدي سعادةً أو شقاء، إذ الدنيا مزرعة الآخرة..ولهذا منح الرب الكريم بعض
الأوقات وبعض الأعمال من البركات والآثار، ( تعويضا ) لقصر الدنيا بما يذهل الألباب!!..فليلة
القدر خير من ألف شهر، وتفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة، وقضاء حاجة مؤمن أفضل من
عتق ألف رقبة لوجه الله، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، إلى غير ذلك
من النماذج الكثيرة في روايات ثواب الأعمال.
حالة المصلي في المسجد
إن على العبد - عند دخول المسجد - أن يستحضر ( مالكية ) المولى لذلك المكان و (
انتسابه ) إليه كبيت من بيوته، فيعظم توقيره لذلك المكان ويزداد أنسه به، إذ الميل
إلى المحبوب يستلزم الميل إلى ( متعلقاته ) ومنها الأمكنة المنتسبة إليه..ويكون
لصلاته في ذلك البيت المنتسب للرب تعالى، وقع متميز في نفسه، فيعظم معها أمله
بالإجابة..كما يحنو بقلبه على المصطفين معه في صفوف الطاعة لله تعالى، إذ يجمعه بهم
جامع التوقير له والوقوف بين يديه..كل هذه المشاعر المباركة وغيرها، فرع تحقق
الحالة الوجدانية التي ذكرناها..ومن هنا يعلم السر في مباركة الحق في جمع المصلين
في بيوته بما لا يخطر على الأذهان، بل قد ورد أن الشيطان لا يمنع شيئا من العبادات
كمنعه للجماعة ( العروة الوثقى-احكام الجماعة ).
* الشيخ حبيب الكاظمي
2016-01-22