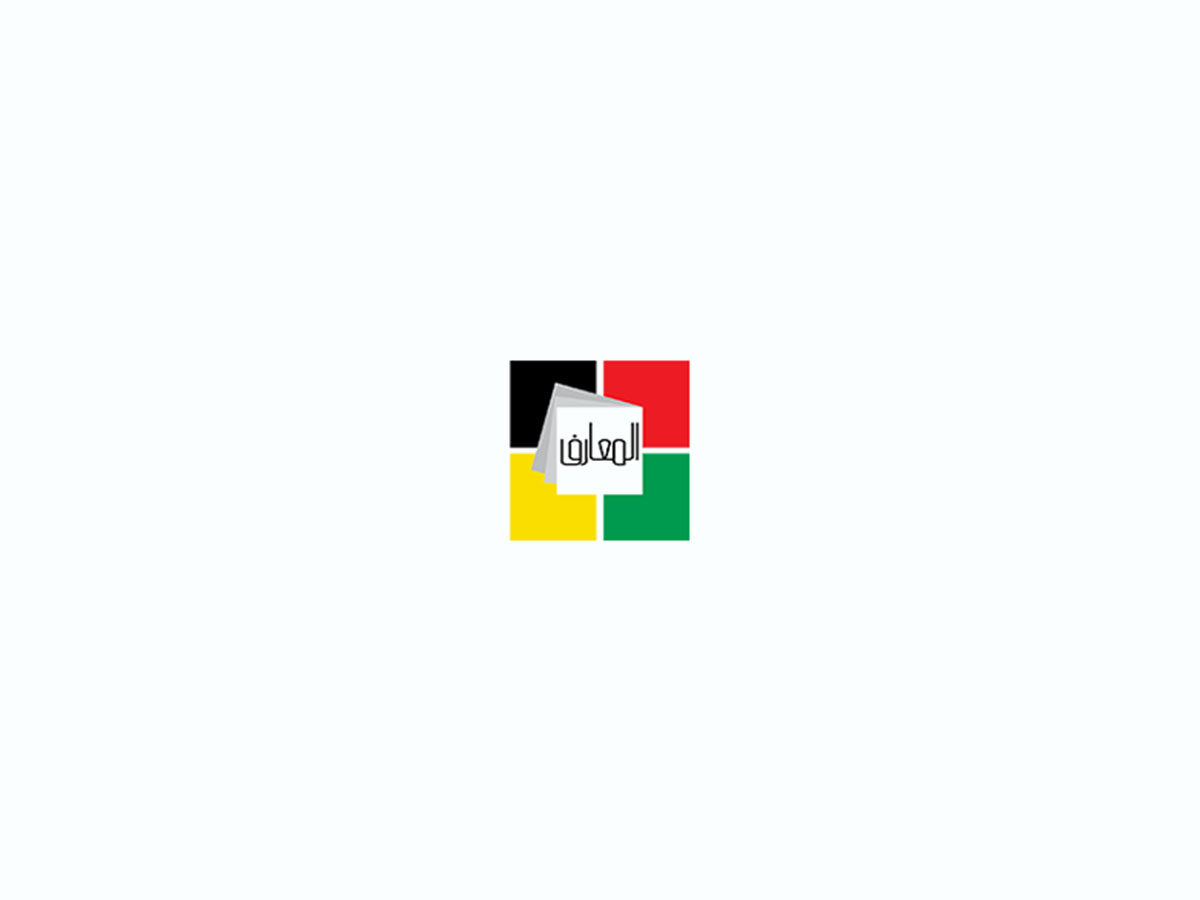تحويل المعلومة إلى عقيدة
إن الصعوبة الكبرى في عالم التكامل، تكمن في عدم قدرة العبد على تحويل ( المعلومة ) الذهنية إلى ( عقيدة ) قلبية، فقد يكون لديه كمٌ كبير من الأفكار الصائبة والمفاهيم الحقّـة،
عدد الزوار: 839
إن الصعوبة الكبرى في عالم التكامل، تكمن في عدم قدرة العبد على تحويل (
المعلومة ) الذهنية إلى ( عقيدة ) قلبية، فقد يكون لديه كمٌ كبير من الأفكار
الصائبة والمفاهيم الحقّـة، إلا أنه لم يترجمها إلى شحنة دافعة في أعماق وجوده
تحركه نحو الكمال، ولهذا لا يجد لهذه المفاهيم ( داعويّة ) في نفسه، ومحركية
لإرادته، فتكون كالأسفار المحمولة !!..وهناك سبلٌ كثيرة ودقيقة بل معقدة، لتحويل
المعلومة إلى عقيدة منها: البلوغ النفسي، والاستحضار الدائم للفكرة تذكيراً لنفسه
وتواصياً لغيره، وتحاشي العمل بما ينافيها، والإصرار على التطبيق عند منافرة الطبع
لها، والعيش في ضمن الأجواء المحفّزة لهـا، والاستمداد الدائم من الحق، ليتحقق في
العبد مضمون قوله تعالى: "وربطنا على قلوبهم"و"أفرغ علينا صبرا"و"فزادهم
إيماناً"و"آتاهم تقواهم"و"ويزيد الله الذين اهتدوا هدىً".
المجاهدة الدفعية والمستمرة
ورد في حديث الاستظلال بظل العرش ذكر سبعة أصناف منهم: "وشاب نشأ في عبادة الله
عزّ وجلّ..ورجلٌ دعته امرأة ذات حسبٌ وجمال فقال إني أخاف
الله"البحار-ج26ص261..فالملاحظ أن هناك صنفاً تكتسب هذه المزية العليا في ذلك
الموقف العصيب، بالمجاهدة المستمرة التي تفيدها عبــارة ( نشأ في عبادة الله )..إلا
أن هناك صنفاً آخر حاز على الرتبة نفسها بمعاملة مربحة مع الحق المتعال، قد لا
تستغرق سوى لحظاتٍ من حياته، وهي ساعة المجاهدة الدفعية المتحققة عند قوله ( إني
أخاف الله )..فمَثَل هذا العبد كمَثَل من ربح مالاً وفيراً في صفقة واحدة، لم يكلفه
سوى الإيجاب والقبول..فعلى العبد عند الابتلاء بهذه المواقف المحرجة، أن لا يفرّط
في هذه الأرباح العظيمة التي يبيعها أهل الهوى بشهوة عابرة، تذهب لذتها وتبقى
تبعتها..بل قد لا يتهيب البعض من تعرّضه لمثل هذه المواقف، ليثبت فيها استقامته
وثباته بفضل الحيّ القيّوم، فيحوز على ما لم يحزه بالمجاهدة المستمرة.
نقاط النور
ما من مؤمن إلا وهو يعيش ( لحظات ) بينه وبين ربه، يستشعر فيها حالة الإنابة بل
الأنس بذكره بما لا يقاس به الأنس بمن سواه، وهي ومضات النور التي تتخلل ظلمة
الحياة..فالمطلوب منه أن ( يوسّع ) من هذه النقطة البيضاء لتغطي أكبر مساحة من
حياته..فما العمر إلا مجموعة من نقاط النور والظلمة، فما دام العبد قادراً على (
التحكم ) في نقطة منها ليحوّلها إلى بقعةٍ من نور، فما المانع عقلاً من التحكّم في
النقاط الأخرى، ليضفي على حياته هالة من النور الثابت المستغرق ؟!..ومن المعلوم أن
هذا النور الذي يكتسبه في الحياة الدنيا، هو بنفسه يسعى بين يديه يوم العرض الأكبر.
فساد الظرف والمظروف
إن موجبات الفساد والإفساد تكون تارة في ( المظروف )، وأخرى يتعدى المظروف
ليفسد ( الظرف ) نفسه، وذلك في ما لو طالت فترة بقاء الفاسد في ذلك الظرف..وعليه
فإن بعض الذنوب التي يدوم عليها العبد - وإن كانت من الصغائر - قد تؤثر في فساد
القلب، كإفساد الثمرة الفاسدة للإناء الذي فيه، وحينئذ فلا يكون علاج الأمر بإزالة
الثمرة الفاسدة، بل بتغيير الإناء الذي تعدى إليه الفساد..ومن هذا المثال نعلم
ضرورة ( المسارعة ) في الإقلاع عن الخطايا، لئلا يفقد القلب سلامته فيؤول أمره إلى
الختم، وعنده يبقى فساد القلب بحاله وإن أقلع صاحبه عن المعصية.
مرد الإحساس بالغيرة
إن مردّ إحساس المرأة بالغيرة من تصرفات الزوج هو اعتقادها ( بالشرك ) التعاملي
الذي يمارسه الزوج مع زوجته، فهي تفترض أن حبه لها ينبغي أن لا تشاركه فيه
غيرها..فلو ( غالبت ) المرأة هذا الإحساس، وخرجت من دائرة انحصار توجهها لزوجها،
والاستغراق في جلب وده، ومن ثَمّ أسلمت أمرها لمن بيده مقاليد الأمور صغيرها
وكبيرها، لهانت عليها بعض الصعاب، واحتملت أذى الأزواج، لما ترى من أن ذلك كله بعين
الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء..إضافة إلى ذلك كله، ( الاعتقاد )
بأن الخير إنما هو بيد الذي لا رادّ لفضله، يصيب به من يشاء من عباده.
الكمال الطولي والعرضي
إن مما يلاحظ في بعض صور توفّـي الحق لعبده بالموت، هو أن العبد يصل إلى مرحلة
رتيبة من الطاعة إما أنساً بها أو اعتياداً لها، بحيث لو ترك بحاله لما عدل عما هو
فيه، ومن المعلوم أن ( استعداد ) العبد للطاعة - وإن استمرت به الدهور - لمن موجبات
الخلود بالجزاء التفضلي للحق الكريم..وعليه فلو توفّاه الحق بعد تلك الحالة الرتيبة
الثابتة، فإن انقطاع ذلك التفاعل ( العرضي ) لا يؤثر كثيراً في رصيده، وهذا بخلاف
ما لو اعتاد العبد القفزة في حياته، فإن هذا التكامل ( الطولي ) في الدرجات، قد
يوجب له منحة الحق في إطالة العمر، ليتسنى للعبد القفز إلى أعلى الرتب التي يمكن أن
يصل إليها، فيتوفاه الحق - لطفاً به - بعد ذلك وهو في أعلى سلم التكامل.
التأسي في تأثرهم
تنتاب الإنسان حالة من الألم الشديد عند فراق عزيز يصل إلى حد الذهول، فعلى
العبد في مثل هذه الحالة، تذكر مصائب أهل البيت (عليه السلام) في أعزتهم، وخاصة مع
ملاحظة ( قرب ) أعزتهم من الحق المتعال، إضافة إلى ( شدة ) محبة المعصوم لمن هو
عزيز لديه، إذ أن المحبة الحقة صفة ( كمالية )، لا بد وأن تكون متحققة في المعصوم
بأعلى درجاتها..ومن هنا كان التأسي بهم في ذلك التأثر بأعـزّتهم، من أعظم موجبات
رضاهم، وكسب الـحُظوة عندهم (عليه السلام).
آثار سرعة الاعتذار
إن سرعة ( قبول ) العذر عند الاعتذار، لمن سمات النفوس الكريمة، فإن المعتذر لا
يخلو من إحساس بالذل والمهانة عند الاعتذار، لا يحتملها أصحاب النفوس العالية، إذ
لا يمكنهم الوقوف موقف اللامبالاة من المعتذرين..أضف إلى ذلك، فإنها من موجبات (
استنـزال ) الرحمة الإلهية لقابل العذر عند اعتذاره هو - بدوره - للحق المتعال، ومن
المعلوم أن العبد لا ينفك من حاجته ( لصفح ) الحق في كل مراحل حياته، لعدم خلوه من
تقصيرٍ في حق العبودية: بدءً بالذنوب، وانتهاءً بالغفلة والإعراض بالقلب..وقد
أمِـرنا بالصفح الجميل الذي فسره الأمام الرضا (عليه السلام) بقوله: "عفواً من غير
عقوبة، ولا تعنيف، ولاعتب"البحار-ج78ص356..كما روي عن الإمام الكاظم (عليه السلام)
أنه قال: "إن أتاكم آتٍ فأسمعكم في الأذن اليمنى مكروهاً، ثم تحول إلى الأذن اليسرى
فاعتذر وقال لم أقل شيئاً، فأقبلوا عذره"البحار-ج71ص425.
التفاعل في الخلوة والجلوة
إن مَثَل من يُقبل على المولى في ( ملأ ) من الناس متأثراً بتفاعلهم مع ذكره
تعالى، ثم يعرض عنه في ( خلوته )، كمَثَل من قدم عليه ضيف كريم، وأكرمه عند زيارة
الناس له متأثراً باحترامهم لذلك الضيف، فإذا خلا به أهمله في ضيافته وتكريمه..فإن
دل ذلك على شيء، فإنما يدل على عدم معرفته بالضيف حق معرفته، وعدم تقديره بما يليق
بشأنه، مما يجعله محروماً من خالص نظرته عند الخلوة به..وكان الأجدر بالمضيف الذي
تشرف بزيارة مثل هذا الضيف له، أن ( يحرص ) على خلوته به أكثر من تكريمه في ملأ من
زوراه، فإن تكريم الضيف في الخلوة، أقرب إلى التقدير الخالص من التكريم في الجلوة،
لما يشوبه من شوائب التظاهر والمجاملة.
تجاوز الحاكمية
إن الدين عبارة عن مجموعة من القوانين التكليفية والوضعية في الأفعال والتروك،
وهي التي ( تحكم ) علاقة العباد بربهم، وبالمخلوقين من جهة أخرى، ومن هنا كانت هذه
القوانين من شؤون ( حاكمية ) الملك الحق المبين..ولـيُعلم أن أيّ تدخّل غير مأذون
به في هذا المجال، يُعـدّ تحدياً وتجاوزاً لتلك الحاكمية القاهرة..ومن هنا جاءت
النصوص المحذرة من: تفسير القرآن بالرأي، والبدعة، والقياس في الدين، والتصرف في
الحديث بالجعل والتحريف، واتباع ما ليس فيه علم..فعلى العبد أن يحذر الاعتقاد بأي
أمرٍ - ولو كان حقيراً - ما لم يقم عليه برهان من شرع أو عقل، لئلا ( يعتاد ) إتباع
الظن المنهيّ عنه، فيقع نتيجة لذلك في شباك الشيطان، لتبنّـيه العقائد الفاسدة التي
تغير مسيرة العباد وتفسد صالح البلاد، وقد ورد عن الإمام الرضا (عليه السلام) أنه
قال: "إن أدنى ما يُـخرج الرجل عن الإيمان، أن يقول للحصاة هذه نواة، ثم يدين بذلك
ويبرأ ممن خالفه"البحار-ج2ص115..فليست المشكلة الكبرى في القول المجرد الذي لا
يستتبع اعتقادا، بل المشكلة فيما ذكر من الديانة به والبراءة ممن خالفه.
عروج الدعاء
إن الدعاء إذا ( عرج ) إلى الحق المتعال، فلا يعقل - بعده - إهمال الكريم لحاجة
صاحبه، إذ أن ذلك لا يجتمع مع كرمه الذي لا يحيط العباد بكنهه، كباقي صفات جلاله
وكماله..ومن هنا تأكدت الحاجة في التأمل في موجبات ذلك العروج، وهي العمدة في تحقق
الإجابة، ولهذا يسأل الداعي ربه قائلاً: "اللهم فأذن لدعائي أن يعرج إليك، وأذن
لكلامي أن يلج إليك"البحار-ج87ص182..وقد أشارت الأدعية الكريمة إلى الذنوب التي (
تحبس ) الدعاء، ومن المعلوم أن حُكم الدعاء الذي لا يعرج إلى الحق،كحكم الدعاء الذي
لم يصدر من صاحبه، في عدم استلزامه الاستجابة.
خبط العشق
إن بعض الذنوب الخارجية يعبّـر عن انحراف ( جارحة ) من الجوارح، وإن كان منشؤها
حالة في النفس تدفع الجارحة لارتكاب تلك الخطيئة..إلا أن هناك بعض الخطايا تتفاعل
مع النفس ( مباشرة )، فتقلب عاليها سافلها، بما يفقدها الاعتدال والاستواء، فتدعو
صاحبها للتخبط في الحياة كتخبط من سلب عقله !!..ومثال ذلك العشق الشديد الذي قد لا
يتجلى من خلال معصية في جارحة، إلا أنه يوجب الاضطراب في ( التكوين ) النفسي
والعقلي بما يفوق أثر بعض الذنوب الخارجية..والدليل على ذلك هو عدم قدرة العبد
عندها على الالتفات إلى الحق، بل الإحساس بحالة من الصدود عنه، لشدة انشغال الفؤاد
بمادة العشق هذه، وهذا كله خلافاً لبعض الذنوب التي يعود العبد بعدها إلى ربه تائباً
منها بمجرد إقلاعه عنها..وقد ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما يصوّر حالة
الانقلاب النفسي للعاشق بقوله: "من عشق شيئاً أعشى بصره، وأمرض قلبه، فهو ينظر بعينٍ
غير صحيحة، ويسمع بأذنٍ غير سميعة، قد خرقت الشهوات عقله، وأماتت الدنيا قلبه"شرح
النهج ج7-ص200.
الآثار البعيدة للعمل
إن مما يُفاجأ به العبد عند المحاسبة يوم القيامة، هو إطلاعه على الآثار غير
المقصودة المترتبة على أفعاله الاختيارية، إذ أن الآثار ( البعيدة ) المترتبة على
الفعل وإن لم تكن ( اختيارية ) للعبد مباشرة، إلا أنها تنتسب إليه بانتساب ( أصل )
الفعل إليه، ولهذا ينتسب أجر من عمل بالسنّة الحسنة، و وزر من عمل بالسنّة السيئة،
إلى صاحب السنّة الحسنة أو السيئة، وإن لم يعمل هو بها..وعليه فمن الواجب على العبد
الحذر الأكيد من الآثار اللاحقة للسيئة، فضلاً عن السيئة نفسها، ولا شك في أن
توقّـع الآثار واحتمال وقوعها، يحتاج إلى بصيرة ونورٍ يمنحان لمن يحذر الآخرة ويرجو
رحمة ربه..والتأمل في الرواية التالية مما يُـذهل ذوي الألباب، ويدفعهم للمراقبة في
كل حركة وسكنةٍ، قولا كان أو فعلاً، وهي ما روي عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه
قال: "يحشر العبد يوم القيامة وما ندا دماً، فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك،
فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا رب لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دماً ؟..
فيقول: بلى، سمعت من فلان رواية كذا كذا، فرويتها عليه، فنقلت حتى صارت إلى فلان
الجبار فقتله عليها، وهذا سهمك من دمه"البحار-ج7ص202.
افتراض حلول الموت
يحسن بالعبد بين فترة وأخرى ( افتراض ) حلول الموت به على حين غفلة، ليرى مدى (
استعداده ) لمواجهة هذا المصير الذي لا يُستثنى منه أحدٌ من الخلق، وتتأكد هذه
الحاجة لمن بلغ من العمر مبلغاً، أو ألـمّت به عارضة يخشى معها الرحيل على
عجل..والمطلوب من العبد في مثل تلك المراجعة، هو تصفية حقوق الخلق، والإنابة إلى
الخالق، والتفكير فيما ينبغي له بعد الموت، من موجبات الأجر الجاري الذي لا ينقطع
بانقطاع الحياة..ومع الإخلال بما ذكر، فإن على العبد أن يوطّن نفسه على التصفية قبل
الموت في سكراته، وبعد الموت في برزخه، وهو ما يعبر عنه الإمام الهادي (عليه السلام)
بـ ( الحمّام )، وذلك عندما دخل على مريضٍ وهو يجزع فقال له: "إذا اتسخت وتقذّرت
وتأذيت من كثرة القذر والوسخ عليك، وأصابك قروح وجرب، وعلمت أن الغسل في الحمام
يزيل ذلك كله، أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟.. أوَ تكره أن تدخله فيبقى ذلك
عليك ؟.. فقال بلى يا ابن رسول الله، فقال(عليه السلام): هو ذلك الحمام، هو آخر ما
بقي من تمحيص ذنوبك، وتنقيتك من سيئاتك"البحار-ج6ص156..فالأولي بالعبد أن يدخل
الحمام بنفسه قبل الموت، لئلا يجبر على دخولهـا بما فيها من ذل وقسر وطول مكث.
القلب موضع النظر
إن النصوص الشريفة من القرآن وروايات العترة (عليه السلام)، أكدت على طهارة
القلب وتزكيته بما لا تدع مجالاً للشك في أنه لا صلاح ولا نجاة ولا كمال للعبد، من
دون ( المراقبة ) الدقيقة والمبرمجة للقلب الذي إن صلح صلحت ( الجوارح ) كلها..ومن
هذه النصوص التي تفتح آفاقا للسالكين إلى الحق، ما روي عن أمير المؤمنين (عليه
السلام) أنه قال: "قلوب العباد الطاهرة مواضع نظر الله، فمن طهر قلبه نظر إليه"غرر
الحكم..وما قيمة القلب الذي لم ينظر الحق إليه، وإن اشتغلت الجوارح ببعض الأعمال
القربـّية ؟!.
قيمة المعارف
إن على المؤمن أن يستذكر حقيقة أن ما وصل إلى الأجيال اللاحقة، من ( المعارف )
الحقّـة في العقائد والأحكام، المستمدة من منبع الوحي والعترة، إنما هي ( ثمرة )
تاريخ من المجاهدة بالأنفس والأموال، منذ بعثة النبي (ص) إلى ما بعد زمان الغيبة،
بما فيها من مآسي وآلام لم يرْوِ لنا التاريخ إلا نزراً يسيراً منها..ومن المعلوم
أن هذا الاستذكار يدعوه لمعرفة قيمة النعم التي هو فيها، وضرورة عدم التفريط بشيء
منها..فهذا بدء زمان الغيبة الصغرى - عند وفاة الإمام العسكري (عليه السلام) - يشهد
بداية إرهاصات زمان الغيبة، إذ روى التاريخ أنه: "جرى على مخلفي أبي الحسن العسكري
(عليه السلام) كل عظيمة من: اعتقال، وحبسٍ، وتهديدٍ، وتصغيرٍ، واستخفافٍ
وذل"البحار-ج50ص334..ومن المعلوم أن كل هذه المآسي بعد زمان الغيبة، شهدها ويشهدها
صاحب الأمر (عليه السلام)، مما يوجب على محبيه، مواساته في مصائبه، وأفضل (
المواساة ) هو الإتّـباع والعمل بما يقرّب من الظهور.
الجهل بدرجات الحجج
إن الجهل بعلوّ درجات حجج الله على الخلق من المعصومين (عليه السلام)، منشؤه
عدم ( استيعاب ) دورهم الذي رسمه الحق لهم في عالم الوجود، فمن اتخذه الحق خليفة في
الأرض، لا بد وأن يزوده ( بمستلزمات ) الخلافـة من جهتين، الأولى: عظمة ( الانتساب
)، إذ أنه خلافة للرب العظيم، وعظمة خلافة الرب العظيم، تستدعي عظمة من استخلفه بما
يليق بشأن خلافته، والثانية: عظمة ( التكليف )، إذ أنه واسطة لعناية الحق في كل ما
يتصل بشؤون المبدأ والمعاد، وبما يضمن سعادة الخلق في عوالم الدنيا والبرزخ
والقيامة..فهذا أبو هاشم من خواص الإمام العسكري (عليه السلام) يقول: جعلت أفكر في
نفسي عِظَم ما أعطى الله آل محمد (ص) وبكيت، فنظر إليّ الإمام وقال: "الأمر أعظم
مما حدثت به نفسك من عظم شأن آل محمد (ص)، فاحمد الله أن جعلك متمسكاً بحبلهم، يوم
تدعى يوم القيامة بهم إذا دعي كل أناس بإمامهم، إنك على خير"البحار-ج50ص259.
تمنيات الغافلين
قد يتمنى الغافل عن الحق ملذات المستغرقين في الشهوات، كما تمنى الغافلون من
قبل ما أوتي قارون من متاع، إذ قالوا: "يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ
عظيم"..والمطلوب في هذه الحالة الالتفات إلى حقائق تزهّده في تلك الأماني الباطلة:
فمنها الاعتقاد ( بفناء ) الملذات ودفعيّـتها حتى في الحياة الدنيا، ولهذا يستوحش
أصحابها بمجرد الفراغ منها، بل يصيبهم شعور بالملل والفتور كما هو واضح في شهوة
البطن والفرج..ومنها أن إقبال أهلها عليها إنما هو ( فرار ) في حالات كثيرة، لما هم
فيه من الضيق والضنك في العيش، ولهذا يلتجأون إلى ما ينسي واقعهم كالمسكرات وما
يشبه ذلك من مزيلات اليقظة والانتباه، فيرتمون في أحضان تلك الموبقات، لعدم وجود
بديل لهم يشفي الغليل، والحال أن المؤمن لا يرى في حياته ما يوجب الهروب منه، ليلجأ
إلى الاستمتاع المجرد من الهدف، فهو متزود من الدنيا لا مستمتع بها..أضف إلى ذلك
كله، وجود تبعات اللذائذ التي تلحق أهل المعاصي في الدنيا والآخرة، خلافاً لأولياء
الحق الذين جمعوا بين سعادة الدارين، كما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه
قال: "المال والبنون حرث الدنيا، والعمل الصالح حرث الآخرة، وقد يجمعهما الله
لأقوام"البحار-70ص225.
التشبّه بالكفار
إن من أعظم الذنوب هو الكفر والشرك، وما ( يرتبط ) بهما من إنكار الضروري
والتبرم من قضائه وقدره، ولكن العبد قد لا ( يعتقد ) شيئاً من تلك المعاني، ولا
يُظهرها على لسانه، ولكنه يتصرف - في مقام العمل - كمن يعتقد بتلك الأمور الموبقة،
فهو وإن لم يكن كافراً بمجرد ذلك، إلا أنه ( متشبّه ) بهم وما أسوأه من تشبّـه..وقد
ورد عن النبي (ص) أنه قال: "يأتي على الناس زمان يشْكُون فيه ربهم، قلت وكيف يشكُون
فيه ربهم ؟..قال يقول الرجل: والله ما ربحت شيئاً منذ كذا وكذا، ولا آكل ولا أشرب
إلا من رأس مالي، ويحك!..وهل أصل مالك وذروته إلا من ربك ؟!"الوسائل-ج17ص462.
الاسترسال بالأنس
إن مما يلاحظ في التعامل الاجتماعي، أن العبد ( يسترسل ) في معاملة الخلق،
فيأنس بهم بدواعٍ ( شخصية ): دفعاً للهم، أو طلباً للمنفعة، أو تأثراً بحبه
لهم..ومن المعلوم أن ذلك كله مما لا يمكن إسناده إلى دواعي القربة إلى الحق المتعال،
إذ لو كان الإنس بهم لوجه الحق، لـما كان ينبغي الاسترسال المذهل عنه، والذي (
يتجلى ) من خلال: الـهذر في القول، والمزاح الممقوت، وإطالة الجلوس بما لا نفع فيه،
والتورّط في معصية اللسان، والانشغال بهم عن أداء الحقوق الواجبة للأهل والعيال.
عقوبة العشق
إن من أشد العقوبات التي يعاقب بها العبد وخاصة في المخالفات القلبية، كالتعلق
بغيره تعالى، والغفلة عنه، والمحبة المستغرقة لغير من أمِـر بـحبّهم: هو ( إعراض )
الحق عن ذلك القلب، و( إيكال ) أمر ذلك القلب إلى صاحبه ليملأه بما فيه هلاكه..وقد
ورد في الأثر، أن الله تعالى لم يضرب عبداً بعقوبة أشد من قساوة القلب، وقد سُئل
الصادق (عليه السلام) عن العشق فقال: "قلوب خلت عن ذكر الله، فأذاقها الله حبّ
غيره"البحار-ج73ص158..ومن الملفت في هذا الخبر التعبير بـ ( أذاقها )، ومن ذلك يعلم
إن بعض الأمور التي فيها إضرار بالعبد، ينسبها الحق إلى نفسه، مشعراً بالخذلان لذلك
العبد المتمرد على إرادة الحق، كقوله تعالى: "ليذيق بعضكم بأس بعض"و"ولولا دفع الله
الناس بعضهم ببعض"و"إنّـا أنزلنا الشياطين على الكافرين"و{نقيّض له شيطاناً فهو له
قرين"..وفي ذلك منتهى الإذلال، لشدة الاستحقاق التي جعلت الرب الرؤوف يُسند الإضرار
إلى نفسه.
التوقيت في الأرض والحياة
إن من الأمور التي تعين العبد على تجاوز العقبات، هو الالتفات الواعي والتفصيلي
لصفة ( التوقيت ) للحياة على الأرض وما عليها، كالتفاته إلى التوقيت للأرض نفسها،
بل لما حولها من شموس وكواكب، وكيف أن العيش فيها بكل صخبها وحطامها، كأنه اللّبث
في ساعة من نهار، بما فيها من سرعة الانقضاء !!..إن هذا الإحساس الذي يرفده اليقين
بصفة التوقيت - مع ما يقارنها من الاعتبار بالصور المادية المؤيدة لذلك كالأموات
والقبور - يجعله ( يتعالى ) بشكلٍ غير متكلَّف عن الشهوات من جهة، و( يتحمل )
الابتلاءات من جهة أخرى، لعلمه أن ذلك كله زائلٌ كزوال أصل الحياة..ومن هنا كان
القرآن الكريم هدىً لمن آمن بالغيب، وتيقّن بالآخرة، ومن المعلوم أن الإيمان
واليقين، كلاهما يصبّـان في تعميق هذا المفهوم، الذي من شأنه تغيير مسيرة العبد
رأساً على عقب.
النتائج بيد الحق المتعال
لا شك في أن الله تعالى خلق الإنسان حراً في إرادته، ولهذا حَسُن تكليفه كما
حَسُن عقابه..إلا أن للحق تعالى فاعليته المباشرة في عالم النتائج والآثار..فليعمل
العبد ما يريد باختياره، ولكنه لا يبلغ مُناه في كل ما يريد، كالزارع الذي له
اختيار الزراعة ( كفعل ) لا الزرع ( كحاصل )، إذ أنه منوط بأسبابه من الرياح
والامطار التي لا دخل للزارع فيها..ومن المعلوم أن نسبة الآمال المتحققة في الخارج،
هي أقل بكثير من نسبة الآمال المنعقدة في القلوب..ومن موجبات هذه الخيبة، طلب
الـمُنى بمعصية الحق المتعال، فلا يُـحرم العبد ما يريد فحسب، بل قد يُـبتلى بعكس
ما يريد..وقد ورد عن الأمام الحسين (عليه السلام) أنه قال: "من حاول أمراً بمعصية
الله، كان أفوت لما يرجو، وأسرع لما يحذر"البحار-ج78ص119.
ما لا يورث اليقين
إن من مصاديق إتباع الظن واقتفاء ما ليس فيه علم، هو التأثر بما لا يورث اليقين:
( كالأحلام ) المقلقة، و( احتمال ) ما قد يتوهمه العبد من السحر والكهانة، و(
تأثـير ) الأرواح الشريرة، وغير ذلك مما يُبتلى به أصحاب الوهم الذين لم يستضيئوا
بنور العلم، ولم يركنوا إلى ركنٍ وثيق..فعلى العبد أن يقيس الأمور بما يورث له
العلم واليقين، مستلهماً ذلك من الشرع وأهله..وإلا فإن البلاء الذي يورده العبد على
نفسه - بسوء اختياره - قد لا يؤجر عليه، فتفوته بذلك راحة الدارين.
أولم يكف بربك
إن العبد لو استحضر - بكل وجوده - مضمون هذه الآية في حياته لانقلبت نظرته إلى
الحياة وما فيها، واستشعر تلك الهيمنة العظمى والرقابة الدقيقة لعالم الغيب على كل
حركاته وسكناته، بما يمنعه من الذهول عن الحق المتعال، فضلاً عن مخالفته وهي قوله
تعالى: "أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد".. فكم فيها من العتاب البليغ، وذلك
بالتعبير بـ ( أولم يكف )، بمعنى أنه لو لم نستحضر إلا هذه الصفة في الرب الخبير،
لكفى بذلك ردعاً للعباد..وعليه فلو اعتقد العبد بإحاطة المولى عزّ ذكره بكل عناصر
الوجود، لأورثه هذا الاعتقاد إحساساً بالرهبة والمراقبة المتصلة، إضافةً إلى
الإحساس بالسكينة والاطمئنان، لعلمه بأن كل ما يجري في حقه وحق عالم الوجود، إنما
هو بعلمه ورأفته.
اللامحدود مقابل المحدود
لو عدّ العبد لحظات عمره المعدودة، وقارنها باللحظات اللانهائية من حياة البرزخ
والقيامة، ثم المصير إلى الجنة أو النار، لرأي ما يذهله أيما ذهول..إذ أن كل ( لحظة
) من لحظات حياته، تساويها قطعة ( لا متناهية ) من الزمان، ضرورة أن تقسيم
اللامحدود على المحدود ينتج اللامحدود..ومقتضى هذا البرهان القاطع، أن الخير والشر
في كل لحظة من العمر المحدود، له أثره اللامحدود سعادة أو شقاءً..فإذا استوعب العبد
هذه الحقيقة المذهلة لجعله يتحرز من هدر أية لحظة من لحظات عمره، بل لاشتدت حسرته
إلى حد الحزن المفرط، عندما يتذكر اللحظات التي ( أضاعها ) من عمره ولو فيما لا نفع
فيه، فضلاً عن هدرها فيما لا يحسن عقباه، من المعاصي والذنوب العظام.
الحسرة على السلف
يتحسر بعضهم عند الإطلاع على سيرة السلف من العلماء والصالحين، لعدم إدراك
زمانهم والعيش معهم، ليقتبسوا الكثير مما كانوا فيه..والحال أنهم لا يعيشون الحسرة
نفسها تجاه من بيده أزمّـة الأمور في زمان الغيبة، مع أنه بيمنه رزق الورى، وبوجوده
ثبتت الأرض والسماء..فهو (عليه السلام) إمام الصالحين في العصور المتمادية، وما
اكتسب الصالحون درجة الصلاح إلا بمباركته ودعوته ورعايته، كما هو مقتضى تنـزّل
الأمر عليه في ليلة القدر وغيرها..ولا شك أن ( الاحتجاب ) الظاهري لا يمنع مثل هذه
( الرعاية )، إذ أنه كرعاية الشمس لنبات الأرض ولو من وراء السحاب..ومن المعلوم أن
الأئمة (عليه السلام) في زمان الظهور أيضاً كانت لهم هذه الرعاية والتسديد لمواليهم
حتى مع تباعد الأمكنة، إذ لم تُـقدّر لبعضهم رؤية إمام زمانه أبداً..فليكن المانع
في مقتضى الزمان كما نحن فيه، كالمانع في مقتضى المكان كما كانوا هم فيه.
ارتفاع الهوية الشخصية
يبلغ المؤمن من البلوغ والسمو الروحي، إلى مرحلة ترتفع عنده الحواجز، حتى حاجز
( هويته ) الشخصية في تعامله مع الخلق..بمعنى أنه يرى الجماعة المؤمنة كالوجود
الواحد، فحاجة أخيه كحاجته، إذ لا يرى - في عالم الواقع لا التلقين - أولويةً
لحوائج نفسه قياساً إلى حوائج غيره، فإن نسبة العباد إلى الحق نسبة واحدة من جهة
الخلق..ومن المعلوم أن هويته الشخصية من لوازم ( إنيّـته ) التي لا بد وأن يذيبها
في مشيئة الحق وإرادته، وعندئذٍ يتحول الإيثار عنده إلى حالة طبيعية غير منافرة
لمزاجه، فلا يرى معها عُجباً في نفسه، ولا منّـة على عباده..وهذه الحالة بحق من
أعظم ( كواشف ) البلوغ النفسي، الذي قلّـما وصل إليه الواصلون.
علامة القبول
يتوقع العبد علامة الاستجابة والقبول بعد فراغه من موسم الطاعة، كشهر رمضان،
وكالحج، وكزيارة وليٍ من أولياء الحق، وعندئذٍ قد يعوّل على ( منامٍ ) غير مورث
لليقين، أو ( كلام ) عبدٍ مثله لا يغني من الحق شيئاً..والحال أن من أهم علامات
القبول هو: إحساس العبد بتغيّـر في ذاته، يستتبع صدور الأعمال الموافقة لرضا الحق
من دون كثيرِ تكلّف..والمهم في هذه العلامة هي ( استمرارية ) ذلك التغيير، وإلا فإن
الزمان اللاحق لتلك المواسم، لا يخلو من شيء من ألوان الطاعة واجتناب المعصية، وهذا
مما لا يعوّل عليه البصير..فمَثَله كَمَثل من خرج من بستان حاملا شيئاً من روائح
زهورها، سرعان ما تتلاشى بالابتعاد عن ذلك البستان.
الشيطان القرين
إن من التهديدات الكبرى للغافلين عن الحق، المشتغلين بالمحسوسات، والمنهمكين في
الشهوات، هو ما ورد في قوله تعالى: "ومن يعشُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له
قرين"..فما حال الإنسان الذي اقترن به شيطانٌ يغويه، غير الشيطان الأكبر الذي يُشرف
على الإنسان وعلى قرينه ؟!..ومن المعلوم أن هذا الشيطان القرين، يصاحب المرء في كل
( تقلّباته )، فيكون خبيراً بواقع العبد أكثر من نفسه، فيعلم بذلك نقاط ضعفه
وقوته..ومن هنا تكمن ( خطورته ) إذ يسوق العبد إلى الهاوية، مستعيناً بنقاط ضعفه،
بعد أن أبعده عن جادة الهدى، مُعرضاً به عن نقاط قوته.
صلاة الليل والجماعة
لقد ورد من الحث على قيام الليل وصلاة الجماعة بما قلّ مثلهما في
المستحبات..ففي صلاة الجماعة إنماء للجانب ( الاجتماعي ) للعبد، إضافة إلى ما تحمله
الصلاة من معان ودقائق، تتجلى في قلوب المقبلين عليها..وفي صلاة الليل تنمية للجانب
( الفردي )، وإخراج للعبد في كل ليلة من عالم ( الفرش ) في النهار بما فيها من لغو
وتشاغل عن الحق، إلى عالم ( العرش ) بما فيها من الخلوة التي لا يعرفها غير أهلها،
إضافة إلى التفكير المعمّق بموقع الإنسان في عالم الوجود الذي لم يُـخلق
باطلا..وكان عليٌّ (عليه السلام) يقول: "نبـّه في التفكير قلبك، وجاف عن الليل جنبك،
واتق الله ربك"تفسير الصافي -ج1ص377.
الحب الخالص
إن من أشق المراحل لطالبي لقاء الحق المتعال، هو الوصول إلى مرحلة الحب (
الخالص ) له..فإن السائر في أول الطريق يلقّن نفسه الحب ( تلقيناً )، ويتصوره في
نفسه تصوراً، ثم يتعالى بعده (ليستشعره ) واقعاً في نفسه، مبتغياً بذلك القرب من
ذلك المحبوب، فيستمتع بلوازم ذلك القرب من الطمأنينة في الدنيا، والأنس في
الآخرة..و لكن العبد يترقى إلى مرحلة لا يكون حبه للحق مقدمة لحيازة مزايا القرب،
واستجلاب عطاء المحبوب إلى نفسه، بل لأجل أنه لا يرى محلاً في قلبه لغير ذكر
المحبوب وحبّـه..فإن القلب شأنه شأن باقي عناصر هذا الوجود مخلوق للحق المتعال، ومن
أولى - بهذا الظرف - من خالقه ليحل حبّه وذكره فيه ؟!..فلغة المحب الواصل هي لغة (
استحقاق ) الحق للحب المنحصر من العبد، لا لغة استحقاق العبد للمزايا المنحصرة في
حب الحق.
أدب المثول
إن من الواضح تقلّب العبد بعين المولى الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في
السماء، إلا أن إحساس العبد بهذه الرقابة المتصلة من الحق المتعال، ( تتأكد ) في
حال الصلاة، فيكون الإلتهاء عن ذكر الحق بالسفاسف من الأمور، أبلغ في عدم الاعتناء
بتلك المراقبة، وفي جَعْـل الحق أهون الناظرين إليه..فمَثَل المصلي كمَثَل من هو في
ملأ بين يدي السلطان يرعاهم بنظرته، فإذا طلب منه السلطان الوقوف بين يديه لمخاطبته،
وجب عليه أن يراعي أدب المثول ( للخطاب )، زائداً على أدب المثول ( المجرد ) بين
يديه.
أعاصير الشهوات
إن مَثَل الشهوات التي تتوارد على العبد بقوة،كمَثَل الأعاصير التي تجتاح
البلاد بين فترة وأخرى..فإن العلم بأن الإعصار لا دوام له، يمنح ( القوة ) والعزم
للثبات أمام الإعصار، ريثما يعود الأمر إلى سابق طبيعته..فالشاب المراهق الذي يعيش
فوران شهوته، عليه أن يعلم بأن هذه مرحلة إعصار تجتاح العباد في تلك المرحلة لترتفع
بعدها، سواء ( ثبت ) صاحبها معهـا أو ( استسلم ) أمامهـا..فالمهم في السائر أن يعلم
فترات الأعاصير، ويستعد للصمود أمامها قبل هبوبها، إضافة إلى علمه بأنها حالة زائلة
في كل الأحوال.
ضيوف الحق
إن العباد ينتسبون إلى الحق بنسبة الضيافة، وذلك فيما لو كانوا حول بيته الحرام
أو في مشاهد أوليائه..فمن هنا لزم على العبد أن يلحظ تلك الإضافة ( التشريفية ) في
تعامله مع هؤلاء الأضياف، فلا يلحظ علمه بسوء سابقتهم، بل ولا بسوء لاحقتهم، ما
داموا جميعاً في ضيافة الملك الكريم..ومن المعلوم أن ( احتقار ) من بحضرة الحق -
أياً كانوا - مما يوجب حلول الغضب، لما فيه من الاستخفاف بعظيم سلطانه، المستلزم
لعظيم عقابه.
مناهج المعرفة
إن الأدعية المأثورة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ليست ( وسيلة ) للحديث
مع الرب المتعال فحسب، بل هي ( مناهجٌ ) لمعرفة السبيل إلى لقاء الحق أيضاً..ففيها
إشارة إلى: موجبات الغفلة، وإلى دواعي القرب، وإلى المقامات التي يمكن أن يصل إليها
العبد، وإلى جزئيات عناية الحق بخواص أوليائه..ومن ( مظانّ ) هذه المضامين العالية:
دعاء كميل، ودعاء أبي حمزة الثمالي، ودعاء مكارم الأخلاق، والمناجاة الشعبانية،
ودعاء الصباح، والمناجاة الخمس عشرة.
المجنون عند الخاصة
ما المجنون عند الناس إلا الذي تصدر منه الأفعال التي لا يتعارف صدورها من عامة
الخلق، فلو كان ما يصدر من ( عامة ) الخلق، لا يتعارف أيضا صدورها من ( الخواص ) من
أولياء الحق، لعدّ ذلك بنظرهم ضربٌ من الجنون أيضاً، لأنه خروج عن المألوف عندهم،
بل خروج عن مقتضى الاستواء في السلوك الطبيعي لمن يعيش العبودية تجاه الحق
المتعال..فليست حسنات الأبرار سيئات عند المقربين فحسب، بل أن مستوى ( الإدراك )
عند الأبرار يُـعدّ ناقصاً عند المقربين، لاختلاف درجات العقل الذي لا يُكمله
الرحمن إلا فيمن يحب، وباختلاف درجات حب الرحمن لهم، تختلف أيضاً درجات العقل
الممنوحة لهـم.
الرصيد الكاذب
ما أخطر العلم على العالم الذي لا عمل له، إذ أن ذلك مدعاة ( للغرور )
والارتياح الكاذب إلى وجود رصيد عنده، والحال أنه لم يملأ إلا جانباً ضئيلاً من
عالم ( ذهنه )، والذي يعد بدوره جزءاً محدوداً من وجوده، الجامع لأبعاد أخرى ومنها
عالم الذهن..أضف إلى أن نقش المعلومة في الذهن، بمثابة نقش الكتابة في الحجر،
والكتابة على الورق، في أنه لا يعد - في حد نفسه - كمالا يُـعوّل عليه ( بمجرده )
في مسيرة الكمال، ولهذا اجتمع العلم وهو أداة الإنارة، مع الضلال وهو واقع الظلمة،
كما في قوله تعالى: "وأضله الله على علمٍ".
جينة الوحدانية
إن الإنسان بفطرته يميل إلى مبدأ وجوده، فهذا هو الطفل لا يجد إحساساً غريباً
عندما يُذّكر بالحق، بل أنه يدعي ببراءة أنه يحبه ويودّه، وهو صادقٌ إجمالاً في
دعواه..ونفس الإحساس ينتاب الكبار عند الشدائد، فينقلب إلى موحدٍ مخلص لله دينَـه (كما
يعبر القرآن الكريم )..ولو بقي على مثل ذلك الإخلاص، لفتحت له الآفاق التي لم يكن
ليحلم بها من قبل..وقد أعلن العلماء عن اكتشاف جينة في الجسم أطقلوا عليها ( جينة
الوحدانية ) مهمتها الرئيسية هي أن تقود الإنسان بالفطرة إلى إدراك أن هناك إلهـاً
واحداً لهذا الكون، خلقه بحكمة وتدبير، وأنه تعالى لا شريك له، ولاحظوا أن تنشيط
هذه الجينة يدفع الإنسان إلى الخشوع، عندما يسمع أحاديثَ تتحدث عن الحق تعالى،
وقالوا أنها موجودة لدى كل مخلوق حيّ بمقتضى قوله تعالى: "وإن من شيء إلا يسبح
بحمده"..وهنا يمكن أن نضيف القول بإمكانية الارتباط بين هذه المقولة، وبين آية أخذ
الميثاق من بني آدم، إذ أخذ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على الربوبية.
إيقاظ المحبة
إن من موجبات الانتقال عن المعصية هو ( الاعتقاد ) بشدة عذاب الحق في الآخرة
وأليم انتقامه في الدنيا، فإنه غير غافل عما يعمل الظالمون..ولكن هناك سبيلاً آخر
قد يكون أنفع من سابقه، وهو ( إحساسه ) بمحبته للحق الذي يهبه حالة من الالتفات
واليقظة، فيرى نفسه وكأنه كان نائماً على مزبلة واستيقظ على نتنه، وهو يواجه - على
مساقة قريبة منه - الجنات والرياحين، فمن الطبيعي أن يبادر من تلقاء نفسه في
الانتقال من المزابل إلى الروضات..وليعلم أن استيعاب هذا المعنى، كفيل بتغيير مسار
كثير من العصاة، يعبر عنها الإمام (عليه السلام) في المناجاة الشعبانية بقوله: "إلهي
لم يكن لي حول فأنتقل عـن معصيتك، إلا في وقت أيقظتني لمحبتك"..فيقظة المحبة أبلغ
في الوصول إلى الحق، من رهبة العقاب.
اجعلوني من همّكم
إن من أبدع ما ورد في زيارات المعصومين (عليه السلام)، هو ما ذكر عند وداعهم،
وهي لحظة فراق بما فيها من استثارة للعواطف التي تستلزمها طبيعة المفارقة، فيقول
الزائر مخاطباً وليّـه: "اجعلوني من همّكم، وصيّـروني من حزبكم"..فلو استجيب هذا
الدعاء في حق هذا العبد - وهو في مظانّ الاستجابة - وصار من ( هـمّ ) المعصوم، بما
يستلزمه الهـمّ من الذكر والمتابعة والرعاية، فكيف تكون حالة الزائر بعد تلك
الزيارة ؟!..أولا يُرجى بعدها تحقيق ( منعطفٍ ) في الحياة، كانت بدايته الدخول في
حرم المعصوم، وخاتـمته الدخول في حزبه وكونه من همّـه.
الوصية بالثلث
إن من الملفت حقاً عدم استغلال العبد لما أعطاه الحق المتعال من حق الوصية (بالثلث
) في الأموال، والحال أنه أحوج ما يكون للدرهم بعد وفاته، رداً لمظلمة أو كسباً
لدرجة..ولو أذن للميت أن يتصرف في كل ما لديه في عالم الوجود - تصرفاً بأمواله،
وفداء بأولاده وذويه - لفعل ذلك، كما ورد مضمونه في قوله تعالى: "يود المجرم لو
يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعاً
ثم ينجيه"..فكم تعظُم حسرته عندما يرى أنه كان ( مأذوناً ) بذلك، ولكنه ( آثـر ) من
هو مستغنٍ من الأحياء على نفسه، وهو مفتقر أشد الافتقار إلى ما كان داخلاً في ملكه،
بعد أن أفنى عمره في جمعه ؟!..والقرآن الكريم يذكر هذه الحالة بتعبير بليغ: "ولقد
تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم".
المخزون الشعوري
قد يتحسر بعضهم على حرمانهم من عطاء شعراء أهل البيت (عليهم السلام) - وخاصة
الأوائل منهم - الذين أحسنوا صرف قريحتهم في سبيل ( الذب ) عن أولياء الحق..ومن
المعلوم أنه لا قيمة لهذه الكلمات مجردة عن دوافعها، والدليل على ذلك عدم قبولها لو
كانت تزلفاً أو نفاقاً، وإنما القيمة الكبرى ( لمخزونهم ) الشعوري الذي يتفجر من
خلال تلك الكلمات الخالدة..وعليه فمن يملك ذلك المخزون بعينه، ولم يستطع التعبير
عنها بنثر أو شعر، لكلل لسان أو قلة بيان، فإنه معدود من تلك الزمرة بعينها، لوجود
المعنون وإن لم يتحقق العنوان، ولوجود البركان في الأعماق وإن لم يتفجر بحسب
العيان..فما ورد في مدح أولئك الشعراء على لسان أهل البيت (عليه السلام)، باعتبار
عواطفهم الظاهرة على اللسان، ( ينطبق ) بدرجة من الدرجات على من يحمل تلك العواطف
الكامنة التي لم يَـقدر على إظهارها.
تجلي النعمة
إن نعمة التوحيد والولاية يتجلى أثرهما - بأوسع مداه - في وقت ( أحوج ) ما يكون
العبد فيه لبركات تلك النعمة، وهو بدايات الانتقال من هذه النشأة الدنيا إلى النشأة
الأخرى، بكل ما فيها من وحشة واضطراب..فيقول العبد مناجياً لربه: "اللهم إني ذخرت
توحيدي إياك، ومعرفتي بك، وإخلاصي لك، وإقراري بربوبيتك، وذخرت ولاية من أنعمت عليّ
بمعرفتهم من بريتك محمد وعترته (عليه السلام)، ليوم فزعي إليك عاجلاً
وآجلاً"..وبذلك تهدأ النفوس التي لم تستمتع بالآثار العاجلة لهذه النعمة، عندما
تعيش شيئاً من الحرمان في هذه الدنيا، بمقتضى زمان الغيبة وما فيه من شدة
وفتنة..ومن أعظم ( الفتن ) غيبة المعصوم الذي بظهوره تزاح الشبهة، وتنجلي الكربة.
تسبيح من في الوجود
إن من موجبات ( الإقلاع ) عن المعصية، هو إحساس العبد بأن كل ما حوله يسبح
بحمدالله تعالى: إما بلسان حاله، أو بلسان مقاله..فإنه عندما يعصي الحق على فراشه
بعيداً عن أعين الناظرين، فإنما هو يتمرد في وسط ( يضجّ ) بالتسبيح، بأرضه وسقفه
وجداره وما فيه من أثاث ومتاع، وقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: "أما
يستحي أحدكم أن يغني على دابته، وهي تسبح" البحار-ج76ص291..فما هي نظرة الملائكة
الموكلة بالحساب وهم يرون هذا الموجود ( الشاذ ) في عالم الوجود ؟!..والأنكى من ذلك
كله أنه يرتكب الجريمة بما هو مسبحٌ للحق، كالقاتل بسلاح يسبح الحق كباقي موجودات
هذا الكون الفسيح، وكالظالم بعصا تسبّح بحمد الحق، يضرب به عبداً يسبح بحمد الحق
أيضاً.
العتق من النار
إن التعبير بالعتق من النار لهو تعبير بليغ، يشعر ( بفداحة ) الخطب الذي يعيشه
العبد وإن لم يستحضر تفاصيل ذلك الخطب الفادح..فإنّ طَلَب العتق يُشعر الإنسان
وكأنه عبد مملوك للجحيم، بمقتضى العقود اللازمة التي أوجبت له هذه الرقية..فكل
معصية بمثابة عقد ( عبودية ) بينه وبين النار، وكلما كثرت العقود كلما ترسخّت
معاملة العبودية، إذ يبيع نفسه للنار كل يوم مرات ومرات مؤكداّ بذلك إصراره على
المبايعة القاتلة..ولا حلّ لهذه المعاملة الملزمة، إلا ( بتدخّـل ) الملك القهار
الذي بيده أزمّـة الأمور فسخاً وابراماً، كالسلطان الذي يفسخ العقود اللازمة بمقتضى
سلطنته المطلقة.
المعصية لا بالمكابرة
يحسن بالعبد أن يكرر الاعتذار بين يدي الحق، وذلك بدعوى أن معصيته للجبار لم
تكن على وجه المكابرة و( الاستخفاف ) بحق الربوبية، وإنما كانت محضَ إتباعٍ لهوى،
أوغلبةٍ لشقوة، وخاصة مع تحقق الستر المرخى، من طرف الستار الغفور..إن هذا الإحساس
يسلب من المعصية جهة ( التحدي ) والاستخفاف، والهلاك الدائم إنما يأتي من هذه
الموبقة..فتبقى جهة المخالفة الاعتيادية لغلبة الهوى، فيتوجه العبد بعدها لمن لا
تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه..وبذلك يتحقق مضمون ( خادعت الكريم
فانخدع )، أي تظاهر بأنه لم يلتفت إلى تحايل العبد، ليكون هذا التغافل مقدمة للعفو
عنه.
تحمّل مظالم العباد
إن من أهم الموانع التي قد تحجب العبد عن دخول الجنة الأحقاب والدهور، هو (
تحمّـله ) لمظالم العباد..فإن المظلومين أحوج ما يكونون إلى حسنات الظالمين يوم
القيامة، فإذا تقاسم المظلومون حسناته، فلا يبقى له ما يدخل به جنة الخلد وهو على
أبوابها..ومن هنا يطلب العبد من ربه - وهو في الدنيا - بإرضاء الخلق بما يشاء، سواء
( بتوفيقه ) للالتفات إلى مظالم العباد وإقداره على أدائها أثناء حياته، أو ( بتدخل
) الحق مباشرة يوم الحساب لإرضاء الخصوم، بما لا يُنقص العبد شيئاً من حسناته.
لازم المحبة العميقة
إن من لوازم المحبة العميقة هو الإحسان للغير إكراماً للمحبوب، كما لو ( طلب )
منه المحبوب ذلك، أو ( أقسم ) الغير بذلك المحبوب ليستجلب عطاءه، إذ لأجل عين ألف
عين تكرم، وهذا مما تعارف عليه الخلق، فيقسمون بالمحبوب استثارة لمحبة المحب..وهذا
الأسلوب مألوف أيضا في التعامل مع الحق وأوليائه، فيكثر في أدعيتهم وزياراتهم القسم
والمناشدة بأحب الخلق إليهم..ومن المعلوم أن القَسَم المؤثر هو ما كان عن ( معرفة )
بدرجاتهم، إضافة إلى الصدق والالتفات الجاد في مخاطبتهم.
الحوائج الجامعة
إن من الملفت في بعض أدعية أهل البيت عليهم السلام، طلب الحوائج ( الجامعة ) من
الحق والتي لو استجيبت في حق داعيها لحاز على ما لم يخطر على الأذهان..ومثال ذلك ما
أملاه الإمام الصادق (عليه السلام) بقوله: "وأعطني من جميع خير الدنيا والآخرة، ما
علمت منه وما لم أعلم، وأجِـرْني من السوء كله بحذافيره، ما علمت منه وما لم
أعلم"..وكمناجاة شهر رجب إذ يقول (عليه السلام): "أعطني بمسألتي إياك جميع خير
الدنيا وجميع خير الآخرة، وأصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة"..ولا
غرابة في مثل هذا الطلب الجامع، ما دام المسؤول هو أكرم الكرماء، ومن لا يعجزه شيء
في الأرض ولا في السماء..ومن المعلوم أنه لا فرق في عطائه بين القليل والكثير، ما
دام ذلك كله ( بأمره ) الذي لا يتخلف عن مراده شيء.
* الشيخ حبيب الكاظمي
2016-01-22