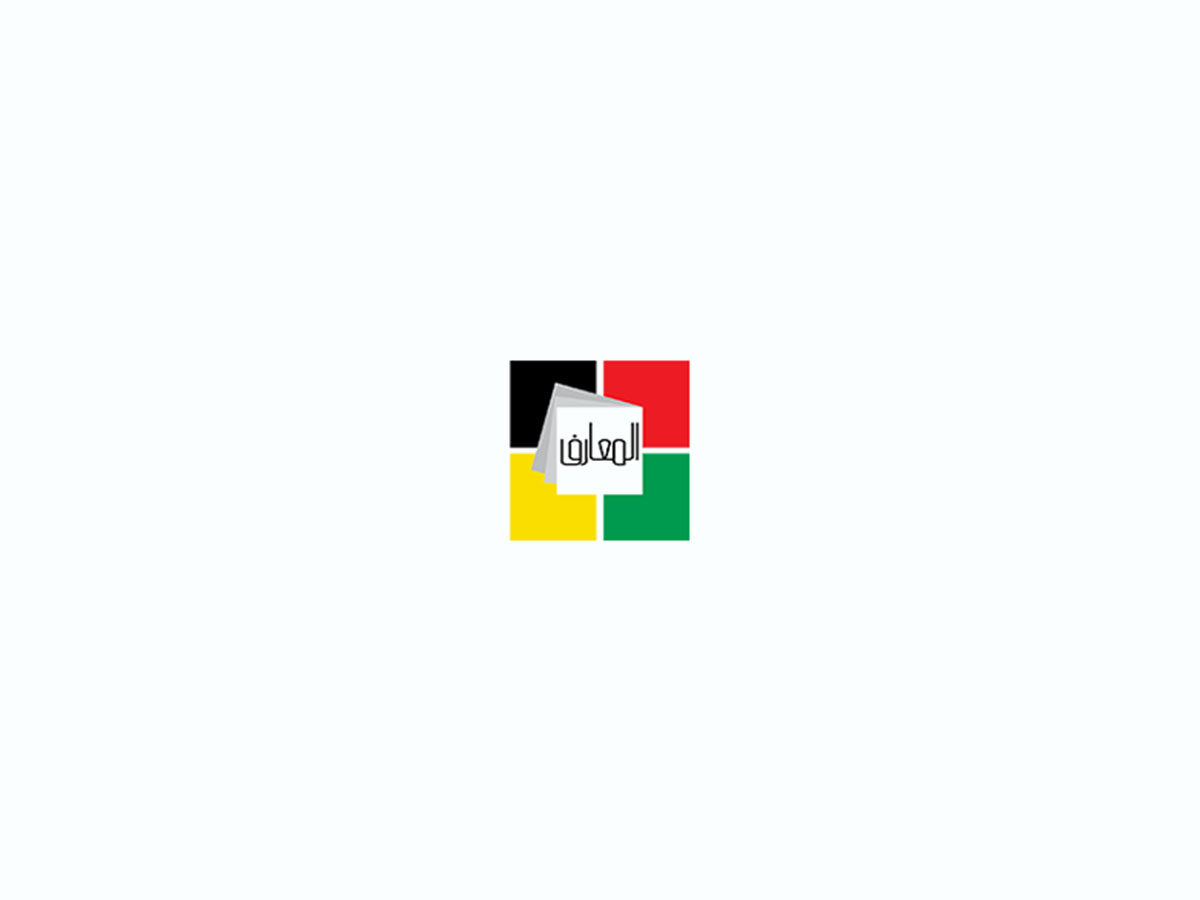مقام الدعوة إلى الله
إن الدعوة إلى الله تعالى منصب مرتبط بشأن من شؤون الحق المتعال، ولهذا قال عن نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم): { وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
عدد الزوار: 758
إن الدعوة إلى الله تعالى منصب مرتبط بشأن من شؤون الحق المتعال، ولهذا قال عن
نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم): { وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا }..فمالم
يتحقق ( الإذن ) بالدعوة، لكان الداعي ( متطفلا ) في دعوته، غير مسدد في
عمله..فالقدرة على التأثير في نفوس الخلق، هبة من رب العالمين، ولا يتوقف كثيرا على
إتقان القواعد الخطابية، فضلا عن تكلف بعض المواقف التي يراد منها تحبيب قلوب الخلق،
وقد ورد في الحديث: { تجد الرجل لا يخطئ بلام ولا واو، خطيبا مصقعاً، ولقلبه أشد
ظلمة من الليل المظلم، وتجد الرجل لا يستطيع يعبر عما في قلبه بلسانه، ولقلبه يزهر
كما يزهر المصباح }الكافي -ج2ص422..ولهذا عُـبّر عن بعضهم - من ذوي التأثير في
القلوب - بأن لكلامه ( قبولاً ) في القلوب.
المسارعة في السير
إن من الأمور اللازمة للسائر إلى الحق، ( المسارعة ) في السير بعد مرحلة (
اليقظة ) والعزم على الخروج عن أسر قيود الهوى والشهوات..فإن بقاءه فترة طويلة في
مراحل السير الأولى، بمثابة حرب استنـزاف تهدر فيها طاقاته من دون أن يتقدم إلى
المنازل العليا، فيكون ذلك مدعاة له لليأس، ومن ثَّم التراجع إلى الوراء كما يقع
للكثيرين..فالسائرون في بدايات الطريق لا يشاركون أهل ( الدنيا ) في لذائذهم الحسية،
لحرمتها أو لاعتقادهم بتفاهتها بالنسبة إلى اللذات العليا التي يطلبونها، ولا
يشاركون أهل ( العقبى ) في لذائذهم المعنوية، لعجزهم عن استذواقها في بدايات
الطريق..فهذا التحير والتأرجح بين الفريقين قد يبعث أخيرا على الملل والعود إلى
بداية الطريق، ليكون بذلك في معرض انتقام الشياطين منه، لأنه حاول الخروج عن
سلطانهم من دون جدوى.
الاصطفاء الإلهي
إن السير إلى الحق المتعال يكون تارة: في ضمن أسلوب ( المجاهدة ) المستلزم
للنجاح حينا وللفشل أحيانا أخرى، ويكون تارة أخرى في ضمن ( الاصطفاء ) الإلهي أو ما
يسمى بالجذب الرباني للعبد..كما قد يشير إلى ذلك قوله تعالى: { واصطنعتك لنفسي }و{
لتصنع على عيني }و{ كفّلها زكريا }و{ ألقيت عليك محبة مني }و{ إن الله اصطفى آدم
ونوحا }و{ الله يجتبي إليه من يشاء }..ومن المعلوم أن وقوع العبد في دائرة الاصطفاء
والجذب، يوفّر عليه كثيرا من المعاناة والتعثر في أثناء سيره إلى الحق المتعال،
ولكن الكلام هنا في ( موجبات ) هذا الاصطفاء الإلهي الذي يعد من أغلى أسرار
الوجود..ولاريب في أن المجاهدة المستمرة لفترة طويلة أو التضحية العظيمة ولو في
فترة قصيرة، وكذلك الالتجاء الدائم إلى الحق، مما يرشح العبد لمرحلة الاصطفاء..وقد
قيل: { إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق }.
العلم صورة ذهنية
ما العلم إلا انعكاس صورة معلومة معينة في الذهن..وهذا المقدار من التفاعل (
الطبيعي ) الذي يتم في جهاز الإدراك - والذي لا يعتبر في حد نفسه أمرا مقدسا يمدح
عليه صاحبه - لا يلازم القيام بالعمل على وفق ما تقتضيه المعلومة، إلا أن ( تختمر )
المعلومة في نفس صاحبها، لتتحول إلى إيمان راسخ يقدح الميل الشديد في النفس للجري
على وفقها..ومن هنا علم أن بين المعلومة والعمل مسافة كبيرة، لا تُطوى إلا بمركب
الإيمان..وإلا فكيف نفسر إقدام المعاندين على خلاف مقتضى العقل والفطرة، بل على ما
يعلم ضرره يقيناً كأغلب المحرمات ؟!، وقد قال الحق تعالى: { وما اختلف الذين أوتوا
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم }..وهنا يأتي دور المولى الحق في تحبيب الإيمان
في الصدور وتزيينه فيها، ليمنح العلم النظري ( القدرة ) على تحريك العبد نحو ما علم
نفعه، ولولا هذه العناية الإلهية لبقي العلم عقيما لا ثمرة له، بل كان وبالا على
صاحبه.
الاستقامة مع المعاشرة
إن مَثَل من يرى في نفسه الاستقامة الخلقية - وهو في حالة العزلة عن الخلق -
كمَثَل المرأة الجميلة المستورة في بيتها، فلا يُعلم مدى ( استقامتها ) وعفافها،
إلا بعد خروجها إلى مواطن ( الانزلاق )..وكذلك النفس فإن قدرتها على الاستقامة في
طريق الهدى، والتفوّق على مقتضى الشهوات، يُعلم من خلال ( التحديات ) المستمرة بين
دواعي الغريزة، ومقتضى إرادة المولى عز ذكره..ولا ينبغي للعبد أن يغـترّ بما فيه من
حالات السكينة والطمأنينة وهو في حالة العزلة عن الخلق، إذ أن معاشرة الخلق تكشف
دفائن الصفات التي أخفاها صاحبها، أو خفيت عليه في حال عزلته.
فتنة الكمال
إن الكمال العلمي والعملي للنفس بمثابة ( الزينة) للمرأة..والمرأة كلما زادت
زينتها كلما أشرق جمالها، وأصبحت مادة لان تفتتن هي بنفسها، ويفتتن الآخرون
بجمالها..فصاحبة هذا الجمال تحتاج إلى مراقبة تامة، لئلا تقع في المفاسد المترتبة
على ذلك الجمال الظاهري..والأمر كذلك في النفس ( العارية ) من مظاهر الجمال الباطني
فانه قد يهون خطبها، وأما ( الواجدة ) للجمال العلمي والعملي - وخاصة مع شهادة
الآخرين بذلك - فإن صاحبها في معرض الفتنة المهلكة، كما اتفق ذلك للكثير من أرباب
الكمال.
الأنس بالحق لا بطاعته
إن الأنس ( بالله ) تعالى أمر يغاير الأنس ( بطاعته )..فقد يأنس الإنسان بلون
من ألوان الطاعة قد تنافي رضا الحق في تلك الحالة، كالاشتغال بالمندوب، تاركا قضاء
حاجة مؤمن مكروب..فالمتعبد الملتفت لدقائق الأمور ( مراقب ) لمراد المولى في كل حال،
سواء طابق ذلك المراد مراده أو خالفه..وبذلك يختارمن قائمة الواجبات والمندوبات، ما
يناسب تكليفه الفعلي، بدلا من الجمود على طقوس عبادية ثابتة.
الحديث النفسي
يدور في داخل الإنسان حديث نفسيّ يصل إلى حد ( الثرثرة )، يختلط فيه الحق
والباطل، والجد والهزل، بل قد ( يحاكم ) الإنسان شخصا في داخله، ويصب عليه ( غضبه
)، بل قد يفحش بالقول في ذلك الحديث النفسي، بحيث تبدو علامات السخط على وجهه
وكأنـّه مشتغل خارجاً بمواجهة الخصم..وعليه فلا بد من مراقبة هذه المحادثات
الباطنية والتنصت عليها - وخاصة وأنها غير تابعة للإرادة الشعورية - لئلا يتحول
الحديث في عالم الخيال والتجريد، إلى عالم الخارج والواقع، فتترتب عليه حينئذ أحكام
الواقع، وما يستلزمه من سخط المولى الجليل.
اللسان كاشف لا موجد
إن حركة اللسان بالألفاظ ( كاشفـة ) عن المعاني وليست ( موجدة ) لـها..وعليه
فان الذكر اللساني الخالي من الذكر القلبي، خال من استحداث المعاني التي تترتب
عليها الآثار، من تنوير الباطن وترتّب الأجر الكامل وغير ذلك..فكما أنه لا قيمة
لحركة اللسان الخالية من قصد المعاني في باب المعاملات، فكذلك الأمر إلى حد كبير في
باب العبادات، وإن كانت مجزءة ظاهرا..وإن هذا الإجزاء يكون ( رفقاً ) بحال المكلفين
الذين يخلّون بهذا الشرط غالبا، إما قصورا أو تقصيرا.
سرقة الجوهرة
إن إيمان العبد بمثابة الجوهرة القيّمة في يده..وكلما ازدادت ( قيمتها ) كلما
ازداد حرص الشياطين في ( سلب ) تلك الجوهرة من يد صاحبها..ولهذا تزداد وحشة أهل
اليقين عند ارتفاعهم في الإيمان درجة، لوقوعهم في معرض هذا الخطر العظيم، من جهة من
اعتاد سرقة الجواهر من العباد..ومن المعلوم أن هذا الشعور بالخوف، لا يترك مجالا
لعروض حالات العجب والرياء والتفاخر وغير ذلك، لوجود الصارف الأقوى عن تلك المشاعر
الباطلة.
الالتفات للمسبِّب لا للسبَّب
إن من الضروري - في السعي وراء الأسباب عند الاسترزاق أو الاستشفاء أو غير ذلك
- الالتفات المستمر ( لمسبِّبية ) الحق للأسباب، إذ أن الساعي في تلك الحالة -
وخاصة عند الاضطراب أو الغفلة - قد يكون بعيدا عن مثل هذه الالتفاتة المقدسة..ومن
الواضح أن مثل هذا الالتفات مستلزم ( لعناية ) الحق في تحقيق المسبَّب الذي يريده
الساعي جريا وراء الأسباب..إضافة إلى خروجه من صفة الغفلة التي تكاد تطبق الجميع في
مثل هذه الحالات، وبذلك يجمع بين ( قضاء ) الحاجة و( الارتباط ) بمسبب الأسباب في
آن واحد.
الإحساس بالمعيّـة الإلهية
لو تعمق في نفس الإنسان الإحساس بالمعـيّة الإلهية - المطردة في كل الحالات -
لما انتابه شعور بالوحدة والوحشة أبدا، بل ينعكس الأمر إلى أن يعيش الوحشة مع ما
سوى الحق، خوفا من صدهم إياه عن الأنس بالحق..وهذا هو الدافع الخفي لاعتزال بعضهم
عن الخلق، وإن كان الأجدر بهم ( تاسيًا ) بمواليهم، الاستقامة في عدم إلتفات الباطن
إلى ما سوى الحق، مع اشتغال الظاهر بهم..وبما أن الإنسان يعيش الوحدة في بعض ساعات
الدنيا، وفي كل ساعات ما بعد الدنيا، فالأجدر به أن يحقق في نفسه هذا الشعور (
بالمعية ) الإلهية، لئلا يعيش الشعور بالوحدة القاتلة، وخاصة فيما بعد الحياة
الدنيا - الذي تعظم فيه الوحشة - إلى يوم لقاء الله تعالى.
فائدة العلوم الطبيعية
إن التعمق في العلوم الطبيعية يعين على معرفة عظمة الصانع، وبالتالي يوجب مزيد
الارتباط به، سواء في ذلك العلم الباحث في المخلوق الصغير وهو ( الطب ) أو الباحث
في المخلوق الكبير وهو ( الفلك )، وقد قال الحق جل ذكره: { سنريهم آياتنا في الآفاق
وفي أنفسهم }..ومن الممكن للمتعمق في هذه العلوم، أن يجـمع في نفسه بين آثار (
الانبهار ) بعظمة عالم التكوين و بين آثار ( التعـبد ) بعالم التشريع معا، إذ أن
صاحب الشريعة هو بنفسه صاحب الطبيعة، والذي أمره بالصلاة هو الذي خلق الكون الفسيح
بما فيه..وبذلك ينظر مثل هذا المتعمق إلى الشرائع بتقديس واعتقاد، وتعبد ممزوج
بالتعقل والقبول..ومما يلفت النظر في هذا المجال، أن القرآن الكريم أمر بالعبادة
بقوله: { اعبدوا ربكم الذي خلقكم }، عقيب قوله: { الذي جعل لكم الأرض فراشاً }، مما
قد يستفاد منه أن الالتفات إلى النعم في عالم التكوين، مما يهيّـأ نفس الملتفت
للخضوع أمام المنعم الخالق.
مدبريّـة الحق
إذا اعتقد العبد بحقيقة ( مدبرية ) الحق لعالم التكوين، وأن ( سببيّة ) الأسباب
- فسخا وإبراماً - بيده، وأن انسداد السبل إنما هو بالنظر القاصر للعبد لا بالنسبة
إلى القدير المتعال، كان هذا الاعتقاد موجبا ( لسكون ) العبد - في احلك الظروف -
إلى لطفه القديم، كما هو حال الخليل (عليه السلام) في النار..ناهيك عما يوجبه هذا
الاعتقاد من طمأنينة وثبات في نفس العبد، سواء قبل البلاء أو حينه أو بعده.
اللقاء في جوف الليل
إن جوف الليل هو موعد اللقاء الخاص بين الأولياء وبين ربهم..ولهذا ينتظرون تلك
الساعة من الليل - وهم في جوف النهار - بتلهّف شديد..بل إنهم يتحملون بعض أعباء
النهار ومكدراتها، لانتظارهم ساعة ( الصفاء ) التي يخرجون فيها عن كدر الدنيا
وزحامها..وهي الساعة التي تعينهم أيضا على تحمّل أعباء النهار في اليوم
القادم..وبذلك تتحول صلاة الليل ( المندوبة ) عندهم، إلى موقف ( لا يجوز ) تفويت
الفرصة عنده، إذ كيف يمكن التفريط بمنـزلة المقام المحمود ؟!..ومن الملفت في هذا
المجال أن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أوصي أمير المؤمنين بصلاة الليل ثلاثاً،
ثم عقّب ذلك بالقول: اللهم أعنه!.
شرف الانتساب إلى الحق
عندما يتحقق العمل القربى منتسباً إلى الله تعالى، فإن شرف ( الانتساب ) إلى
الحق أشرف وأجلّ من ( العمل ) نفسه، سواء كان ذلك العمل كثيرا أو قليلا..فالعبد
الملتفت لمرادات المولى، يجاهد في تحقيق أصل ( العُلقة )، ولا يهمه - بعد ذلك - حجم
العمل ولا آثاره..لأن العمل مهما بدا للعبد جليلا، فهو حقير عند المولى الذي تصاغر
عنده الوجود برمّـته، بخلاف علقة الانتساب إليه، فانه شريف لكونه من شؤونه تعالى.
مطابقة المزاج للطاعة
يصل العبد - بعد مرحلة عالية من صفاء الباطن - إلى درجة يتطابق فيها سلوكه مع
مضامين بعض الأخبار الواردة عن المعصومين (عليه السلام)، حتى مع عدم التفاته إلى
تلك الأخبار تفصيلا، لأنها حاكية عن الفطرة السليمة..بل يصل الأمر به إلى أن يكون
التقيّد بحدود الشريعة ( موافقاً ) لمزاجه الأوليّ، وبالتالي لا يجد كثير معاناة في
العمل بها..وحينها يكون السير ( حثيثاً ) لا يقف إلا عند الوصول إلى ( لقائه )، و
ذلك لازدياد درجة صفاء المزاج، المستلزم لملائمة الطاعة - حتى الثقيلة - منها لذلك
المزاج..وعندها تتلاشى صعوبة المجاهدة والرياضة، لما في الرياضة والمجاهدة من
منافرة الطبع، وهي منتفية عند ذلك المزاج.
بنيان الحق في الأرض
إن المؤمن بنيان الله تعالى في الأرض، ولهذا صار بمثابة الكعبة بل هو أشرف
منها..إذ أنه وإن تحقق الانتساب إلى المولى تعالى في الحالتين، إلا إن انتساب (
القلب ) الذي هو عرش الرحمن إلى الحق، أشرف من انتساب ( الحجارة ) إليه..فذاك
انتساب ذي شعور ناطق، بخلاف الفاقد للشعور الصامت..وعليه فإن كل خدمة لهذا البنيان،
فإنما هو خدمة لصاحب ذلك البنيان، وكل أذى له فهو أذى لصاحبه..وقد ورد عن الإمام
الرضا (عليه السلام) أنه قال: { من أسخط وليا من أوليائي، دعوت الله ليعذبه في
الدنيا أشد العذاب، وكان في الآخرة من الخاسرين }البحار-ج74ص230.
العمل للقرب لا للأجر
لا يحسن بمن يروم الدرجات العالية من الكمال، أن يتوقف أداؤه للعمل على مراجعة
ثواب ذلك العمل..بل إن جلب رضا المولى في التروك والأفعال، لمن أعظم الدواعي التي
تبعث العبد على الإقدام والإحجام..وهذا الداعي هو الذي يؤثر على كمّ العمل، وكيفه،
ودرجة إخلاصه..فحيازة الأجر والثواب أمر يختص بالآخرة، وتحقيق القرب من المولى له
أثره في الدنيا والآخرة..وشتان بين العبد الحر والعبد الأجير، وبين من يطلب المولى
( للمولى ) لا ( للأولى ) ولا ( للأخرى ).
وجه القلب
كما إن في الكيان ( العضوي ) للإنسان وجها يمثل جهة اهتمامه بالأشياء والأشخاص،
إذ الإقبال على الأمور الخارجية والإعراض عنها يكون بالوجه، فالأمر كذلك في الكيان
( النفسي ) للإنسان، فإن له وجها بذلك الوجه يتجه حبا أو إعراضا نحو ما يتوجه إليه
أو عنه..فمن الممكن بعد المجاهدات المستمرة والمراقبات المتوالية، الوصول إلى درجة
تكون جهة القلب ( ثابتة ) نحو المبدأ، وإن ( اشتغل ) البدن في أنشطة متباينة، وتوزع
وجهه الظاهري نحو أمور مختلفة.
الصلاة قمة اللقاء
إن ( أصل ) وجود علاقة العبودية و ( عمقها ) بين العبد وربه، يمكن أن يستكشف من
خلال الصلوات الواجبة والمستحبة..فالصلاة هي قمة اللقاء بين العبد والرب، ومدى (
حرارة ) هذا اللقاء ودوامها، يعكس أصل العلاقة ودرجتها..فالمؤمن العاقل لا يغره
ثناء الآخرين - بل ولا سلوكه الحسن قبل الصلاة وبعدها - ما دام يرى الفتور والكسل
أثناء حديثه مع رب العالمين، فإنه سمة المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا
كسالى.
العلم لا يلازم الاطمئنان
إن من الواضح أن عملية ( تخزين ) المعلومات النظرية - حتى النافعة منها فيما
يتعلق بعالم الفكر والإدراك - عملية مغايرة لعملية ( تجذير ) موجبات الاطمئنان في
القلب..فقد يوجب العلم حالة الاطمئنان وقد لا يوجبها، وان كانت المضامين الموجبة
لسكون القلب، لها دورها كإحدى المقدمات الواقعة في سلسلة العلل..ومما يؤيد ذلك عدم
وجود تلازم بين ( القراءات ) المتعلقة بالجانب الروحي - كالكتب الأخلاقية - وبين (
التفاعلات ) الروحية المستلزمة لحالة السكينة والاطمئنان.
اجتذاب قلوب الخلق
إن السيطرة على قلوب المخلوقين ولو لغرض راجح - كالهداية والإرشاد - تحتاج إلى
( تدخّل ) مقلب القلوب ومن يحول بين المرء وقلبه..وعليه فلا داعي لاصطناع الحركات
الموجبة لجلب القلوب كالتودد المصطنع، أو حسن الخلق المتكلَّف..فما ( قيمة )
السيطرة على القلوب أولاً ؟!..وما ( ضمان ) دوام السيطرة الكاذبة ثانياً ؟!..وحالات
انتكاس علاقات الخلق مع بعضهم - بدواع واهية - خير دليل على ذلك.
تلذذ الغني والفقير
طالما اشترك الغني والفقير في الالتذاذ ( الفعلي ) بملذات الحياة الدنيا..وإنما
افترقا في إحساس الأول بامتلاك الوسائل الكافية لتأمين الالتذاذ ( المستقبلي ) دون
الآخر..وليس هذا الفارق مما يستحق معه الوقوع في المهالك، وخاصة أن ساعة المستقبل
تنقلب إلى ساعة الحاضر في كل لحظة، فيجد فيها الفقير أيضا ما يحقق له أدنى درجات
الالتذاذ بحسبه، من دون الوقوع في ( المعاناة ) والحرص الذي يصاحب جمع المال عـادة.
التأثر الشخصي بالمصاب
من الضروري أن نجعل تأثرنا بمصائب أهل البيت (عليه السلام) بمثابة تأثر على
مصاب ( شخصي ) كالمفجوع بعزيز لديه، كما يشير إليه التعبير في زيارة عاشوراء: {
وعظم مصابي بك }..فمن عظمت مصيبته بمن يحب، لا يتوقع ( أجراً ) مقابل ذلك التأثر،
ولا يجعل ذلك ( ذريعة ) للحصول على عاجل الحطام، كما نلاحظ ذلك فيمن يتوسل بهم
توصلا إلى الحوائج الفانية..وليعلم في هذا المجال أن التأثر بمصائبهم التي حلّت بهم
صلوات الله عليهم، كامن في أعماق النفوس المستعدة، فلا يحتاج إلى كثير إثارة من
الغير، كما روي من{ أن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا }..أضف إلى
أن هذا التأثر العميق، مما يدعو العبد إلى الولاء العملي والمتابعة الصادقة، وهو
المهم في المقام.
شهر الضيافة
إن شهر رمضان شهر ضيافة - حقيقة لا مجازا - ومن هنا سهل على الضيف أن ( يحوز )
على عطايا من المضيف، لا يمكن الحصول عليها منه خارج دائرة الضيافة..وليعلم أن هذه
العطايا مبذولة من غير سؤال كما هو مقتضى الضيافة من الكريم، فكيف بمن ( يسأل ) ذلك
؟!.. وكيف بمن ( يلح ) في السؤال ؟!..ومن هنا صارت ليلة العيد ليلة الجوائز العظمى،
ولطالما غفل عنها الغافلون.
الجمع بين الوحشة والمودة
إن من خصائص العامل في المجتمع، هو الجمع بين حالة ( الوحشة) من الخلق، لعدم
تحقق الملكات الصالحة فيهم والتي هي الملاك للارتياح والأنس، وبين حالة ( المودة )
والألفة والمداراة التي أمر بها الشارع جل شأنه..فالمستفاد من مجموع الأخبار ضرورة
الرفق بالناس على أنهم أيتام آل محمد (عليه السلام)، وإن خلطوا عملا صالحا وآخر
سيئا..فالجامع في نفسه بين هاتين الخصلتين، أقرب ( للنجاح ) في إرشاد الخلق، (
وللاحتراز ) عن مقتضى طباعهم الفاسدة المتمثلة في الانشغال بالباطل، والغفلة عن
الحق في الغالب.
سياسة النفس
إن مجاهدة النفس وسياستها يحتاج إلى خبرة وإطلاع بمداخلها ومخارجها، وسبل
الالتفاف حولها..فلا ينبغي تحميلها فوق طاقتها، وإلا حرنت وتمردت حتى فيما لامشقة
فيه..بل لابد من إقناعها بالحقائق المحركة لها، والموجبة لاستسهال بعض الصعاب،
ومنها: ( العلم ) بضرورة سلوك هذا السبيل الذي ينتهي إلى الحق الذي إليه مرجع
العباد، وأن ( مراد ) المولى لا يتحصل - غالباً - إلا بهذه المخالفة المستمرة،
بالإضافة إلى ( التذكير ) باللذات المعنوية البديلة، مع الاحتفاظ بما يحلّ ويجمل من
اللذائذ الحسية.
تسويل النفس
كثيرا ما ننبعث في حياتنا من ( محركية ) الذات ومحوريتها، حتى في الأمور التي
يفترض فيها محو الذات، واستذكار القربة الخالصة لله رب العالمين، كدعوة العباد إلى
الله تعالى..ولطالما ( تسوّل ) النفس لصاحبها ( فيبطّن ) محورية ذاته بأمور أخرى
عارضة، كالثأر للكرامة أو إثبات العزة الإيمانية، أو الدفاع عن العنوان، أو دعوى
العناوين الثانوية، مما لا تخفى على العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور..وليعلم
في مثل هذه الحالات، أن الإحجام عن العمل خير من القيام به من تلك المنطلقات
المبطّنة.
حذر المصلحين
إن المصلح الذي يروم إخراج العباد من الظلمات إلى النور في معرض ( عداء )
الشياطين له، بل إثارة أحقادهم المستلزم ( للانتقام ) منه، لأنه يروم تحرير الآخرين
من سيطرة الطاغوت، وهذا بدوره يعتبر تحديا له ولجنوده..ومن هنا كان الأولياء يعيشون
حالة الإشفاق والخوف من وقوعهم في إحدى شراك الشيطان المنصوبة لهم في جميع مراحل
حياتهم..فلم يأمنوا سوء العاقبة إلا بفضله تعالى، وخاصة في مواطن ( الامتحان )
العسير في المال أو الجاه أو الدين، فيما لو تزامن أيضا مع الضعف، والغفلة، وتكالب
الشرور.
الاستعاذة بالحق
لو اعتقد الإنسان بحقيقة أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وأنه
أقسم صادقا على إغواء الجميع، وخاصة مع التجربة العريقة في هذا المجال من لدن آدم
إلى يومنا هذا، ( لأعاد ) النظر في كثير من أموره..فما من حركة ولا سكنة إلا وهو في
معرض هذا التأثير الشيطاني..فالمعايِش لهذه الحقيقة يتّهم نفسه في كل حركة - ما دام
في معرض هذا الاحتمال - فإن هذا الاحتمال وإن كان ضعيفا إلا أن المحتمل قوي، يستحق
معه مثل هذا القلق..و( ثـمرة ) هذا الخوف الصادق هو ( الالتجاء ) الدائم إلى المولى
المتعال، كما تقتضيه الاستعاذة التي أمرنا بها حتى عند الطاعة، كتلاوة القرآن
الكريم.
العبودية ضمن المجاهدة
ليس من المهم تحقيق العبودية الكاملة من دون ( منافرة ) للشهوات والأهواء..فمن
يمكنه سفك الدماء والإفساد في الأرض - بما أوتي من شهوة وغضب - ثم ( يتعالى ) عن
تلك المقتضيات، ويلتزم جادة الحق والصواب، هو الجدير بخلافة الله تعالى في
الأرض..وكلما ( اشتد ) الصراع والنجاح، كلما عظمت درجة العبودية..وقد كان الأمر
كذلك بالنسبة إلى إبراهيم (عليه السلام) في تعامله مع نفسه وأهله وقومه، إذ لم يصل
إلى درجة الإمامة، إلا بعد اجتيازه مراحل الابتلاء كما ذكره القرآن الكريم.
* الشيخ حبيب الكاظمي