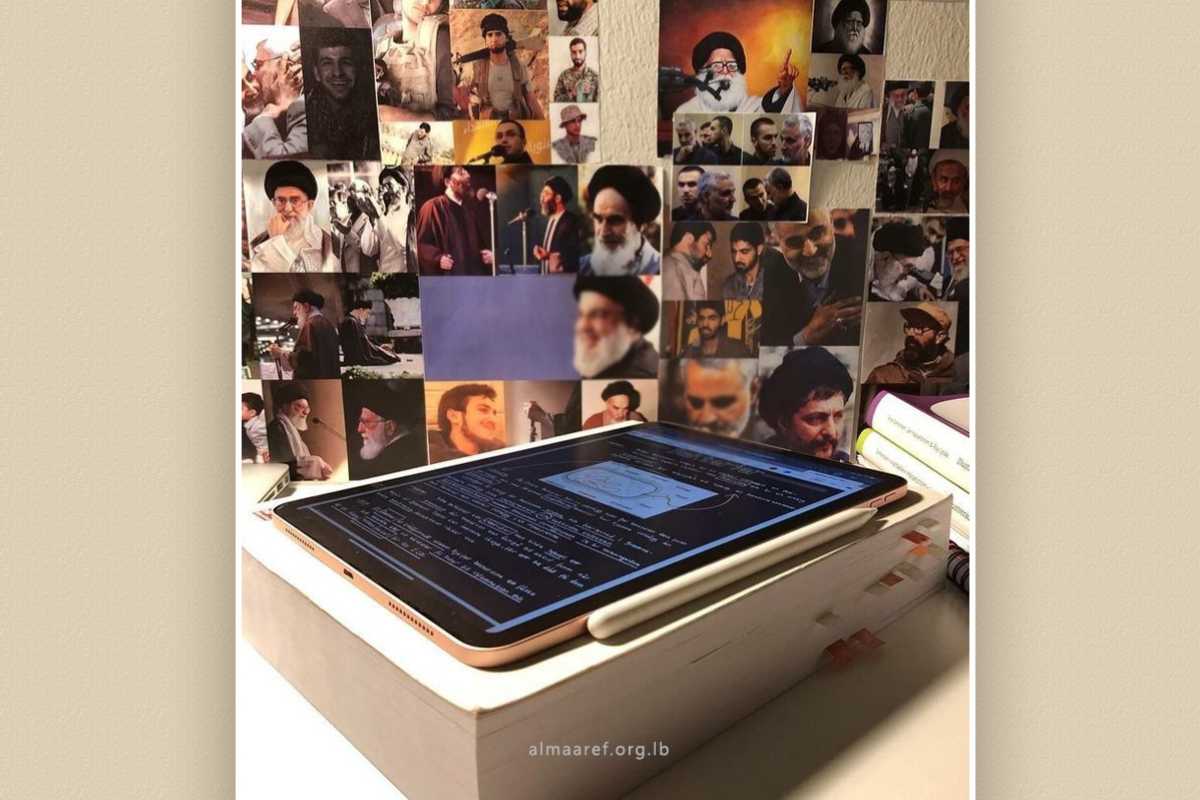بماذا يتكون ويعيش المجتمع الإسلامي؟
المجتمع الإسلامي
لا ريب أن الاجتماع أي اجتماع كان إنما يتحقق ويحصل بوجود غاية واحدة مشتركة بين أفراده المتشتتة، وهو الروح الواحدة السارية في جميع أطرافه التي تتحد بها نوع اتحاد، وهذه الغاية والغرض في نوع الاجتماعات المتكونة غير الدينية إنما هي غاية الحياة الدنيوية للإنسان...
عدد الزوار: 24
لا ريب أن الاجتماع أي اجتماع كان إنما يتحقق ويحصل بوجود غاية واحدة مشتركة بين أفراده المتشتتة، وهو الروح الواحدة السارية في جميع أطرافه التي تتحد بها نوع اتحاد، وهذه الغاية والغرض في نوع الاجتماعات المتكونة غير الدينية إنما هي غاية الحياة الدنيوية للإنسان لكن على نحو الاشتراك بين الأفراد لا على نحو الانفراد وهي التمتع من مزايا الحياة المادية على نحو الاجتماع.
والفرق بين التمتع الاجتماعي والانفرادي من حيث الخاصية أن الإنسان لو استطاع أن يعيش وحده كان مطلق العنان في كل واحد من تمتعاته حيث لا معارض له ولا رقيب إلا ما قيد به بعض أجهزته بعضاً فإنه لا يقدر أن يستنشق كل الهواء فإن الرئة لا تسعه وإن اشتهاه، ولا يسعه أن يأكل من المواد الغذائية لا إلى حد فإن جهاز الهاضمة لا يتحمله فهذا حاله بقياس بعض قواه وأعضائه إلى بعض، وأما بالنسبة إلى إنسان آخر مثله، فإذا كان لا شريك له في ما يستفيد منه من المادة على الفرض فلا سبب هناك يقتضي تضييق ميدان عمله، ولا تحديد فعل من أفعاله وعمل من أعماله.
وهذا بخلاف الإنسان الواقع في ظرف الاجتماع وساحته فإنه لو كان مطلق العنان في إرادته وأعماله لأدى ذلك إلى التمانع والتزاحم الذي فيه فساد العيش وهلاك النوع. وهذا هو السبب الوحيد الذي يدعو إلى حكومة القانون الجاري في المجتمع غير أن المجتمعات الهمجية لا تتنبه لوضعها عن فكر وروية وإنما تكون الآداب والسنن فيها المشاجرات والمنازعات المتوفرة بين أفرادها فتضطر الجميع إلى رعاية أمور تحفظ مجتمعهم بعض الحفظ، ولما لم تكن مبنية على أساس مستحكم كانت في معرض النقض والإبطال تتغير سريعاً وتنقرض، ولكن المجتمعات المتمدنة تبنيه على أساس قويم بحسب درجاتهم في المدنية والحضارة فيرفعون به التضاد والتمانع الواقع بين الإرادات وأعمال المجتمع بتعديلها بوضع حدود وقيود لها ثم ركز القدرة والقوة في مركز عليه ضمان إجراء ما ينطق به القانون.
ومن هنا يظهر أولاً: أن القانون حقيقة هو ما تعدل به إرادات الناس وأعمالهم برفع التزاحم والتمانع من بينهما بتحديدها.
وثانياً: أن أفراد المجتمع الذي يحكم فيه القانون أحرار فيما وراءه كما هو مقتضى تجهز الإنسان بالشعور والإرادة بعد التعديل، ولذا كانت القوانين الحاضرة لا تتعرض لأمر المعارف الإلهية والأخلاق، وصار هذان المهمان يتصوران بصورة يصورها بهما القانون فيتصالحان ويتوافقان معه على ما هو حكم التبعية فيعودان عاجلاً أو آجلاً رسوماً ظاهرية فاقدة للصفاء المعنوي، ولذلك السبب أيضاً ما نشاهده من لعب السياسة بالدين فيوماً تقضي عليه وتدحضه ويوماً تميل إليه فتبالغ في إعلاء كلمته، ويوماً تطوي عنه كشحاً فتخليه وشأنه.
وثالثاً: إن هذه الطريقة لا تخلو عن نقص فإن القانون وإن حمل ضمان إجرائه على القدرة التي ركزها في فرد أو أفراد، لكن لا ضمان على إجرائه بالنهاية بمعنى أن منبع القدرة والسلطان لو مال عن الحق وحول سلطة النوع على النوع إلى سلطة شخصه على النوع وانقلبت الدائرة على القانون لم يكن هناك ما يقهر هذا القاهر فيحوله إلى مجراه العدل، وعلى هذا القول شواهد كثيرة مما شاهدناه في زمننا هذا وهو زمان الثقافة والمدنية فضلاً عما لا يحصى من الشواهد التاريخية، وأضف إلى هذا النقص نقصاً آخر، وهو خفاء نقض القانون على القوة المجرية أحياناً، أو خروجه عن حومة قدرته.
وبالجملة الاجتماعات المدنية توحدها الغاية الواحدة التي هي التمتع من مزايا الحياة وهي السعادة عندهم، ولكن الإسلام لما كان يرى أن الحياة الإنسانية أوسع مداراً من الحياة الدنيا المادية بل في مدار حياته الحياة الأخروية التي هي الحياة، ويرى أن هذه الحياة لا تنفع فيها إلا المعارف الإلهية التي تنحل بجملتها إلى التوحيد، ويرى أن هذه المعارف لا تنحفظ إلا بمكارم الأخلاق وطهارة النفس من كل رذيلة، ويرى أن هذه الأخلاق لا تتم ولا تكمل الا بحياة اجتماعية صالحة معتمدة على عبادة الله سبحانه والخضوع لما تقتضية ربوبيته ومعاملة الناس على أساس العدل الاجتماعي أخذ (أعني الإسلام) الغاية التي يتكون عليها المجتمع البشري ويتوحد بها دين التوحيد ثم وضع القانون الذي وضعه على أساس التوحيد، ولم يكتف فيه على تعديل الإرادات والأفعال فقط بل تممه بالعباديات وأضاف إليها المعارف الحقة والأخلاق الفاضلة.
ثم جعل ضمان إجرائها في عهدة الحكومة الإسلامية أولاً، ثم في عهدة المجتمع ثانياً، وذلك بالتربية الصالحة علماً وعملاً والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومن أهم ما يشاهد في هذا الدين ارتباط جميع أجزائه ارتباطاً يؤدي إلى الوحدة التامة بينها بمعنى أن روح التوحيد سارية في الأخلاق الكريمة التي يندب إليها هذا الدين، وروح الأخلاق منتشرة في الأعمال التي يكلف بها أفراد المجتمع، فالجميع من أجزاء الدين الإسلامي ترجع بالتحليل إلى التوحيد، والتوحيد بالتركيب يصير هو الأخلاق والأعمال، فلو نزل لكان هي ولو صعدت لكان هو، (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه)، فإن قلت: ما أورد من النقض على القوانين المدنية فيما إذا عصت القوة التنفيذية عن إجرائها أو فيما يخفى عليها من الخلاف مثلاً وارد بعينه على الإسلام وأوضح الدليل عليه ما نشاهده من ضعف الدين وزوال سيطرته على المجتمع الإسلامي، وليس إلا لفقدانه من يحمل نواميسه على الناس يوماً.
قلت: حقيقة القوانين العامة سواء كانت إلهية أو بشرية ليست إلا صوراً ذهنية في أذهان الناس وعلوماً تحفظها الصدور، وإنما ترد مورد العمل وتقع موقع الحس بالإرادات الإنسانية تتعلق بها، فمن الواضح أن لو عصمت الإرادات لم توجد في الخارج ما تنطبق عليه القوانين، وإنما الشأن فيما يحفظ به تعلق هذه الإرادات بالوقوع حتى تقوم القوانين على ساقها والقوانين المدنية لا تهتم بأكثر من تعليق الأفعال بالإدارات أعني بإرادة الأكثرية، ثم لم يهتموا بما تحفظ هذه الإرادة، فمهما كانت الإرادة حية شاعرة فاعلة جرى بها القانون، وإذا ماتت من جهة انحطاط يعرض لنفوس الناس وهرم يطرأ على بنية المجتمع، أو كانت حية لكنها فقدت صفة الشعور والإدراك لانغمار المجتمع في الملاهي وتوسعه في الإتراف والتمتع، أو كانت حية شاعرة لكنها فقدت التأثير لظهور قوة مستبدة فائقة غالبة تقهر إرادتها إرادة الأكثرية، وكذا في الحوادث التي لا سبيل للقوة التنفيذية على الوقوف عليها كالجرائم السرية، أو لا سبيل لها إلى بسط سيطرتها عليها كالحوادث الخارجة عن منطقة نفوذها ففي جميع هذه الموارد لا تنال الأمة أمنيتها من تطبيق القانون وحصانة المجتمع من المفاسد والتلاشي وعمدة الانشعابات الواقعة في الأمم الأوروبية بعد الحرب العالمية الكبرى الأولى والثانية من أحسن الأمثلة في هذا الباب.
وليس ذلك (أعني انتقاض القوانين وتفسخ المجتمع وتلاشيه) إلا لأن المجتمع لا يهتم بالسبب الحافظ لإرادات الأمة على قوتها وسيطرتها وهي الأخلاق العالية إذ لا تستمد الإرادة في بقائها واستدامة حياتها إلا في الخُلق المناسب لها كما بين ذلك في علم النفس، فلولا استقرار السنة القائمة في المجتمع واعتماد القانون الجاري فيه على أساس قويم في الأخلاق العالية كانت كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. واعتُبر في ذلك ظهور الشيوعية، فليست إلا من مواليد الديمقراطية أنتجها إتراف طبقة من طبقات المجتمع وحرمان آخرين، فكان بُعداً شاسعاً بين نقطتي القساوة وفقد النصفة، والسخط وتراكم الغيظ والحنق، وكذا في الحرب العالمية التي وقعت مرة بعد مرة وهي تهدد الإنسانية ثالثة، وقد أفسدت الأرض وأهلكت الحرث والنسل ولا عامل لها إلا غريزة الاستكبار والشره والطمع، هذا.
ولكن الإسلام بنى سنته الجارية وقوانينه الموضوعة على أساس الأخلاق، وبالغ في تربية الناس عليها مع تأكيد وجود الرقيب الغيبي على الإنسان في سره وعلانيته وخلوته وجلوته،وهذا الرقيب يعمل عمله أحسن مما يؤديه شرطي مراقب أو أي قوة تبذل عنايتها في حفظ النُظُم. نعم تعتني المعارف العمومية في هذه الممالك بتربية الناس على الأخلاق المحمودة وتبذل جهدها في حض الناس وترغيبهم اليها لكن لا ينفعهم ذلك شيئاً.
أما أولاً: فلأن المنشأ الوحيد لرذائل الأخلاق ليس إلا الإسراف والإفراط في التمتع المادي والحرمان المبالغ فيه، وقد أعطت القوانين للناس الحرية التامة فيه فأمتعت بعضاً وحرمت آخرين فهل الدعوة إلى فضائل الأخلاق والترغيب عليها إلا دعوة إلى المتناقضين أو طلباً للجمع بين الضدين.
على أن هؤلاء كما عرفت يفكرون تفكراً عصبيا، ولا تزال مجتمعاتهم تبالغ في اضطهاد المجتمعات الضعيفة ودحض حقوقهم، والتمتع بما في أيديهم، واسترقاق نفوسهم، والتوسع في التحكم عليهم ما قدروا، والدعوة إلى الصلاح والتقوى مع هذه الخصيصة ليست إلا دعوة متناقضة لا تزال عقيمة.
وأما ثانياً: فلأن الأخلاق الفاضلة أيضاً تحتاج في ثباتها واستقرارها إلى ضامن يضمن حفظها وكلاءتها وليس إلا التوحيد أعني القول بأن للعالم إلهاً واحداً ذا أسماء حُسنى خَلقَ الخلق لغاية تكميلهم وسعادتهم وهو يحب الخير والصلاح، ويبغض الشر والفساد وسيجمع الجميع لفصل القضاء وتوفية الجزاء فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ومن الواضح انه لولا الاعتقاد بالمعاد لم يكن هناك سبب أصيل رادع عن إتباع الهوى والكف عن حظوظ النفس الطبيعية، فإنما الطبيعة الإنسانية تريد وتشتهي مشتهيات نفسها لا ما ينتفع به غيرها كطبيعة الفرد الآخر إلا إذا رجع بنحو إلى مشتهى نفسها. ففيما كان للإنسان مثلاً تمتع في إماتة حق من حقوق الغير ولا رادع يردعه ولا مجازي يجازيه ولا لائم معاتب يلومه ويعاتبه، فأي مانع يمنعه في اقتراف الخطيئة وارتكاب المظلمة وإن عظمت ما عظمت؟ وأما ما يتوهم ـ وكثيراً ما يخطئ فيه الباحث ـ من الروادع المختلفة كالتعلق بالوطن وحب النوع والثناء الجميل ونحو ذلك، فإنما هي عواطف قلبية ونزوعات باطنية لا سبب حافظاً عليها إلا التعليم والتربية من غير استنادها إلى السبب الموجب فهي إذن أوصاف اتفاقية وأمور عادية لا مانع معها يمنع من زوالها فلماذا يجب على الإنسان أن يفدي بنفسه غيره، ليتمتع بالعيش بعده وهو يرى أن الموت فناء وبطلان؟ والثناء الجميل إنما هو في لسان آخرين ولا لذة يلتذ به الفادي بعد بطلان ذاته.
وبالجملة لا يرتاب المتفكر البصير في أن الإنسان لا يقدم على حرمان لا يرجع إليه فيه جزاء ولا يعود إليه منه نفع، والذي يعده ويمنيه في هذه الموارد ببقاء الذكر الحسن والثناء الجميل الخالد والفخر الباقي ببقاء الدهر، فإنما هو غرور يغتر به وخدعة ينخدع بها بهيجان إحساساته وعواطفه فيخيل إليه انه بعد موته وبطلان ذاته حاله كحاله قبل موته فيشعر بذكره الجميل فيلتذ به وليس ذلك إلا من غلط الوهم كالسكران الخاضع لهيجان إحساساته فيعفو ويبذل من نفسه وعرضه وماله أو كل كرامة له ما لو يقدم عليه لو صحا وعقل، لعد ذلك سفه وجنونا.
فهذه العثرات وأمثالها مما لا حصن للإنسان يتحصن فيه منها غير التوحيد الذي ذكرناه ولذلك وضع الإسلام الأخلاق الكريمة التي جعلها جزءاً من طريقته الجارية على أساس التوحيد الذي من شؤونه القول بالمعاد، ولازمه أن يلتزم الإنسان بالإحسان ويجتنب الإساءة أينما كان ومتى ما كان سواء علم به أو لم يعلم، وسواء حمده حامد أو لم يحمد، وسواء كان معه من يحمله عليه أو يردعه عنه أو لم يكن فإن معه الله العليم الحفيظ القائم على كل نفس، ووراءه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء، وفيه تجزى كل نفس بما كسبت.
التعقل والإحساس
أما منطق الإحساس، فهو يدعوا إلى النفع الدنيوي، ويبعث إليه فإذا قارن الفعل نفع وأحسن به الإنسان فالإحساس متوقد شديد التوقان في بعثه وتحريكه، وإذا لم يحس الإنسان بالنفع فهو خامد هامد، وأما منطق التعقل فإنما يبعث إلى إتباع الحق ويرى أنه أحسن ما ينتفع به الإنسان أحس مع الفعل بنفع مادي أو لم يحس فإن ما عند الله خير وأبقى، وقس في ذلك بين قول عنترة، وهو على منطق الإحساس:
وقولي كلما جشأت وجاشت * مكانك تحمدي أو تستريحي
يريد أني استثبت نفسي كلما تزلزت في الهزاهز والمواقف المهولة من القتال بقولي لها: اثبتي فإن قتلت يحمدك الناس على الثبات وعدم الانهزام، وإن قتلت العدو استرحت ونلت بغيتك فالثبات خير على أي حال، وبين قوله تعالى... وهو على منطق التعقل ﴿قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ * قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ﴾1.
يريد أن أمرنا إلى الله سبحانه لا نريد في شيء مما يُصيبنا من ضر أو شر إلا ما وعدنا من الثواب على الإسلام له والالتزام لدينه كما قال تعالى: ﴿لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾2.
وإذا كان كذلك فإن قتلتمونا أو أصابنا منكم شيء كان لنا عظيم الأجر والعاقبة الحُسنى عند ربنا فإن قتلناكم أو أصبنا منكم شيئاً كان لنا عظيم الثواب والعاقبة الحسنى والتمكن في الدنيا من عدونا، فنحن على أي حال سعداء مغبوطون ولا تتربصون بنا في أمرنا إلا إحدى الحسنيين فنحن على الحسنى والسعادة على أي حال، وفي إحدى الحالين وهو كون الدائرة لكم علينا فنحن نتربص بكم ما يسؤوكم وأنتم لا تتربصون بنا إلا ما يسرنا ويسعدنا.
فهذان منطقان أحدهما يعني الثبات وعدم الزوال على مبنى إحساسي وهو أن الثابت أحد نفعين، إما حمد الناس وإما الراحة من العدو، هذا إذا كان هناك نفع عائد إلى الإنسان المقاتل الذي يلقي بنفسه إلى التهلكة، أما إذا لم يكن هناك نفع عائد كما لو لم يحمده الناس لعدم تقديرهم قدر الجهاد وتساوى عندهم الخدمة والخيانة، أو كانت الخدمة مما ليس من شأنه أن يظهر لهم البتة، فليس لهذا المنطق إلا العيّ واللكنة.
وهذه الموارد المعدودة هي الأسباب العامة في كل بغي وخيانة وجناية يقول الخائن المتساهل في أمر القانون: إن خدمته لا تقدر عند الناس بما يعد لها وإن الخادم والخائن عندهم سواء بل الخائن أحسن حالاً وأنعم عيشاً، ويرى كل باغ وجان انه سيتخلص من قهر القانون وأن القوى المراقبة لا يقدرون على الحصول عليه فيخفى أمره ويلتبس على الناس شخصه ويعتذر كل من يتثبط ويتثاقل في إقامة الحق والثورة على أعدائه ويداهنهم بأن القيام على الحق يذله بين الناس، ويضحك منه الدنيا الحاضرة، ويعدونه من بقايا القرون الوسطى أو إعصار الأساطير فإن ذكرته بشرافة النفس وطهارة الباطن رد عليك قائلاً: ما أصنع بشرافة النفس إذا جرت إلى نكد العيش وذلة الحياة.
وأما المنطق الآخر، وهو منطق الإسلام فهو يبني أساسه على إتباع الحق وابتغاء الأجر والجزاء من الله سبحانه، وإنما يتعلق الغرض بالغايات والمقاصد الدنيوية في المرتبة التالية وبالقصد الثاني، ومن المعلوم أنه لا يشذ عن شموله مورد من الموارد، ولا يسقط كليته من العموم والاطراد، فالعمل ـ أعم من الفعل والترك ـ إنما يقع لوجهه تعالى، وإسلاماً له وأتباعا للحق الذي أراده وهو الحفيظ العليم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا عاصم منه ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله بما تعملون خبير.
فعلى كل نفس فيما وردت مورد عمل أو صدرت، رقيب شهيد قائم بما كسبت، سواء شهده الناس أو لا، حمدوه أو لا.
وقد بلغ من حسن تأثير التربية الإسلامية أن الناس كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيعترفون عنده بجرائمهم وجناياتهم، ويذوقون مر الحدود التي تقام عليهم (القتل فما دونه) ابتغاء رضوان الله وتطهيراً لأنفسهم من قذارة الذنوب ودرن السيئات. وبالتأمل في هذه النوارد الواقعة يمكن للباحث أن ينتقل إلى عجيب تأثير البيان الديني في نفوس الناس وتعويده لهم السماحة في ألذ الاشياء وأعزها عندهم، وهي الحياة وما في تلوها.
* قضايا المجتمع والأسرة والزواج على ضوء القرآن الكريم، العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي، دار الصفوة، ص28-38.
1- التوبة:51ـ 52.
2- التوبة:120 ـ 121.